رأيتُ فراشاتٍ تتراقصُ
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 04 كانون2/يناير 2016 16:23
- كتب بواسطة: ثامر سعيد

ثامر سعيد
رأيتُ فراشاتٍ تتراقصُ( قراءة في قصائد الشاعر آوات حسن أمين)
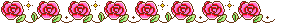
هل هو جبلُ أزمر بخيلائه وعناده الأسطوري ، أم هو شلالُ أحمد آوه بشاعريته وانسيابه الحالم ، أم هي حلبجة بقرابينها الآلافُ الخمسة ، هل هي خضرة الصنوبر أم زرقة النهر أم بياض الغمام من جعل الشاعر آوات حسن أمين يرسمُ لوحاته المرقشة بالأحلام والمنمنمة بالعشق والدموع فيأخذكَ بين الفجيعة والفرح الشاهق في دروبٍ مباغتة ، زادُكَ اللهفة وماءُكَ الدهشة ، وبوصلتكَ لا تشير إلا إلى الجمال ، هذا المتصوفُ الذي شاهد أوراقه الخضر تتساقطُ في بستانه تحت عاصفةٍ من الغبار الكيمياوي ما زال رومانسياً يمارس الحبّ على طريقته ويدون أيامه بقلمٍ عاشقٍ من أقاصي القهقهة حتى أقاصي البكاء .
القصيدة التي يكتبها أمين والتي أقرأها أنا ( رغم خيانة الترجمان ) تصلني بطاقاتها الحسيّة كأني قرأتها بلغتها الأم فأراني محاصراً بالانزياحات و الأسئلة ، بالتأويلات والشكوك وبالإشارات والأقنعة , ( مللنا ... / من بداية فجر / لفعنا برداء الراهبات / التقطوا أول صورة لهويتنا ... بحجاب عذارى / حين جئنا ... / تربينا بهدهدة ناشزة / لم يمنحونا حق الاستماع إلى أغاني الغجريات / في الحافلات العسكرية نصبوا لنا المهد / وعلقوا الأراجيح / كانوا شياطين .. شياطين ..! / كنا في شك ) في هذه الكلمات التي تنبضُ بنبض المناضل الشاعر كان يصورُ وجه الفاشيست القبيح الذي جالدَ وحشيته ودمويته هو ( ابن الشمال ) مثلما عانيتُ أنا ( ابن الجنوب ) وجالدتُ فأشعرُ أن جراحنا قد تشابهت خلال هذه الهمسات الرافضة كل جغرافيات التهور والآثام والمبجلين الذين لا يهمنا أمرهم رغم غيومهم الداكنة التي غلفت أيامنا الفائتة ويبث إشارات أعرفها رغم مراوغته المتقنة ( لا تعنينا عقاربكم الروتينية / داخل خرائطكم ... / مللنا من البحث عن شارع تمشي فيه آمالنا / تتفتحُ فيه براعمنا / أو زقاق .. يفتحُ لنا الأحضان .. بنهم / بعيداً عن وميض نظراتكم / المشكوكة ) ، والتي أعتقد أنه كان يريد أن يقول ( المشكوك بها ) لكني أحيل الأمر إلى المترجم ، الأستاذ حميد عبد الله بانة يي الذي نقلها إلى العربية . أقول لا يهمنا أمرهم لأننا لسنا من فصيلتهم ولا نفكر بعقولهم التي وسمت الفصول كلها بآيات الخراب .
قبحُ الحروب وضراوة الموت ومتوالياتُ الفقد والهزائم واتساع رقعة السواد ، مهيمنات فرضت سلطتها القهرية على بوح الشاعر رغم تغليفها باستعارات وتآويل شكلت اللعبة الكبرى في نصوصه ، إذن فهو لاعبٌ ذكي حاول توظيف إمكانياته اللغوية وصوره الذهنية لحسم الاشتباكات المتكررة بين ما يضطرب في روحه وما ينزف من قلمه ، فحين يتصدى لحكاية فرهاد ومعشوقته شيرين ، تلك الحكاية الكوردية التي ترسم أقسى ملامح الخسارات في العشق الصادق وتنتهي بضياع الحبيبة إلى الأبد .. فرهاد هو الشاعر وشيرين هي الخسارات الفادحة التي كابدها ، لكن أيّ من الخسارات هذه هي التي أراد ( أمين ) البوح بها ، هو لم يثقب جبل بيستون بمعوله ، ولم يصل إلى السفح الآخر من الجبل ، رغم أن جنونه قد سوّل له فعل ذلك – حسب رغبة والد شيرين الجميلة – ( السفح ) المرتجى لديه ، هل أراد الشاعر في قصيدته ( الشك في سيرة فرهاد ) التي نقلها إلى العربية الأستاذ عبد الله طاهر البرزنجي ومن خلال هذه الحكاية الكوردية المعروفة أن يرفع الراية البيضاء أمام مخالب الحياة بأشكالها المختلفة ، الرماد والضباب والشك والكذب والخديعة وحمل أحزان العالم على كاهله المتعب والأمنيات التي يطلبها من النجوم ولم تحققها له تلك النجوم والأماني المرتقبة بلا جدوى ، قصيدة الشك في سيرة فرهاد فضحت خلجات الشاعر المائجة في صدره ليختمها بخاتمة مجلجلة تخبرنا أن فرهاد هو الشاعر ذاته ( كم كنتُ فرهاداً مغفلاً / لسرابٍ أبدي / ضربت نفقاً في جسدي / وكلّي ثقة الآن / أنني ثقبتُ فؤادي / لا الجبل ...!! ) .
صرخات احتجاج كبيرة يطلقها الشاعر في وجه السواد الذي تمقته روحه المطعونة بتصاريف الأيام وصرخات مجلجلة أخرى يطلقها أيضا في وجه ( الضحّاك ) المتكرر في تاريخ شعبه ، هذه الصرخات التي عرف كيف يصيرها قصائد فيجيد من خلالها انجاز مهمته الإنسانية ومهمته الإبداعية في آن معاً وهي حاضرة في أكثر من مكان في سيرته الشعرية ، لا أملكُ أن أتطرقُ لها كلها في هذا المكان لكنني سأنتخب منها ما يصبُ في المراد ( يا للمأساة ... / إنها المرة الألف ،/ أكونُ الشاهدُ الوحيد على / افتراق التغريد عن منقار العصفور / وسقوط الأوراق من أغصان شجرة حدباء ) أو ( كنّا عاشقين خاسرين ) أو ( عودة العشاق الليلة من حروبهم الخاسرة / يجلبون معهم جثة آخر لقاء ) أو ( أما أنا / فصرتُ قدراً للريح / وصرتُ قدراً للمنفى / وصرتُ عاشقاً مخنوقاً ) ثم يتصاعد هذا الإيقاع الدراماتيكي لنكوص الشاعر وصراعه النفسي مع الزمن القاتم الذي جعل من البلاد كلها جورنيكا متكاملة لينتج صوره الشعرية المشبعة بطاقاتٍ باذخة من الوجع المقدس والأفول البشري والتعرية القسرية لخضرة الحياة ( بينما في أرضي المحروقة / لم تتفتح زهرة / ولم يحيى برعمٌ أصفر ... / من ذكرياتي ) في ناموس الطبيعة ، البراعم تصفرّ إذا عطشت ، ثم يأتيها الماءُ فتخضرّ ، لكن الشاعر يقطع هذا الاحتمال حين يعالج ثيمة الذكريات ، وأسأل هنا : كيف لبراعم ذكرياته أن تخضرّ والغيمُ دخانٌ مميت ؟ .
في كتابه الشعري ( مملكة ما وراء خط الاستواء ... قصائد ونصوص ) استوقفتني ظاهرة شعرية جميلة ، قد نجدها في مجاميع شعرية أخر ، لكنها ليست بهذا الاتساع ، الحب والوفاء للآخر ، من خلال الإهداءات الكثيرة لمبدعين كثر ( رشدي العامل / سعدي يوسف / حسين مردان / بلند الحيدري / محمد مهدي الجواهري / بدر شاكر السياب / رستم آغاله / كاظم السماوي / سامان طاهر / كورش قادر ) كل هذه التفاصيل والرؤى في مملكته القارة خلف حدود الاستواء والمكتنزة بذكريات الطفولة والمنافي البعيدة وآيات العشق وشفاه الجميلات وجبهات الحروب والحزن الكبير ، كل هذا ويزيد سوره الشاعر بالقصب داخل شبرٍ من الأرض ، مساحة بحجم الكف لكنها مشعة بملايين الخطوط الضوئية ، بقصدية واضحة أراد ( أمين ) أن تكون صومعته أو مثابة بوحه الشعري بهذا الحجم ، خالية من الترهل والزيادات القاتلة مستفيداً من مقولة النفري ( كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة ) .
رغم هذا النزيف العذب المرّ إلا أن الشاعر مازال يجأرُ بالرفض والأمل أيضاً ويهيئ ترانيمهُ لأيامهِ القابلة ويرنو لفراشات تتراقص فوق هامات محاربين عائدين من الموت ( دعونا نغني أنشودة للغد / نبحث عن مكان / وأوراق سنوات عمرنا / تودعُها الفتياتُ للرياح / دعونا نفلتُ من جنائنكم ) لكن أيّ جنائن يرومُ الشاعرُ الانفلاتُ منها ؟
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
مختارات
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
890 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- تركيا تنفى طلب مخابراتها من بريطانيا حماية الرئيس السورى إثر محاولة اغتياله
- اسرائيل تكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال المرشد الايراني
- ثري إيراني متهم ببناء إمبراطورية عقارية في لندن لمصلحة نجل المرشد
- الحرب على إيران تشعل الأسواق العراقية تحسبا للحصار
- بذكريات الحصار .. أدوات التسعينيات "اللالة" و"الچولة" تعود إلى منازل العراقيين
- بعد الحرب على إيران .. ترامب يكشف عن وجهته التالية
- الحرب بلا حليف أمرها مخيف ايران نموذجا
- برنامج ألأمثال البغدادية ( "يد وحدة ما تصفك" )
تابعونا على الفيس بوك




















































































