عن أدب التقديم والتقريظ والتصدير للكتب
- التفاصيل
- المجموعة: ثقافة وأدب
- تم إنشاءه بتاريخ السبت, 28 كانون2/يناير 2023 12:33
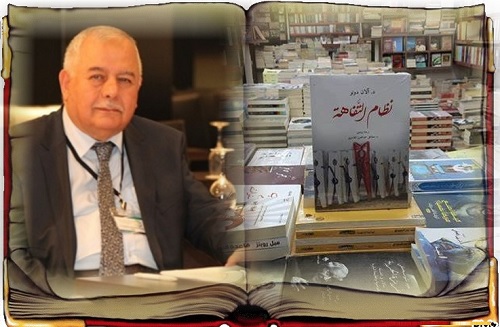
عن أدب التقديم والتقريظ والتصدير للكتب

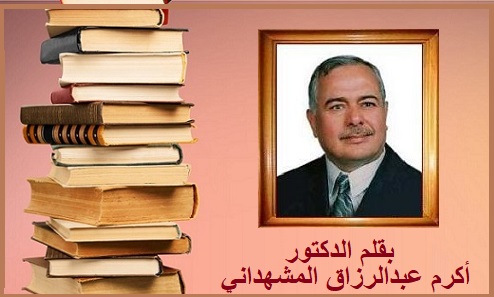
يسألني بعض الأصدقاء، أن أكتب تقديماً أو تقريضاً مُناسباً، لأعمالهم من مؤلفات قانونية او شُرطية او أدبية وغيرها، من باب التقدير والاعتزاز.. والحقيقة ان مصطلح التقديم «foreword» ومصطلح «التقريظ» المعروف في تراثنا العربي شبههٌ بينهما؛ إذ يشتركان في أنهما نصٌّ خاصٌّ يكتبه غير المؤلف عن الكتاب الذي أنجزه، ويوضع بين يديه غالبًا، وربما وُضِع التقريظ في آخره، إلا أنه في «التقديم» يراد به التعريف المُجمل بالكتاب المقدَّم له، والإشارة إلى مبلغ إضافته العلمية لموضوعه، ومواضع الإجادة فيه والمآخذ عليه، ويكاد «التقريظ» يكون خالصًا للثناء على الكتاب والإشادة بمؤلفه دون تعرّض لنقده أو بيانٍ لمواضع نقصه.
وقد يخلط كثيرون اليوم بين المصطلحين، فكم من نصٍّ سُمِّي اليوم تقديمًا وهو تقريظٌ محض، فكأنما عاد «التقريظ» التراثي في إطار «التقديم» المحدث، ومما يرد أحيانًا مورد «التقديم» مصطلح «التصدير»، فقد يكتبه المؤلف أو غيره مؤديًا وظيفة «التقديم»، وليس لهذه الكلمات كما يقول بعض المكتبيين «استخداماتٌ تحدد بوضوح علاقتها بالمؤلف أو غير المؤلف في التأليف العربي الحديث».
وهناك البعض من الادباء قد جُمعت مقدماتهم ونشرت سواء كان الكتاب «لمؤلف معاصر، أو عالم كبير، أو صديق عزيز ليس عملًا تقليديًّا يقوم به الكاتب مجاملة أو تحقيقًا لرغبة المؤلف أو الناشر أو إرضائه، إنه شهادةٌ وتزكية، ولهما أحكامهما وآدابهما ومسؤوليتهما، وقد يتحوَّل من شهادةٍ بالحق وتقييم الكتاب تقييمًا علميًّا، وبيان مكانته فيما كُتِب وأُلِّف في موضوعه، ومدى مجهود المؤلف في إخراج هذا الكتاب ونجاحه في عمله التأليفي أو التحقيقي، إلى سمسرةٍ تجارية أو قصيدة إطراء من شاعرٍ من شعراء المديح، فيفقد قيمته العلمية والأدبية ويتجرد من الحياة والروح، وهو زيادة معلوماتٍ وإلقاء أضواء على موضوع الكتاب ومقاصده، وعلى حياة المؤلف ومكانته بين العلماء المعاصرين وفي عصره ومصره، وعلى تكوينه العقلي ونشوئه العلمي، والدوافع التي دفعته إلى التأليف في هذا الموضوع رغم وجود مكتبة واسعة في موضوعه أو مجموعة من الكتب التي أُلِّفت في هذا الموضوع، ولا يكون التقديم مجموع كلمات تقريظٍ ومدحٍ يمكن أن يحلَّى بها جيدُ أي كتاب إذا غُيِّر اسمه واسم مؤلفه. فلا بد من أن تكون بين المقدِّم للكتاب وبين موضوعه صلةٌ علميةٌ أو ذوقية، أو دراسةٌ وافيةٌ للموضوع وما أُلِّف فيه، وارتباطٌ وثيقٌ كذلك بينه وبين المؤلف يُمكِّنه من الاطلاع على تركيبه العقلي والعلمي والعاطفي إذا كان الكتاب في موضوع علمي أو أدبي أو فكري أو دعوي، وعلى مدى إخلاصه لموضوعه واختصاصه وتفانيه فيه ورسوخه في العلم والدين وأخذهما من أصحاب الاختصاص فيه المعترف بفضلهم إذا كان الكتاب في موضوع دينيٍّ كالتفسير والحديث والفقه وما إلى ذلك. ويلخص الأستاذ عباس العقاد، وهو من أكبر أدباء العربية وأبرز كتَّاب المقدمات لعصره، المقصود الأعظم من تقديم الكتب بعبارة وجيزة في مقدمته لكتاب «ثورة العصر» لهيوستون واتسون، فيقول: «والمقصد الطبيعي من كل مقدمة تُكتب لرسالة في الموضوع أن نرى ما أضافته هذه الرسالة لموضوع هذا البحث من جديد، ونعرف ما هو السهم الذي اشترك به مؤلفها». ولا يمكن أن يحرِّر المقدِّم قيمة الكتاب العلمية، ويُبِين للقارئ عن مقدار اسهامه في إثراء الموضوع الذي يعالجه، ويضعه موضعه اللائق به بين الكتب المؤلفة في بابه، ما لم يكن عارفًا بمجاله، ممتلئًا منه، مطلعًا على مصادره. والمتأمل في كثير مما يُكتَب من المقدِّمات للكتب يجده كما قال الدكتور محمد رجب البيومي في مقالته «أمانة الكلمة في مقدمات الكتب»: «يميل إلى الإسراف في الثناء، ويتحدث عن المؤلف أكثر مما يتحدث عن الكتاب، مع أن مهمة المقدمة الأولى هي تسليط الضوء على ما جاء بالكتاب من إضافاتٍ جديدة لا توجد في سواه، فإذا تعذرت هذه الإضافات فمجال الحديث يتجه إلى أهداف الكتاب ومنهجه الفكري ومنحاه التعبيري، وقد يخالف المقدِّم صاحب الكتاب في بعض آرائه فيشير إلى وجهة نظره دون حرج».
وفي معاناة التقديم للكتب يقصُّ علينا الأديب الحجازي الشهير حمزة شحاتة نبأه معها، ويشير إلى وظيفة التقديم المُثلى وصلة المُقدِّم بالقارئ، في تقديمه الظريف لكتاب «شعراء الحجاز في العصر الحديث» لعبد السلام الساسي: «والقارئ لا شكَّ يعلم أن من مصطلح أدب التقديم الذي جرى فيه الناسُ على مألوف العادة والعُرف أن يكون تنبيهًا عريضًا إلى المحاسن، وإعلانًا عنها ولها، وإشارةً مجملةً إلى نقائضها وأضدادها لا تخرج عن نافلة الاستبراء بحركةٍ أو بحركتين إن رؤي أن هذا ضروريٌّ لإثبات الأمانة!
ومن المقدمات الجياد المحققة لوظيفة التقديم على الوجه الأمثل مقدمة شيخ الأزهر مصطفى المراغي لكتاب «صلة الإسلام بإصلاح المسيحية» لأمين الخولي، فقد أحسن التعريف به، والعرض لموضوعه، والإشارة إلى محاسنه، ومناقشته في بعض ما ذهب إليه، فجاءت كما قال مؤلفه « أَلِفَ الناسُ من هذه المقدمات ما هو التقريظ أو ما يشبهه، لكنما أراد الله أن تكون هذه المقدمة مثلًا من حرية الفكر ونزاهة النظر الديني في مناقشة مولانا الأستاذ الأكبر لنتائج هذا البحث بما تركتُه بين يدي القارئ دون تعليق».
ويتفاوت المقدِّمون في إجادة تقديمهم لكتب غيرهم، بحسب منازلهم من التحري والتثبت، والعلم والمعرفة، والبصر والعناية بموضوع الكتاب خاصة، فمنهم الظالم لنفسه المتكلف ما ليس له به شأن، ومنهم المقتصد القائم بحق التقديم كما ينبغي له، ومنهم السابق بالإحسان الذي ربما كانت مقدمته أهمَّ من الكتاب الذي يقدِّم له وأكثر غناءً ونفعًا، ومن أولئك السابقين الأستاذ عباس محمود العقاد، وللناس في طلب التقديم لكتبهم مآرب شتى، كما يقول الشيخ علي الطنطاوي: «لقد كتبتُ مقدمات لأكثر من أربعين كتابًا، من مؤلفيها من هو مبتدئ يعتمد على مقدمتي ليقوم فيرى الناس كتابه، ومنهم من هو مثلي لا يحتاج إليَّ ولكن ينوِّع مائدته حين يضع مقدمتي مع كتابه، ومنهم من هو أفضل مني ولكنه كرَّمني حين جعلني أقدِّم كتابه للناس وكتابه متقدِّمٌ بلا تقديم» وما زال الكتَّاب يغالون في طلب تقديم الكبار لمؤلفاتهم، ويتماوتون عليه؛ لتلك الأسباب وغيرها، وربما أظهر بعضهم عيبه والأنفة منه ثم لم يلبث أن سعى إليه! كما وقع للأديب المشاكس حبيب الزحلاوي، فقد كتب مقالة عن مغالاة أدباء الشباب في استكتاب الشيوخ مقدماتٍ لكتبهم، ومغالاة الشيوخ في مدحهم، قال فيها: «من يطالع الكتب التي يكتبها أدباء الشباب يجدها مصدَّرة بمقدماتٍ تلفت النظر، لا في خروجها عن المألوف في مقدمات الكتب السابقة لعصرنا الحاضر، ولا في التزام أساليب الغربيين ومحاكاتهم في تقديم الكاتب وتعريف مضامين مؤلفه، بل لظاهرة المغالاة العجيبة وعدم الصدق في القول الذي لا ينطبق لا على الكتاب ولا على كاتبه.
ما بالك بهم وقد توهموا اعتباطًا أن مقدمات الكتب وحشوَها بما لا يحصى من أوصاف النبوغ والعبقرية تكفي للهيمنة على عقول القراء واجتذابها إليهم وتحويلهم عن قراءة كتب أدباء الشيوخ المعروفين. لو كانت الأوصاف والمزايا والنعوت التي يسبغها الواحد على الآخر من هؤلاء المؤلفين صادقةً وصحيحةً لهان الأمر وكان لهم ما يبرر تمادحهم وتقارظهم، إنما تأخذك الدهشة حين لا تجد في متن الكتاب نبوغًا ولا عبقرية ولا شيئًا مما قالوه في المقدمة، بل يخيَّل إليك أنك ترى جسم قزمٍ يتدثر جلباب عملاق، فيغلبك الضحك والهزء والسخرية.
وقد أخذتنا الدهشة حين لم يمض غير يسير ورأينا هذا الكاتب يسعى إلى العقاد ليقدِّم له كتابه «شعاب قلب»! وقد صدر بتقديمه، وستراه في موضعه «مقدمات العقاد».
ولئن كان استكتاب التقديم سائغًا لمصلحة فإن الإلحاف في طلبه لا يليق بغنيٍّ ذي مرَّة، وما رأيت رسائل العلامة عبد الله الطيب الملحَّة على طه حسين لتقديم كتابه الفحل «المرشد» وتملُّقه له وتهالكه عليه إلا أدركتني غصَّة.
ولم أر العقاد أصدر شيئًا من كتبه بتقديم أحدٍ من رفاقه أو كبار أهل عصره، من مبتدأ أمره وأول عهده بالكتابة إلى آخر عمره، إلا كتابًا واحدًا قدَّم له أنور السادات على غير اختيار من العقاد فيما أحسب، وهو كتاب «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» الذي نشره المؤتمر الإسلامي بالقاهرة سنة 1957، وكان السادات سكرتيرًا عامًّا له، وقد جاء تقديمه رسميًّا وظيفيًّا لبيان فكرة الكتاب والثناء على العقاد وسبب انتدابه لتأليفه، ومما قاله فيه بعد الإشارة إلى ظاهرة النيل من الإسلام والتشكيك فيه بدعوى حرية الفكر، والتأكيد على أن الحرية تتطلب غزارة المعرفة، واتساع الأفق، وعمق البحث، وسلامة المنطق، ونصاعة الحجة، وإيمان القلب، وإنصاف الرأي، واستقامة المذهب، والتنزه عن الهوى: «ولما كان محل اتفاقٍ أن الأستاذ عباس محمود العقاد موفور النصيب من هذا كله كان طبيعيًّا أن يتجه التفكير إليه، وكان طبيعيًّا أن يرتاح هو إلى هذا الاتجاه؛ لما أخذ نفسه به من مؤازرة الحق وتأييده، ومقاومة الباطل وتفنيده». ومن فوائدها التعريف ببعض الأعلام المغمورين الذين نسيهم الناس على جلالة منازلهم وعظيم آثارهم، كالشاعر علي شوقي الذي يرى العقاد أنه كان «نسيج وحده في نهضة الإحياء العربية، وكان خليقًا بديوانه أن يشغل بين الدواوين المنشورة مكانه الذي لا يغني عنه غيره».
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1119 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- تنويه الى الأخوة والأخوات كتاب وقراء مجلة الگاردينيا المحترمين
- لقاء مع صدام حسين بعد السقوط!
- سرد ما قل ودل .. الكتابة المستقبلية للرواية العالمية
- الولادة من رحم الأقدار والأقلام.....
- ترمب يعيد العلاقات مع العراق إلى المربّع الأول!
- عراقيون يتطوعون بألوية "استشهادية" دفاعاً عن إيران (صور)
- هل توجد حياة خارج كوكبنا؟ .. اكتشاف جديد يثير اهتمام العلماء
- لماذا ينسى البعض منا أسماء الناس؟.. علم النفس يجيب
تابعونا على الفيس بوك




















































































