الطبيب المؤثر (البلوغر) أم المؤثر الطبيب؟
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 09 نيسان/أبريل 2025 21:27
- كتب بواسطة: د.أسامة شكر محمد أمين
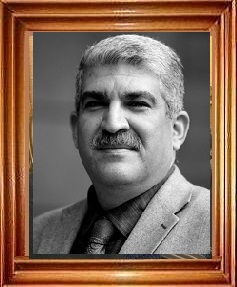
د. أسامة شكر محمد أمين
الطبيب المؤثر (البلوغر) أم المؤثر الطبيب؟
أتذكر جيدًا منتصف الثمانينات حين كان أخي الصغير يعاني من حساسية في القصبات الهوائية، مصحوبة بسعال ونوبات ضيق تنفس متقطعة لكنها كانت شديدة. بناءً على نصيحة طبيب صديق للعائلة، زرنا الدكتور عبد الجليل خليل البرزنجي، وهو طبيب متخصص في أمراض الأطفال، في عيادته الواقعة في ساحة بيروت بالقرب من مرطبات حمورابي آنذاك. كان منزلنا في شارع فلسطين، قريبًا جدًا من العيادة. عرفت الدكتور البرزنجي من ابتسامته الودودة التي كانت تبعث الطمأنينة في قلوب أهالي الأطفال، ومن صوته الهادئ المميز.
كان لبرنامج "الأسرة والطفل" الذي كان يقدمه الدكتور عبد الجليل البرزنجي على القناة الأولى في تلفزيون جمهورية العراق تأثير كبير من الناحية التثقيفية الطبية على الأمهات في جميع أنحاء العراق. استخدم الدكتور البرزنجي ألفاظًا وتعبيرات باللغة العامية البغدادية (الجلفي) كانت مفهومة وسهلة الوصول إلى الجميع، كبارًا وصغارًا، متعلمين وغير متعلمين، سكان المدن والأرياف على حد سواء. تميز أسلوبه في شرح الأمراض أو العلاج أو الوقاية بخلوه من الكلمات الأجنبية (الإنكليزية) أو الصعبة أو الغامضة، وهو ما استقبلته الأم العراقية باهتمام بالغ، خاصة الأمهات الشابات اللاتي لديهن طفل أول حديث الولادة. كان البرنامج الذي ابتدأ بثه في بداية الثمانينات من اخراج صادق مهدي شعبان (رحمه الله، انتقل الى بارئه في العام ٢٠٢٣ عن عمر يناهز ٧٢ عاما بعد صراع مع المرض) ومن اعداد قسم البرامج العلمية في تلفزيون العراق.

الطبيب البرزنجي مقدما لحلقة عن طريقة تحميم الطفل الحديث الولادة. الصورة من برنامجه "الأسرة والطفل" المعروضة على قناة علي صادق للأرشيف على منصة اليوتيوب، مشكورا.
على الرغم من أن لقبه يشير إلى أن الدكتور البرزنجي من أصل كردي (غير عربي)، إلا أنه كان بغدادي المولد والنشأة. في بعض حلقات برنامجه، كان من الواضح أن التصوير تم في إحدى المستشفيات الحكومية (في الردهة أو العيادة الاستشارية)، بينما تم تصوير حلقات أخرى في عيادته الخاصة. اختفى البرنامج في أواخر الثمانينات وتوقف نهائيًا دون أن يتم تعويضه ببرنامج أو مقدم آخر. كان الدكتور البرزنجي عضوًا في الهيئة التدريسية في كلية طب بغداد (كليتي العزيزة) منذ أوائل السبعينات، وفي فترة ما بعد تقاعده في العام ٢٠٠١، غادر العراق واستقر في المملكة المتحدة. انتقل إلى رحمة الله في فبراير ٢٠١٥ بعد معاناته من جلطة دماغية، رحمه الله صاحب الابتسامة المتفائلة، بعيدًا عن وطنه، غريبًا مغتربًا، حاله كحال العديد من الكفاءات التي خدمت بلاد ما بين النهرين بإخلاص وتفانٍ.
مع ظهور وتطور منصات التواصل الاجتماعي خلال الخمسة عشر عامًا الماضية (منذ عام ٢٠١٠ تقريبًا)، وسهولة الوصول إلى أي مجتمع وفرد في جميع أنحاء العالم، أصبح لهذه المنصات تأثير إيجابي وسلبي، بل وخطير في كثير من الأحيان. مع ازدياد صعوبة جوانب الحياة اليومية وتزايد أعداد الأطباء، أصبحت فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وسائل بسيطة وسهلة الاستخدام والوصول من وإلى عامة المواطنين، بعيدًا عن وسائل الدعاية التقليدية الباهظة التكلفة في الإذاعة والتلفزيون.
أصبح من الضروري، لمواكبة التطور التقني والزمني، على المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والمراكز الطبية الخاصة في مختلف الدول (وفقًا لقوانينها) أن تعلن عن خدماتها العلاجية والفحصية وكوادرها المتخصصة من أطباء وممرضين وعلاج طبيعي... إلخ، مع توفير العنوان الكامل والدقيق وأرقام الهواتف الأرضية والمحمولة للاستعلام والحجز والشكاوى.
كنتيجة لذلك، حدث تحول نوعي سهل على المواطن العثور على طبيب أو جراح أو خدمة طبية معينة بسهولة وسرعة، سواء في دولته أو في دول أخرى مجاورة أو بعيدة للسياحة العلاجية، وكل ما يحتاجه لذلك هو توفر خدمة الإنترنت فقط.
عامًا بعد عام، رأينا صفحات (ما يطلق عليها "پيجات") لأطباء واختصاصات مختلفة. تطورت هذه الصفحات من مجرد الإعلان عن الطبيب واختصاصه مع توفير العنوان والهاتف فقط، إلى نشر مقاطع فيديو بتقنيات تصوير ومونتاج عالية الجودة، مع إضاءات متطورة وألوان خلفية وجانبية وأمامية خاصة، وأحيانًا مع موسيقى مؤثرة وحركة عدسة احترافية. بعض مقاطع الفيديو القصيرة (ما يطلق عليها "ريلز") بسيطة التصوير والأداء من جهة أخرى.
في هذه الفيديوهات، قد يتحدث المقدم (الطبيب) عن مرض معين أو طريقة علاج خاصة، والبعض الآخر يتضمن حوارًا بين الطبيب ومريضه، أو يتحدث المريض بمفرده عن كيفية شفائه أو علاجه الناجح على يد طبيب معين في مستشفى أو عيادة معينة. لاحظت أن أسلوب الكلام والشرح لدى العديد (وليس الكل) من الأطباء يتخلله الكثير من الألفاظ والتعبيرات غير العربية (باللغة الإنجليزية)، والتي بالتأكيد غير مفهومة للمواطن العادي البعيد عن المجال الطبي. رأيت بعض الأطباء يتحدثون عن أمراض نادرة الحدوث (جدًا جدًا) مع منشورات تبدو تثقيفية حول كيفية تشخيص أو علاج هذه الأمراض.
تدريجيًا، وعبر السنوات الأخيرة التي تلت جائحة كوفيد العالمية، وللحاق بالركب، تطور الأمر بشكل كبير وأصبحنا نرى أطباء جالسين فيما يشبه الاستوديو (تابع لشركات دعاية مختصة) مع زوايا تصوير ثابتة وميكروفونات إذاعية كبيرة الحجم أمام أفواههم مصحوبة بإضاءة احترافية ومونتاج صوتي ومرئي عالي الجودة، وذلك فقط على سبيل المثال لشرح ماهية الصداع النصفي.

يظهر كاتب المقال في الصورة أثناء حديثه عن التحضيرات لمؤتمر طبي. استغرق هذا اللقاء القصير دقائق معدودة، وجرى تصويره باحترافية عالية داخل استوديو مجهز بكاميرتين ومعدات إضاءة متخصصة وميكروفون إذاعي وديكور معين، كما ورد في تفاصيل المقال.
ما هو دور الإعلام الحكومي والحزبي والخاص؟ في دول عديدة، ومنذ عقود، وفي برامج تكون صباحية عادةً، يصادف وجود أحد الضيوف من المجال الطبي للحديث الموجز عن موضوع طبي معين. بعض القنوات خصصت مساحة زمنية، يومية أو أسبوعية، لبث برنامج معين للحوار مع الأطباء. الملاحظ أن بعض هذه البرامج استعانت بمقدمين ما زالوا طلبة طب (لم يتخرجوا بعد) أو حديثي التخرج. هل من الممكن أن يحاور هؤلاء المقدمون (قليلو الخبرة والمعلومات) أطباء كبارًا في السن؟ وعليه، نجد أن أغلب (وليس جميع) ضيوفهم من الأطباء حديثي الاختصاص مع تكرار ظهورهم الإعلامي.
بعض هذه البرامج أصبح علامة تجارية عالمية، كالبرنامج الأمريكي الحواري الأطباء The Doctors، الذي عُرض من عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠٢٢. أجرت المجلة الطبية البريطانية دراسة عام ٢٠١٤، شملت ٤٠ حلقة مختارة عشوائيًا من برنامج "الأطباء"، ودرست صحة ٨٠ جملة أو توصية مختارة عشوائيًا في كل حلقة. وخلصت الدراسة إلى أن "الأدلة تدعم ٦٣%، وتتعارض مع ١٤%، ولا توجد أدلة في ٢٤%" من التوصيات التي قدمتها لجنة الأطباء في البرنامج، ونصحت الجمهور "بالشك في التوصيات المقدمة في البرامج الحوارية الطبية". إذن، هل كل ما يقال أو قيل جدير بالثقة والأخذ به؟
يسأل أو سأل المواطن البسيط استفسارًا: كيف تتم آلية اختيار الضيوف في هذه البرامج الحوارية الطبية؟ مع ملاحظة أن وجود هكذا مادة إعلامية في المجتمعات الصغيرة أو الضيقة يعتبر وسيلة دعائية قوية للضيوف للاستمرار في سوق العمل الخاص.
وعليه نعود للغرض الرئيسي من الحديث، هل تعمل بصمت وتترك عملك يتحدث عنك وعن إنجازاتك أم تلجأ لوسائل دعائية متعددة لكسب الزبائن (المتأثرين بمادتك الإعلامية الفيديوية الصوتية)؟ أصدرت العديد من الهيئات التنظيمية والمنظمات المهنية في جميع أنحاء العالم إرشادات وتوصيات خاصة لمعالجة كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام من قبل الأطباء. مثلًا، من أقوى مزايا وسائل التواصل الاجتماعي القدرة على التواصل الفوري مع المرضى. هذه الخاصية تحديدًا طمست الحدود بين الحياة الشخصية والمهنية. رغم وجود جوانب إيجابية مؤكدة لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن سلوك بعض المستخدمين على الإنترنت يؤثر سلبًا على زملائهم، وعلى المجتمع الطبي والجراحي، وعلى المهنة الطبية ككل. وقد سهل هذا الوجود الإلكتروني المجهول الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي (الحسابات مجهولة الهوية)، للأسف، انتشار الآراء المتطرفة، وأجج التصيد غير المرغوب فيه والتنمر الإلكتروني. مثلًا، قد نشاهد صفحات معينة (التي قد تكون ممولة) تمدح عن طريق حسابات وهمية طبيبًا بالاسم أو تجرح سمعة زميل آخر باسمه الصريح لسبب معين. مع ملاحظة أن البعض من المرضى الحقيقيين أو عن طريق مرافقيهم قد يعطون معلومات مضللة مدفوعة بتجربة سلبية شخصية، كالتأخر في الانتظار أو غلاء التكلفة، دون ذكر الكفاءة الحقيقية الطبية أو النتائج الملموسة الإيجابية.
من المتفهم أن مهنة الطب، ومنذ فجر البشرية، هي التي أطالت متوسط عمر الإنسان، وأنها رسالة إنسانية، ولكنها مهنة "ذات عائد مادي" ومن حق الطبيب البارع الكفء الحصول على ثمن لخدماته الطبية. فالطبيب إنسان وجميع الوظائف لها عائد مادي ومعنوي. ولكن، هل أن تحول الطبيب إلى مؤثر إعلامي وفيسبوكي وإنستغرامي (بلوغر) ومع إعلانات ممولة وشبه يومية هو مصدر منحه السمعة والثقة والكفاءة؟ في ظل غياب الرقابة والتوجيهات التي تنظم المحتوى الطبي المرئي على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، سيؤدي ذلك حتماً إلى انتشار معلومات غير دقيقة ومضللة. بالإضافة إلى ذلك، ستستغل جهات ذات أجندات خاصة هذا الفراغ لشن حملات دعائية سلبية تستهدف القطاع الطبي، مما سيؤدي إلى تفاقم انعدام الثقة بين المواطنين والأطباء.
د. أسامة شكر محمد أمين
طبيب استشاري في طب الأعصاب وزميل كليات الأطباء الملكية في إدنبرة وغلاسكو ودبلن ولندن

فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
897 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- أفكار شاردة من هنا هناك/١١٨
- التمديد المتوقع والانسداد الدستوري في العراق
- فيديو / فشل عملية سطو هوليودية نفذتها عصابة محترفة بإيطاليا يشعل المنصات
- إرشادات مهمة لحماية الأطفال في منصات الذكاء الاصطناعي
- ما هي أقوى جوازات سفر في العالم؟ ... وما هي أضعفها؟ ... وما هو ترتيب الدول العربية؟
- سرد ما قل ودل.. الكتابة المستقبلية للرواية العالمية
- جولة بغدادية /الگاردينيا كانت هناك
- كيف تقوم بتشغيل سيارتك عن بُعد عبر هاتف آيفون؟
تابعونا على الفيس بوك




















































































