ثنائي المعبد ــ القصر
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 10 شباط/فبراير 2025 21:39
- كتب بواسطة: د.ضرغام الدباغ
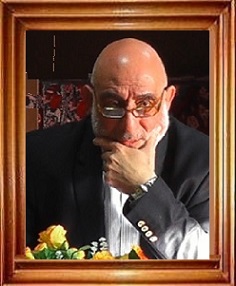
ضرغام الدباغ / برلين
ثنائي المعبد ــ القصر
مرت المجتمعات الإنسانية في مرحلة كان المعبد فيها هو مقر الحكم، والكاهن الأعظم هو الملك بنفس الوقت، ونظريات حكم تزعم الحلول الإلهي، أي أن جزاْ من الآلهة قد حلت في الملك نتيجة اتصال بين الآلهة ووالدة الملك، التي كانت على الأرجح من العاملات في المعبد أو وفق نظرية التفويض الإلهي، أن الملك يحكم باسم الآلهة وتفويض منها.
أردنا بهذه المقدمة الوجيزة، استعراض التأثيرات والمنفعة المتبادلة بين الدولة والمعبد، ومن خلال هذا التحالف الوثيق، نشأت نظرية الحلول الإلهي، أي حلول جزء من الآلهة في الملك، ومن ثم تطورت بنتيجة وعي الناس إلى نظرية ما زالت قائمة حتى اليوم في بعض الدول، وهي نظرية الحق أو التفويض الإلهي، أي أن الحاكم مخول باسم الآلهة أو الله. وقد أطلق على الملوك أحياناَ: ظل الله في الأرض.
وقد اشتد الطلب على هذه العوامل دون ريب في المراحل اللاحقة، في القرون الميلادية وواصل الفلاسفة والمفكرون نشاطهم بعد دخولهم المسيحية، ولكن تناقضاً كامناً كان يظهر ويبرز إلى سطح الأحداث بأشكال مختلفة بين سلطة الملك الدنيوية وسلطة الكنيسة الدينية. فالسلطة الملكية كانت متجذرة لدى الشعوب الأوربية بحيث يصعب على الكنيسة اقتلاعها، بل أن المسيحية ومنذ بداياتها كانت تحترم السلطة الملكية، أو لم يقل السيد المسيح مخاطباً الناس: " أعطوا ما لله لله وأعطوا ما لقيصر لقيصر ! ".
إذن كانت السلطة والحكم شأناً دنيوياً احترمته المسيحية الأولى، في حين اتجهت العقيدة الدينية إلى البحث في خلاص الروح، وغلى حاجة الإنسان إلى تلمس العزاء الروحي. وكانت مثل هذه الأفكار توجد حتى في العهود الوثنية، ولكن المسيحية جاءت وأخرجتها بطريقة لاقت قبولاً أوسع.
كانت هذه هي المراحل الأولى التي طرحت فيها الكنيسة نفسها كمؤسسة لها السلطة على البشر فيما يختص بالشؤون الروحية والإيمان بالله، قاد لاحقاً إلى بروز متزايد للكنيسة كنظام مستقل عن الدولة وعن سلطة الملك. وكان ذلك لوحده يمثل حدثاً فريداً من نوعه على أساس " المسيحية مبدأ يهدف على تحقيق الخلاص، وهي ليست فلسفة أو نظرية سياسية ". والواقع أن كثير من المبادئ كانت معروفة في أوربا الوثنية، وفي الفلسفة الرواقية" قانون الطبيعة، أو حكومة أرضية تحوطها العناية الإلهية " أو " المساواة أمام الله والعدالة، وهي مثل كانت موجودة قبل المسيحية وجاءت بالبعث بعد الموت " وقد كتب القديس بولس تأكيداً على احترام الكنيسة لسلطة الملوك " لتخضع كل نفس للسلاطين، لأن ليس السلطان إلا من الله، السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، ومن يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. أنه خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعله البشر".
بهذا التأكيد وبنصوص كثيرة غيرها، أصبح الولاء للحاكم مسألة مسيحية مؤكدة، ومع التأكيد على أن الحاكم إنما يحكم لأنه مبعوث من الله، واحترام وتقديس وظيفة الملك أكدت ورسخت نظرية التفويض الإلهي.
ولكن الأمور لم تسر على هذا المنوال طويلاً، فالكنيسة تمكنت من تثبيت أقدامها داخل المجتمعات، وصارت الملاذ الروحي للبسطاء من الناس وهم الأغلبية، كما كان يتقرب إليها أمراء الإقطاع والنبلاء طمعاً في نفوذها الروحي ونيل دعمها، وصار للكنيسة فلاسفة ومفكرون رجعيين يفلسفون سلطاتها ويدعون إلى تعزيزها، ثم تحقق لها نفوذ ثقافي مهم بفعل تصديها للأفكار الثورية التي كانت تدعو إلى إصلاحات جذرية، فنالت بذلك رضى الملوك والقياصرة بوقوفها على جانبهم في معسكر ضم أيضاً أمراء الإقطاع والنبلاء. ومع مكتسبات اقتصادية نالتها الكنيسة تمثلت بالأراضي الزراعية الشاسعة والهبات من الطبقات الثرية، أصبحت الكنيسة تمتلك القوى المادية التي تمكنها من ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وثقافية في المجتمع.
كان توسع الدولة ومؤسساتها، وترسيخ مكانة الكنيسة واكتسابها نفوذاً اقتصادياً وثقافياً، قد أهلها لاكتساب النفوذ السياسي أيضا، فقد بدا أن الأنظمة الملكية كانت بحاجة إلى دعم أمراء الإقطاع وإلى دعم أمراء ونبلاء الإقطاع وإلى دعم الكنيسة معاً في بعض الأحوال التي كانت تستدعي إجراءات هامة، فقد تأسس في القرن الثاني عشر مجلساً مشتركاً يضم رجال الدين والنبلاء وأمراء الإقطاع بالإضافة إلى سلطة الملك، سميت بالمجالس العامة (مجلس طبقات الأمة Les Teats generous ) تعبر عن التمثيل ألمراتبي الذي ظهر في أماكن أخرى من أوربا عدا فرنسا مثل برلمان إنكلترا.
بيد أن هذا التحالف كان يمر بمراحل من المد والجزر، فكلما كانت سلطة الدولة قوية وفاعلة، كانت الحاجة إلى دعم المعبد ضئيلة والعكس صحيح، كلما كانت سلطة الدولة ضعيفة ومهزوزة كانت تستعين بسلطة المعبد لتقوية مكانتها لدى الشعب.
ولكن المجتمع كان يفتقر إلى القوى الاجتماعية والسياسية المنظمة، فالمجتمعات كانت تمر بمرحلة هي أشبه بالعبودية الجماعية، فهناك مؤسسة الحكم وعلى رأسها الملك الذي يمثل أساساً قوة القبيلة الأكثر ثراء ونفوذاً، وهناك قوة المعبد المعنوية / الأخلاقية، ثم هناك طبقة رقيقة من أصحاب الامتيازات من حاشية القصر والكهنة تتمتع بامتيازات بسيطة، ثم غالبية الشعب الذي كان يعمل في نظام عبودي جماعي لصالح الفئات العليا من المجتمع .
وفي مرحلة لاحقة لم يستطع فيها الملوك أن يثبتوا بأنهم أكثر من بشر لا يرتقون إلى مرتبة الآلهة، أي بمعنى أنهم لا يتمتعون بقدرات فائقة سواء برد الأخطار والكوارث الطبيعية، أو حتى بتجنب الهزائم العسكرية، تطورت نظرية الحلول الإلهي Incarnation التي نصت في أكثر من مكان على إيحاءات بأن الملك أو الحاكم إنما هو أبن الآلهة بنتيجة اتصال جسدي بين الآلهة وأم الملك التي ربما تكون إحدى بنات الملك، ومن نسله يتوارث أكبر الذكور الحكم. وتطورت هذه النظرية في أحداث سياسية جسيمة مرت بها الدولة إلى نظرية التفويض الإلهي Divine Right ، وفيها تمت صياغة نظرية مفادها، أن الملك أو الحاكم بوصفه منفذاً لإرادة ورغبة الآلهة، فأن منصبه يكتسب قوة سلطة الآلهة. وقد أيد المعبد هذه النظرية في تحالف عقد بين القصر والمعبد، ضمن فيه الكهنة دوراً قيادياً على الصعيد الثقافي ومزايا ومكاسب اقتصادية واجتماعية، واصل المعبد بموجبها مكانته المتقدمة في المجتمع كقوة أساسية مهمة مقابل إسباغ الشرعية الإلهية على منصب الملك.
ومع تطور مكانة الاقتصاد في حياة المجتمعات وتأثيراته السياسية والثقافية على حياة الناس. وتطور الفعاليات الاقتصادية التي لم تعد مقتصرة على الزراعة وعلى الأنماط العبودية في أعمال الأرض، بل تعدى ذلك إلى حلول التجارة كنشاط رئيسي في حياة المجتمعات وكذلك قيام فعاليات تخدم التجارة والزراعة في إنتاج وسائل الإنتاج وخدمة التطور العام الذي أصاب حياة الناس من احتياجات استهلاكية للمدن والمستوطنات، وكان ذلك سبباً يقود إلى تطور الحياة السياسية والارتقاء بنظريات أنظمة الحكم والسياسة.

فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
682 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- ظاهرة القرقوز المؤسسي .. حين يتسيّد المهرّج على الكفاءة
- مسلسل_عمر - الحلقة السادسة
- طرائف رمضانية - شيطان في المسجد!!
- لماذا سمي شهر رمضان بهذا الاسم وهل له أسماء أخرى؟
- حول الإعجاز العددي للقرآن الكريم
- قصة مدفع "الحاجة فاطمة" من ميادين الحروب إلى طقس رمضاني
- العراق على حافة "حرب الإسناد": احتمالات انخراط الفصائل في صراع واشنطن وطهران
- جهاز الخدمة السرية يقتل رجلاً بعد اقتحامه محيط الحماية في منتجع ترامب بفلوريدا
تابعونا على الفيس بوك




















































































