يهود العراق: دراسة تاريخية من السبي البابلي حتى العصر الحديث
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 27 آب/أغسطس 2025 15:49
- كتب بواسطة: قاسم محمد داود
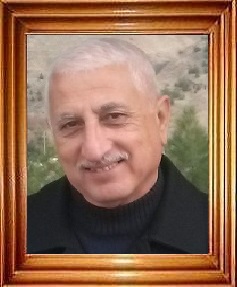
قاسم محمد داود
يهود العراق: دراسة تاريخية من السبي البابلي حتى العصر الحديث
تحليل لتطور الجماعة اليهودية في بلاد الرافدين عبر أكثر من 26 قرناً
يهود العراق هم من أقدم الجماعات اليهودية في العالم، ويُعتبر وجودهم في بلاد الرافدين أحد أقدم التواريخ المستمرة لليهود خارج أرض فلسطين، إذ يعود إلى أكثر من 2,600 سنة، منذ سبي بابل الأول سنة 597 ق.م والثاني سنة 586 ق.م، حين نُفي قسم من يهود مملكة يهوذا إلى بابل على يد الملك نبوخذ نصر الكلداني. ويعتبر العراق من أبرز مراكز الفكر والثقافة اليهودية في الشتات. مرّت هذه الجماعة بأطوار من الاندماج والازدهار والتحديات، وصولًا إلى التهميش والاقتلاع القسري حتى هجرتهم الجماعية. لاسيما في منتصف القرن العشرين. يتناول هذا البحث بأسلوب موضوعي تطور وضع يهود العراق عبر الحقب التاريخية المختلفة، مع التركيز على مسألة الهجرة الجماعية إلى إسرائيل ودور الحركة الصهيونية فيها.
فيما يلي نظرة تاريخية مختصرة عن يهود العراق:
الجذور القديمة (السبي البابلي واستقرار اليهود في بابل وما بعده):
بدأ الوجود اليهودي في العراق مع السبي البابلي الأول عام (597 – 539 ق.م) والثاني عام 586 ق.م على يد نبوخذ نصر الثاني. استقر اليهود في بابل، وأصبحوا جزءًا من النسيج الاجتماعي البابلي. وبعد سقوط بابل بيد الفرس عام 539 ق.م وصدور مرسوم كورش، يشير مرسوم كورش عادةً إلى الرواية التوراتية لإعلان كورش الكبير، الملك المؤسس للإمبراطورية الفارسية الأخمينية، عام ٥٣٩ قبل الميلاد. صدر هذا المرسوم بعد أن غزا الفرس الإمبراطورية البابلية الجديدة وسقوط بابل، ووُصف في التناخ (أسم التوراة في اللغة العبرية)، الذي يدّعي أنه سمح وشجّع على العودة إلى صهيون وإعادة بناء الهيكل في القدس (أي الهيكل الثاني). وقد أطلق على نص أسطوانة كورش أيضًا اسم "مرسوم كورش"، ولكن يُعتقد الآن أن هذا النص يدعم الرواية الكتابية فقط بالمعنى العام للغاية، دون وجود دليل مادي. وحسب هذا السرد الكتابي عاد البعض إلى القدس، لكن الغالبية بقيت، وشكّلت أساس مجتمع يهودي مزدهر، ساهم لاحقًا في إنتاج التلمود البابلي. ويمكن تقسيم ذلك بالتالي:
ــ 597 ق.م – السبي البابلي الأول: في هذا العام، غزا الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني مملكة يهوذا، وسبى الملك يهوياكين ونحو 10,000 من اليهود (من النخبة، كالكهنة والحرفيين والجنود) إلى بابل. ونُقلت العائلات اليهودية إلى مناطق مختلفة من جنوب العراق، خصوصًا قرب نهر الفرات.
ــ 586 ق.م – السبي البابلي الثاني (والأشهر): بعد تمرد مملكة يهوذا، عاد نبوخذ نصر ودمّر هيكل سليمان في القدس تدميرًا كاملاً، وسبى عددًا إضافيًا من اليهود. بهذا الحدث بدأت الجالية اليهودية البابلية تتكوّن بشكل كبير ومؤسس. واستقر اليهود في بابل بعد السبي البابلي، وأصبحوا جزءًا مهمًا من المجتمع البابلي.
ــ 539 ق.م – سقوط بابل بيد الفرس:
عندما غزا كورش الكبير (أول ملوك فارس560 - 529 ق م) بابل، أصدر مرسوم كورش كما أوضحنا سابقاً، الذي سمح لليهود بالعودة إلى القدس وبناء الهيكل. رغم هذا، بقي عدد كبير من اليهود في بابل، إذ وجدوا فيها فرصًا اقتصادية واستقرارًا، وبدأوا يشكلون مجتمعًا قويًا ومستقلاً دينيًا وثقافيًا. خلال القرون التالية (خصوصًا خلال العصر الساساني 224–651 م)، وأصبحت بابل مركزًا دينيًا رئيسيًا لليهود. وتأسست فيها أهم الأكاديميات التلمودية: (سورا وبومبيديتا). وفي هذه الفترة تم تدوين التلمود البابلي (القرن الخامس ميلادي تقريبًا)، وهو من أكبر إنجازات الفكر الديني اليهودي. وإذا ما وضعنا خلاصة بالتسلسل الزمني ستكون كالآتي:
597 ق. م السبي البابلي الأول.586 ق.م تدمير الهيكل والسبي البابلي الثاني. 539 ق.م سقوط بابل ومرسوم كورش. القرن الثالث ق.م – السادس م ازدهار الجالية اليهودية البابلية – ظهور التلمود البابلي استقر اليهود في بابل بعد السبي البابلي، وأصبحوا جزءًا مهمًا من المجتمع البابلي. وبرزوا في التجارة والطب والتعليم. وكانت بابل مركزًا دينيًا وثقافيًا رئيسيًا لليهود لفترة طويلة، وخرج منها "التلمود البابلي"، أحد أهم النصوص الدينية في اليهودية.
التلمود البابلي (Talmud Bavli) – تعريف ونبذة تاريخية:
خلال القرنين الثالث والخامس الميلاديين، تطورت في بابل أكاديميات دينية مهمة في سورا وبومبيديتا. "سورا" و"بومبيديتا" هما اسمان لمدينتين في العراق القديم، وكانتا من أهم مراكز الدراسة الدينية اليهودية في العصور الإسلامية المبكرة، وخاصة خلال ما يُعرف بـ عصر الجاؤونيم (الجعونيين)، أي ما بين القرنين السادس والعاشر الميلاديين.
1. سورا (Sura / סורא): تقع جنوب العراق قرب مدينة الحلة الحالية. تأسست فيها إحدى أقدم وأشهر المدارس التلمودية في العالم اليهودي، على يد الحاخام راف (أبو إيليا) في القرن الثالث الميلادي. وأصبحت مركزًا مهمًا لتفسير ودراسة التلمود البابلي، وكان رئيس المدرسة يُلقب بـ "جاؤون سورا".
2. بومبيديتا (Pumbedita / פומבדיתא):
تقع قرب مدينة الفلوجة الحالية في العراق. تأسست فيها مدرسة دينية يهودية كبرى في نفس الحقبة، اشتهرت بالتركيز على التحليل والمنطق في دراسة التلمود. كانت تنافس سورا في الريادة، وكان لها دور حيوي في تطوير الفقه اليهودي. لذلك فإن المدارس الدينية في سورا وبومبيديتا شكّلت معًا المرجع الأعلى ليهود العالم في ذلك العصر. وكان على رأس كل مدرسة جاؤون (Gaon)، وهو لقب ديني مرموق.
استمر تأثير هاتين المدرستين حتى القرن الحادي عشر الميلادي، حين بدأ دورهما يضعف مع صعود المراكز اليهودية في الأندلس وأوروبا. وجود هاتين المدرستين في العراق يُظهر جذورًا عميقة للوجود اليهودي في بلاد الرافدين، الذي بدأ منذ السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد واستمر حتى العصر الحديث. وفي هاتين المدينتين أُلف التلمود البابلي، وهو نص مركب من (المشناه) وهي كلمة عبرية مشتقة من الفعل "شناّه" الذي يعني "يثنِّي" أو "يكرر". وقد تطور معناها ليشمل "يدرس" أو "يشرح" أو "يفسر". والمشناه: هي مجموعة من القوانين الشفوية المدوّنة، جمعها الحاخام يهوذا الناسي حوالي عام 200 م. والجمارة (Gemara): وهي شروح وتفسيرات ونقاشات الحاخامين حول المشناه، وقد أضيفت لاحقاً في بابل. وهي أول تدوين للشريعة الشفوية اليهودية (التوراة الشفوية)، والتي كانت تتناقل شفويًا لقرون. تتضمن (المشناه) الشرائع والأحكام الفقهية والتفاسير التي وضعها الحاخامات والمعلمون اليهود (المعروفون باسم "التنائيم") خلال الفترة الممتدة من القرن الأول إلى القرن الثالث الميلادي. تم تحرير المشناه وصياغتها النهائية في بداية القرن الثالث الميلادي بواسطة الحاخام يهودا الناسي وحكماء جيله. تنقسم المشناه إلى ستة أجزاء رئيسية (تسمى "سيدريم")، وكل جزء منها ينقسم إلى فصول، وكل فصل إلى قطع تسمى "هلخوت" (أحكام). هذه الأجزاء تغطي جوانب مختلفة من الحياة اليهودية، مثل: زراعة (زرعيم): القوانين المتعلقة بالأرض والزراعة. مواعيد (موعد): الأعياد والمواسم وأيام الصيام. نساء (نشيم): قوانين الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية. أضرار (نزيقين): القوانين المدنية والجنائية وعمل المحاكم. مقدسات (قدوشيم): قوانين المعبد والقرابين. طهارة (طهروت): قوانين الطهارة والنجاسة. التلمود البابلي هو أحد أهم الكتب المقدسة في الديانة اليهودية، ويُعد المرجع الأساسي في الشريعة اليهودية (الهلاخاه) والفكر الديني. يُعد هذا النص من أهم المراجع في الفكر الديني اليهودي، وهو يعكس مكانة بابل كمركز روحي وثقافي عالمي لليهود.
أين ومتى ظهر التلمود البابلي؟
تم تطويره وتدوينه بين القرنين الثالث والخامس الميلادي في الأكاديميات الدينية اليهودية في سورا وبومبيديتا في جنوب العراق (بلاد بابل القديمة). استغرق تأليفه قروناً من النقاش والدراسة بين مئات الحاخامات المعروفين بـ "الأمورائيم". التلمود البابلي يحتوي على نقاشات حول القانون، الأخلاق، الفلسفة، الطب، التاريخ، والقصص الرمزية. هو أوسع وأعمق من نظيره الأصغر، "التلمود الأورشليمي"، ولذلك اعتمدته معظم الطوائف اليهودية كمرجع رئيسي. أثر تأثيرًا بالغًا على الحياة اليومية والدينية لليهود، خاصة في الشتات. التلمود ليس كتاباً منظماً بشكل سردي، بل هو أقرب إلى سجال حي بين الحاخامات، مليء بالآراء المختلفة والمتعارضة أحياناً. يُظهر عمق الفكر القانوني اليهودي (الشريعة اليهودية)، وكيفية تطبيقه على أدق تفاصيل الحياة. يمثل ذروة الوجود اليهودي في العراق خلال العصور القديمة. ويعكس الحياة الاجتماعية والاقتصادية لليهود في ظل الحكم الفارسي الساساني. وهذا اقتباس منه: «من ينقذ نفساً واحدة، كأنما أنقذ العالم بأسره.» (من التلمود البابلي، ترجمة وتفسير لاحق).
كُتبت المشناه باللغة العبرية الحديثة، مع بعض التأثر باليونانية واللاتينية. تعتبر المشناه المتن أو الأصل الذي تم بناء بقية التلمود عليه، وهي مرجع موثوق للقانون اليهودي. وكلمة "جمارا" آرامية الأصل وتعني "التكملة" أو "الإكمال"، وتشير إلى الدراسة والتحليل. هي الشروح والتفاسير والمناقشات التي دارت حول المشناه من قبل الحاخامات اللاحقين (المعروفين باسم "الأمورائيم"). تم تدوين هذه المناقشات على مدى عدة قرون (من القرن الثالث إلى أواخر القرن السادس الميلادي) في المراكز الدينية اليهودية في فلسطين وبابل. الجمارا توسّع وتوضح المشناه، وتضيف إليها تفاصيل وأمثلة، وتناقش وجهات النظر المختلفة للحاخامات. توجد نوعان من الجمارا: جمارا أورشليمي (القدسي): وهي الشروح التي تم تدوينها في فلسطين. جمارا بابلي: وهي الشروح التي تم تدوينها في بابل. وتعتبر الجمارا البابلية هي الأكثر شهرة والأوسع انتشارًا.
كُتبت الجمارا باللغة الآرامية بشكل أساسي، مع بعض العبرية. الجمارا هي بمثابة الشرح التفصيلي للمشناه، وكلاهما يشكلان معًا التلمود. لذلك، لا يمكن فهم المشناه بشكل كامل دون الرجوع إلى الجمارا التي تفسرها وتوضحها. باختصار، لذلك فأن المشناه هي المتن الأساسي للقانون اليهودي الشفوي، بينما الجمارا هي الشرح والتوسع لهذا المتن. ويعد المرجع الأساسي في الشريعة اليهودية. التلمود البابلي يعكس عمق الفكر الديني والفقهي لليهود في العراق، وقد ظل مرجعًا هامًا حتى اليوم.
يهود العراق في الفترة الإسلامية في العصر العباسي (750–1258م):
ازدهر يهود العراق تحت الحكم الإسلامي، خصوصًا في العصر العباسي. سُمح لهم بممارسة شعائرهم وكان لهم زعماء دينيون وقضائيون (الرئيس أو "الريش جالوت"). ساهموا في الحياة الاقتصادية والفكرية، وكان بعضهم مترجمين وأطباء ومثقفين بارزين. بغداد، التي تأسست سنة 762م، وأصبحت مركزًا عالميًا للعلم والثقافة، ويهود العراق كانوا جزءًا فاعلًا في هذا الازدهار. كان يُسمح لهم بممارسة شعائرهم بحرية، وكانوا يديرون شؤونهم الدينية والقانونية من خلال الرئيس اليهودي (الريش جالوت)، الذي كان يُعترف به من قبل الخلافة. أسّس اليهود مدارس تلمودية كبرى كما أسلفنا في سورا وبومبيديتا، والتي استمرت في التأثير لقرون، وكان لها دور في الحفاظ على التقاليد اليهودية. في العصر العباسي، نال يهود العراق درجة عالية من التسامح والمشاركة في الحياة العامة، وازدهرت ثقافتهم ودينهم بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخهم خارج أرض فلسطين. ساهموا في الحياة الاقتصادية والفكرية، وكان بعضهم مترجمين وأطباء ومثقفين بارزين لعبوا دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية والفكرية والعلمية، خصوصاً خلال العصر العباسي وما بعده. عمل كثير من اليهود في الطب، الترجمة، التجارة، والعلوم، وكان منهم أطباء في البلاط العباسي، مثل ماسورجية بن إسحاق: طبيب يهودي في القرن التاسع، كان من أوائل من ترجموا الكتب الطبية من اليونانية إلى العربية. منسي بن إسحاق الهذلي: طبيب يهودي عراقي في بغداد، عمل طبيبًا لدى الخليفة المتوكل العباسي (منتصف القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي) من أوائل الأطباء اليهود المعروفين بالاسم في التاريخ العباسي، وذُكر في "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" لابن أبي أصيبعة. ليس اليهود فقط من برزوا في ظل التسامح الذي كان سائداً في العصر العباسي بل كان للمسيحيين دورهم في الحياة العامة ومن الأمثلة على ذلك أَبُو زَيْدٍ حُنَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَبَّادِيُّ عالم ومترجم وعالم لغات وطبيب عربي، مسيحي نسطوري. من أهل الحيرة بالعراق، ولد عام 194 هـ / 810 مـ، ولدَ لأب يشتغل بالصيدلة علمه اللغات. وهو مؤرخ ومترجم ويعد من كبار المترجمين في ذلك العصر، وكان يجيد - بالإضافة للعربية - السريانية والفارسية واليونانية. أما في الاقتصاد والتجارة فقد كان لليهود دور محوري في التجارة الدولية عبر الطرق الممتدة من الهند إلى البحر المتوسط.عملوا كـ صيارفة، ووكلاء تجاريين، وموظفين ماليين لدى الدولة. نظموا شبكات تجارة تعتمد على الثقة العائلية والمراسلات التجارية المشفّرة (خاصة في فترة الدولة العباسية الوسطى). في الفكر والثقافة: ساهم الحاخامات اليهود في صياغة الفكر التلمودي، ومنهم علماء من العراق وردت آراؤهم في التلمود البابلي. كانت الشخصيات اليهودية في العراق خلال العصر العباسي فاعلة في ميادين الطب، الترجمة، الفلسفة، والتجارة، وأثروا بشكل مباشر في النهضة الإسلامية العباسية.
الوضع العام لليهود تحت الحكم العثماني:
هناك معلومات وفيرة عن يهود العراق في العهد العثماني (والذي استمر في العراق من عام 1534م حتى 1917م)، وهي فترة مهمّة شهدت تحولات في وضع الجالية اليهودية بين الازدهار والقيود، وساهمت في تشكيل شخصيتهم الاجتماعية والاقتصادية الحديثة. ففي العهد العثماني، لعب اليهود دورًا اقتصاديًا وتجاريًا مهمًا في العراق، خاصة في المراكز الحضرية الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل. كانوا يشكلون طبقة بارزة من التجار، والصرافين، والوسطاء الماليين، وكان لهم حضور مؤثر في النشاطات الاقتصادية على مستوى الإمبراطورية العثمانية عمومًا، وليس العراق فقط.
أهم ملامح دورهم: كان لليهود وضع قانوني خاص ضمن نظام الملة العثماني، حيث اعتبروا "أهل ذمة"، وكانوا يتمتعون بحكم ذاتي ديني. شكلوا مجتمعات متماسكة، يرأسها "حاخام باشي" (رئيس الحاخامات)، وتحت إشراف الدولة العثمانية. أي يُعترف بهم كأقلية دينية مقابل دفع الجزية، مع السماح لهم بممارسة شعائرهم وإدارة شؤونهم الداخلية. تمتعوا في كثير من الفترات بـ الاستقرار النسبي مقارنة بأوروبا الشرقية، خاصة في المدن الكبرى مثل بغداد، البصرة، والموصل. ولكن مع نهاية القرن التاسع عشر، حصل تطور مهمّ حين بدأت الدولة العثمانية تمنح بعض الحقوق المدنية لليهود، خاصة في ظل إصلاحات "التنظيمات" (1839–1876م). سيطر اليهود على جزء كبير من التجارة المحلية والإقليمية، وخصوصًا تجارة المنسوجات، والتوابل، والمعادن، والحبوب. كانت بغداد مركزًا تجاريًا هامًا، وفيها كانت العائلات اليهودية الكبيرة مثل: عائلة ساسون: بدأت في بغداد ثم انتقلت لاحقًا إلى بومباي ولندن، وكانت من أبرز العائلات التجارية اليهودية. عائلة معود (Ma'ud) وعائلة دانكور وغيرهم ممن برزوا في التمويل والتجارة الدولية. امتهن الكثير من اليهود الصيرفة وتبديل العملات، وكانوا يُعرفون بدقة الحسابات. بسبب الحظر الديني المفروض على المسلمين فيما يتعلق بالفائدة (الربا)، لجأت الدولة العثمانية والوجهاء المحليون أحيانًا إلى اليهود والمسيحيين لتمويل مشاريعهم، أو لتصريف المال. ارتبط بعض الصرافين اليهود بالبلاط العثماني نفسه، أو بحكام بغداد المحليين. تعاون بعض التجار اليهود مع السلطات العثمانية وكانوا يلعبون أدوارًا وسيطة في الجباية أو استيراد السلع. في بعض الفترات، حصل أفراد من الجالية اليهودية على امتيازات خاصة من الباب العالي، مقابل دعمهم المالي أو تقديمهم خدمات استراتيجية.
من أبرز الشخصيات اليهودية في تلك الفترة داود ساسون: تاجر كبير، أسس لاحقًا شركة "ساسون" التجارية العملاقة في الهند والخليج. حسقيل ساسون: كان له دور مهم في العلاقات التجارية مع بريطانيا والهند. يوسف دانكور: حاخام وتاجر، عُرف في بغداد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. عزرا روبين: كان له نشاط واسع في الموصل وشارك في تجارة الحبوب والنفط لاحقًا. حاخام عبد الله سوميخ (1813–1889): زعيم ديني مرموق، أسس يشيفا (وهي مدرسة يهودية دينية حيث يتم تعليم مصادر الهالاخاه (الشريعة اليهودية) وخاصة التلمود، وكذلك طرقات الإفتاء في الديانة اليهودية) مشهورة في بغداد. عزرا روبين دانيال: من أثرياء اليهود في بغداد، ساهم في بناء المدارس والمعابد اليهودية. يوسف غابي: تاجر ومثقف معروف ساهم في نشر التعليم الحديث. ساهم اليهود في تطوير البنوك المحلية والأسواق المالية. امتلكوا شبكات تجارية تمتد من العراق إلى الهند وبلاد فارس والشام، مما منحهم قدرة على تصريف البضائع وإدارة الأزمات النقدية. كما ساعدوا على إدخال أفكار تجارية حديثة إلى العراق، خاصة من خلال ارتباطهم بالأسواق الأوروبية. وفي هذه الفترة، وخصوصًا في القرن التاسع عشر، برز عدد من الأطباء اليهود في العراق ضمن الطواقم الطبية الحكومية والخاصة. تأثرت النخبة الطبية اليهودية بالتعليم الغربي بعد تأسيس مدارس الإرسالية الأوروبية. كثير من أطباء اليهود تلقوا تعليمهم الطبي في إسطنبول أو أوروبا، ثم عادوا للعمل في العراق.
في الدور الاقتصادي، لعب اليهود دورًا محوريًا في الاقتصاد المحلي: تجار جملة، وصيارفة، وحرفيون، ووكلاء ماليون للولاة. كثير منهم انخرط في التجارة الإقليمية والدولية، خاصة مع الهند وفارس وبلاد الشام. بعض العائلات اليهودية أصبحت غنية وذات نفوذ، مثل عائلة دانيال في بغداد، التي كان لها أثر اقتصادي وخيري كبير. وهناك شخصيات بارزة من يهود العراق. مثل ساسون حسقيل أول وزير مالية في العراق، ويُعد من أبرز من وضعوا أسس الاقتصاد العراقي الحديث. وكان معروفًا بنزاهته. موريس صادق: رجل أعمال ومثقف. أنور شاؤول: أديب وشاعر وكاتب يهودي عراقي معروف، شارك في نهضة الأدب العربي في العراق. بدأ التراجع التدريجي مع أواخر العهد العثماني (خاصة بعد 1908)، عندما بدأت تظهر نزعات قومية معادية للأقليات، مما قلل من النفوذ اليهودي التجاري. كما بدأت الدولة العثمانية تميل أكثر إلى "تتريك" الإدارة، وتقليص الامتيازات الأجنبية.
النشاط الثقافي والديني:
استمر نشاط المدارس الدينية اليهودية (يشيفوت)، وكانت بغداد مركزًا رئيسيًا للتعليم اليهودي التقليدي. ظهرت حركات إصلاح ديني وفكري متأثرة بأفكار "الهسكالا" (النهضة اليهودية الأوروبية). في أواخر القرن التاسع عشر، أُنشئت مدارس حديثة بإشراف من منظمة "الأليانس الإسرائيلية العالمية" (Alliance Israélite Universelle)، خصوصاً في بغداد والبصرة. تفاوتت العلاقة بين اليهود والولاة العثمانيين ففي بعض الفترات، نُصّب يهود في مواقع إدارية محلية (مثل إدارة الضرائب). وفي فترات أخرى، تعرضوا للتمييز أو الاضطهاد، خاصة عند وجود فتن دينية أو توتر طائفي. مع ذلك، نادرًا ما كان الاضطهاد ممنهجًا كما حصل لاحقًا في القرن العشرين.
الفترة الذهبية (1921–1930):
مع تأسيس المملكة العراقية تحت حكم الملك فيصل الأول، كان هناك توجه للانفتاح وبناء دولة حديثة. حصل اليهود على مواطنة كاملة بموجب دستور 1925، وأصبحوا مواطنين عراقيين متساوين في الحقوق. انخرطوا في مؤسسات الدولة، وشغلوا مناصب مهمة في الإدارة والبرلمان والجيش والمال. حتى بدأت مرحلة التوتر والصعود القومي (1930–1941): بدأت القومية العربية تتصاعد، ورافقها تزايد الحساسية تجاه اليهود، خاصة مع تصاعد الصراع في فلسطين وظهور المشروع الصهيوني. نُظرَ إلى يهود العراق أحيانًا بشك، على الرغم من كونهم معارضين للحركة الصهيونية في الغالب. استمرت مشاركتهم في الحياة العامة، لكن بدأت تظهر علامات العزلة والتخوف.
النكبة اليهودية العراقية (القرن العشرين):
بدأ وضع اليهود يتدهور مع صعود القومية العربية والصراع العربي الإسرائيلي. ومن الأمثلة حادثة الفرهود (1941) وقد وصفت بأنها مجزرة ضد اليهود في بغداد خلال فراغ السلطة بعد فشل حركة رشيد عالي الكيلاني، راح ضحيتها العشرات. وصدرت قوانين تمييزية ضد اليهود في الأربعينات، وبلغت ذروتها بعد إعلان قيام إسرائيل 1948. أُجبر الكثيرون على الهجرة في عملية "علي بابا" (عزرا ونحميا) (1950–1952). شهدت عملية عزرا ونحميا نقل ما بين 120000 و130000 يهودي عراقي جواً إلى فلسطين المحتلة في الفترة بين 1950 و1952 عبر إيران وقبرص. لم يبقى سوى 2,000 يهودي في العراق اعتباراً من عام 1968. تم تمويل معظم تكاليف العملية البالغة 4 ملايين دولار من قبل لجنة التوزيع اليهودية الأمريكية المشتركة. اليوم لم يتبقَ في العراق سوى عدد قليل جدًا من اليهود (يُقال أقل من 5 أفراد). الجالية الكبيرة الآن تعيش في إسرائيل، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. لا تزال الذاكرة اليهودية العراقية حية عبر كتب ومؤلفات ومتاحف (مثل مركز التراث اليهودي العراقي في إسرائيل).
ثقافة اليهود العراقيين:
كانوا يتحدثون العربية والعبرية، وبعضهم الآرامية اليهودية (اللغة المحكية "اللحجية"). لهم طقوس دينية خاصة تميزت عن اليهود الغربيين. حافظوا على نغمة فريدة في قراءة التوراة، وبعض التقاليد الشرقية. كانت الموسيقى العراقية الكلاسيكية (المقام العراقي) متأثرة بعدد من الموسيقيين اليهود مثل صالح الكويتي وداوود الكويتي.
عائلات يهودية عراقية:
من أبرز العائلات والشخصيات اليهودية في العراق عائلة ساسون التي لُقبت بـ "روتشيلد الشرق" لشهرتها وثروتها، من أبناء العائلة ساسون حسقيل، أول وزير مالية في العراق وشخصية بارزة في الاقتصاد العراقي الحديث. ومناحيم صالح دانيال العضو في مجلسي الأعيان العراقي، والمبعوثان في العهد العثماني، كانت تقطن محلة التوراة في بغداد. وأحمد سوسة المؤرخ والمهندس والآثاري، حاز على وسام الرافدين من الدرجة الثانية عن خدماته في دوائر الري والمساحة في العراق عام 1953م. وأسيناث برزاني عالمة الدين الكردية من القرن السابع عشر، وهي شخصية بارزة في التاريخ الكردي اليهودي. ابنة الحاخام صموئيل بن نثنيل هليفي بارزاني، وهو عالم حاخامات. وتضم القائمة أيضاً شخصيات فنية وسياسية واقتصادية بارزة مثل عائلة الكويتي الموسيقية (صالح وداوود)، وكانا موسيقيين اشتهرا في ثلاثينيات وأربعينات القرن العشرين بوضع ألحان لمغنيي تلك الفترة، بالإضافة إلى وضع العديد من المقدمات واللزمات الموسيقية. لقب صالح الكويتي بـ (أبو الموسيقى العراقية)، وهو أول من أسس الأغنية المأخوذة من المقام العراقي، كما لحن لأشهر مطربات ومطربي تلك الحقبة في العراق أمثال سليمة مراد، عفيفة إسكندر، داخل حسن، زهور حسين، منيرة الهوزوز تلك الألحان التي ساهمت في أثراء الغناء العراقي. وسليمة مراد مغنية يهودية عراقية ولدت في محلة طاطران ببغداد، تعد سليمة مراد إحدى قمم الغناء العراقي منذ أواسط العقد الثاني من القرن المنصرم، حيث احتلت مكانة مرموقة في عالم الغناء العراقي. وهي أول امرأة تأخذ لقب باشا، إلا أنها لم تغادر العراق أيام حملة تهجير اليهود إلى إسرائيل، عندما عمدت الحكومة الملكية العراقية إلى إسقاط الجنسية العراقية عن كل اليهود لإجبارهم على الرحيل إلى إسرائيل، وبقيت في العراق حيث استمرت في ممارسة الغناء حتى السنوات الأخيرة من عمرها. وقد حذت حذوها الفنانة سلطانة يوسف حيث كانت الأخيرة يهودية الديانة أيضاً، ورينيه دنكور التي لقبت بملكة جمال بغداد، والدها كان من أشهر أطباء بغداد وهو من يهود العراق. وكانت عائلتها من العوائل العراقية العريقة في بغداد، فكان جدهم أحد حاخامات يهود بغداد، ساهمت عائلتها في تجارة الورق والطباعة في العراق مما ساعدَ على إنتاج ثقافة صحافية هي الأرقى في تاريخ العراق، وتأسست مطبعة دنكور عام 1904 من قبل الياهو دنكور وهي من أقدم المطابع الأهلية التي اشتهرت في العراق وأصدرت الكثير من الكتب المهمة. فازت رينيه دنكور بلقب ملكة جمال بغداد في تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 1946 وتم تنظيم حفل تتويجها في نادي الطيران العراقي، وفي 1947 توجت بلقب ملكة جمال العراق وكان عمرها آنذاك 21 سنة، تزوجت في نوفمبر 1947 بعد فوزها باللقب من ابن عمها الدكتور نعيم دنكور الذي أسس أول معمل لمشروب الكوكاكولا في العراق. كما ساهمت عائلات أخرى كـ "خلاصجي" في تطور مدينة الديوانية، اشتهرت بزراعة وتسويق الرز وكان إنتاجها يعرف بـ "تمن خلاصجي" عائلة خلاصجي واحدة من أشهر عوائل يهود العراق في ميدان الزراعة والتجارة، كان يطلق لقب ملك الديوانية على شخصية الياهو خلاصجي بسبب دماثة أخلاقه وكرمه ولامتلاكه للأراضي الزراعية الواسعة جدا. وهناك عائلات من أصل يهودي بغدادي مثل عائلة روبنز التي اشتهرت في بريطانيا في مجال الأعمال التجارية. شلومو بيخور حوتزين وهو حاخام وناشر وُلِد شلومو بيخور حوتزين لعائلة حاخامية بارزة في بغداد، العراق في العهد العثماني، وهو من نسل الحاخام صدقا بيخور حوتزين (1699-1743)، مؤلف كتاب "العراق العثماني". أفي شلايم: مؤرخ وسياسي. ولد أفي شلايم في بغداد في 31 أكتوبر 1945 وترعرع في إسرائيل. يتحدث باللغتين العبرية والعربية. يعلن بأنه يهودي عراقي. له كتابات متواصلة في جريدة الجارديان البريطانية. بحسب مجلة (The Nation) فإن آفي شلايم يعتبر واحد من أكثر الأشخاص تعمقا وفهما للصراع العربي الإسرائيلي. وهناك عدد غير قليل من العائلات اليهودية العراقية..
"الفرهود" (1941):
شهد العراق مطلع شهر نيسان/أبريل 1941 انقلابا قاده السياسي رشيد عالي كيلاني، المقرب من الألمان، ضد الحكومة العراقية المؤيدة للبريطانيين. في الأثناء، لقي تحرك رشيد عالي الكيلاني دعم العديد من الشخصيات البارزة كمفتي القدس أمين الحسيني وعدد من أهم قادة الجيش العراقي "المربع الذهبي" العقداء الأربعة: صلاح الدين الصباغ، كامل شبيب، فهمي سعيد، ومحمود سلمان. كانوا قادة عسكريين بارزين ولعبوا دورًا رئيسيًا في تنظيم الثورة.. إلى ذلك، لم تدم هيمنة رشيد عالي الكيلاني على العراق طويلا. فبتلك الفترة، تخوفت بريطانيا من إمكانية فقدانها للعراق الذي مثّل طريقا رئيسيا نحو مستعمرتها بالهند. فضلا عن ذلك، عبّر المسؤولون البريطانيون عن قلقهم من إمكانية ظهور حلف جديد مؤيد للألمان بالشرق الأوسط بقيادة العراق. ولهذا السبب، اتجه البريطانيون للتدخل العسكري بهدف إزاحة رشيد عالي الكيلاني من سدة الحكم وإعادة الحكومة السابقة. ومع نجاح التدخل البريطاني، غادر كيلاني رفقة عدد من مساعديه نحو إيران وتم إعدام العقداء الأربعة فيما بعد في بغداد.
وببغداد مطلع حزيران/يونيو 1941، تسبب التدخل البريطاني بالعراق بأعمال عنف دامية ضد اليهود العراقيين. فمع محاصرة القوات البريطانية لبغداد، تيقن اليهود بزوال خطر حكومة رشيد عالي الكيلاني واتجهوا للاحتفال بعيد (شافوعوت) الذي مثّل عيدا مقدسا لديهم. ومع بداية الاحتفال، أعتقد عدد كبير من سكان العاصمة العراقية باحتفال اليهود احتفالا بانتصار البريطانيين على القوات العراقية المؤيدة لرشيد عالي الكيلاني. على إثر ذلك، اتهم اليهود العراقيون بمساندة البريطانيين. لاحقا، اندلعت يوم 1 حزيران/يونيو 1941 أعمال عنف، عرفت بالفرهود، ضد اليهود. وقد قاد هذه المواجهات حينها عدد من العسكريين والأمنيين، المؤيدين لرشيد عالي الكيلاني، الذين دعوا سكان بغداد لمهاجمة اليهود وتخريب ممتلكاتهم. وأثناء أعمال العنف، رفض عدد من سكان بغداد الانسياق وراء دعوات مؤيدي رشيد عالي الكيلاني واتجهوا لإخفاء جيرانهم اليهود بمنازلهم. استمرت أعمال العنف ضد اليهود ببغداد لنحو يومين حيث استتب الأمن مجددا مساء يوم 2 حزيران/يونيو 1941 عقب تدخل مباشر من القوات البريطانية التي اتجهت لفرض حظر تجول. إلى ذلك، أسفرت أعمال العنف ببغداد حينها عن مقتل ما بين 150 و180 يهودي عراقي وإصابة 600 آخرين. فضلا عن ذلك، قدرت الخسائر المادية بملايين الدولارات حيث شهدت أعمال العنف حينها إحراق وتخريب آلاف المنازل والمنشآت الحرفية المملوكة لليهود. أثارت أعمال العنف المعروفة بالفرهود خوف اليهود المقيمين بالعراق. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، اتجهت الحكومة العراقية لفرض قيود على اليهود العراقيين. وبسبب ذلك، لم يتردد عدد كبير منهم في مغادرة الأراضي العراقية والهجرة نحو الأراضي الفلسطينية التي أعلن عليها اليهود دولتهم عام 1948.
ما بعد الفرهود وحتى التهجير (1941–1951):
رغم عودة بعض الهدوء بعد الحرب العالمية الثانية، تصاعد الضغط على اليهود بعد قيام إسرائيل عام 1948. مُنع اليهود من وظائف الدولة، وفرضت قيود على تحركاتهم، وبدأت حملة اعتقالات وتعذيب ضد بعض التجار والمثقفين. صدر قانون إسقاط الجنسية عام 1950 لمن "يرغب بمغادرة العراق"، فاضطر آلاف اليهود للتخلي عن جنسيتهم مقابل السماح لهم بالهجرة. بين عامي 1950 و1951، تم تهجير أكثر من 120 ألف يهودي عراقي إلى إسرائيل ضمن ما يُعرف بـ "عملية عزرا ونحميا". في عام 1951، صودرت أموال وممتلكات اليهود الذين هاجروا، وكانت تشمل:
منازل، عقارات، شركات، ومحال تجارية. أرشيفات ثقافية ودينية نادرة، بعضها نُقل لاحقًا إلى الولايات المتحدة بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. بين 1921 و1951، انتقل يهود العراق من الاندماج والمواطنة الكاملة إلى الخوف والتهجير القسري. فبعد أن ساهموا بفعالية في بناء الدولة العراقية الحديثة، وجدوا أنفسهم في ظرف إقليمي ودولي جعلهم ضحايا لصراعات سياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
هل كان للحركة الصهيونية دور في هجرة يهود العراق إلى فلسطين (إسرائيل)؟ والإجابة عنه تتطلب نظرة موضوعية ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار عدة روايات ومصادر متباينة.
أولاً: السياق العام قبل الهجرة
معظم يهود العراق كانوا مواطنين مخلصين لبلدهم ولم يكونوا على ارتباط فعلي بالصهيونية. كانت الحركة الصهيونية في العراق ضعيفة ومحدودة حتى نهاية الثلاثينات، ومعظم الزعماء الدينيين اليهود في العراق عارضوها في البداية. حتى بعد قيام دولة إسرائيل سنة 1948، لم يندفع يهود العراق فوراً للهجرة، بل كان معظمهم يفضّل البقاء.
ثانياً: العوامل الأساسية التي دفعت للهجرة
1. العامل السياسي–الأمني:
بعد حرب 1948 وقيام دولة إسرائيل، بدأت حملة رسمية وغير رسمية ضد اليهود في العراق: طرد من الوظائف الحكومية. تقييد الحريات والتنقل. اعتقالات وتعذيب، وأحكام بالإعدام بحق بعضهم بتهمة "التجسس". ومن أبرزها حادثة إعدام شفيق عدس (1948)، وهو تاجر يهودي بارز، أثير حوله الكثير من الشبهات والتساؤلات حول نشاطه التجاري فهو من أصل سوري ولد في حلب عام 1900 ثم جاء للعراق واستقر في مدينة البصرة وكان من كبار التجار في البصرة وكيلاً لشركة فورد للسيارات الأمريكية ومقرها على شاطئ العشار، وكان شريكه في التجارة التاجر العراقي المعروف ناجي الخضيري. كانت صدمة كبيرة لليهود، إذ أُعدم رغم كونه بعيداً عن أي نشاط سياسي. لكن التهمة التي وجهت له من قبل المجلس العرفي العسكري هي أنه يشتري مخلفات معدات الجيش البريطاني في الشعيبة وشحنها إلى إيطاليا ليعاد شحنها ثانية إلى إسرائيل وقد ألقى القبض على شفيق عدس في أيلول عام 1948 دون أن يلقي القبض على شريكه. وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه في 23 أيلول 1948 بالقرب من بيته الذي قارب على الانتهاء ولم يعدم مره واحدة وإنما أعدم مرتين ففي الأولى التي تم إعدامه فيها قام الطبيب بفحصه فوجد أنه ما زال حياً، لتكرر المحاولة مرة ثانية لتبقى معلقة لعدة ساعات، وصف السفير البريطاني في العراق عملية إعدامه بأنه "عملاً مخزياً ولكن أجد من الصعوبة توجيه اللوم للوصي والحكومة اللذين لم يكونا في وضع قوي للوقوف ضد الجيش".
2. الفرهود (1941): المجزرة التي تعرض لها اليهود في بغداد زرعت الخوف العميق، وأثّرت في قرارات الكثيرين بعد سنوات.
3. الحرب النفسية والإشاعات والتضييق الاقتصادي: حملات تشويه، مصادرة أموال، وشعور متزايد بانعدام الأمان.
ثالثاً: دور الحركة الصهيونية – هل كانت لها يد؟ هنا الجدل الحقيقي، ويمكن تلخيصه في ثلاث وجهات نظر رئيسية: الرأي الأول – الصهيونية ساعدت في الهجرة لكنها لم تصنع الظروف:
يرى هذا الرأي أن: البيئة المعادية لليهود في العراق بعد 1948 هي العامل الأساسي للهجرة. الحركة الصهيونية نظّمت الهجرة واستغلت الفرصة، لكنها لم تفتعل الأحداث. عملية "عزرا ونحميا" (1950–1951) كانت استجابة لطلب اليهود أنفسهم بالرحيل خوفًا من المستقبل المجهول. هذا هو الرأي الأكثر شيوعًا في الأبحاث الأكاديمية الغربية المتوازنة. الرأي الثاني الحركة الصهيونية حرّضت وافتعلت أحداثًا لتسريع الهجرة: بعض الباحثين (ومنهم إسرائيليون مثل المؤرخ باروخ نادل والصحفي أوري أفنيري) طرحوا فرضيات خطيرة، منها: أن عملاء صهاينة قاموا بتفجيرات في أماكن يهودية في بغداد عام 1950 (مثل معبد المواصلات ونادٍ يهودي، مركز المعلومات الأميركي قي بغداد وتحديداً الجناح الثقافي الذي كان يرتاده اليهود، مقهى الدار البيضاء في بغداد حيث كانوا يحتفلون بعيد الفصح اليهودي، واجهة شركة بيت لاوي للتجارة في بغداد، استهداف الحي اليهودي في بغداد (البتاويين)، معبد مسعودة شمطوف، وسوق الصفافير في بغداد حيث يتبضع اليهود)، لإثارة الذعر ودفع اليهود للهجرة. اعتمدوا في ذلك على وثائق استخباراتية وتسريبات من أرشيفات إسرائيلية وبريطانية. هذا الرأي لا يحظى بإجماع، لكنه لا يمكن تجاهله تماماً، وهناك ملفات ما زالت غير مكشوفة بالكامل حتى اليوم. الرأي الثالث لا علاقة للحركة الصهيونية إطلاقًا: وهذا رأي مبالغ في تبسيطه، لأن هناك أدلة على: نشاط حقيقي للحركة الصهيونية السرية في العراق. وجود شبكة ساعدت في ترتيب الهجرة والتسجيل. اتصالات مع عملاء ووسطاء، خصوصًا خلال التفاوض مع الحكومة العراقية على نقل اليهود. لذلك ومن مراجعة مصادر عديدة يمكن أن يتضح التالي:
جددت الحركة الصهيونية نشاطاتها في العراق، بعد قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين، بإصرار ومصادر دعم أكبر، وبهدف واضح هو حث يهود العراق على الهجرة إليها. وأخذ وضع اليهود يتدهور بعد قيام دولة إسرائيل، إذ فرضت الحكومة العراقية قيودًا صارمة على سفرهم إلى الخارج وعلى بيع أملاكهم، وسعت إلى إقصائهم عن الجيش والشرطة والخدمات العامة. وفي 4 مارس 1950. أقرت حكومة توفيق السويدي القانون رقم 1 لسنة 1950 بعد الموافقة عليه في مجلسي النواب والأعيان. وجاء القانون الجديد ملحقًا لمرسوم إسقاط الجنسية العراقية (رقم 62 لسنة 1933)، الذي خوّل مجلس الوزراء «إسقاط الجنسية العراقية عن أي مواطن عراقي يرغب في اختياره الحر في مغادرة العراق نهائيًا». ومع أن الحكومة العراقية لم تضع حين أصدرت قانون إسقاط الجنسية أي قيود على أملاك الراغبين في الهجرة، فإنها عادت وأصدرت في 8 مارس 1951 قانونًا بتجميد أملاك اليهود العراقيين الذين أُسقطت عنهم الجنسية. لقد مالت أكثرية اليهود في العراق إلى الاعتقاد أن الصعوبات التي صارت الطائفة تواجهها، بعد قيام دولة إسرائيل، هي قضية مؤقتة ولا بد من أن تزول. لذا، كانت أغلبيتهم ترى أن مستقبلها في العراق، وتنشد التعايش مع الوضع الجديد الناجم عن تأسيس إسرائيل. ثم حدث تطوران كان لهما تأثير عميق في التشجيع على حدوث هجرة جماعية لليهود العراقيين: أولهما، في 7 مايو 1950، حين عُقدت اتفاقية لنقل اليهود بين توفيق السويدي، رئيس الحكومة العراقية آنذاك، وبين شلومو هليل، المبعوث الإسرائيلي وأحد عملاء جهاز الموساد، وُضعت بموجبها عملية إجلاء اليهود في أيدي السلطات الإسرائيلية؛ ثانيهما، بدأت سلسلة من التفجيرات استهدفت أماكن يهودية عامة كما بيناها فيما سبق، في الوقت نفسه الذي كان هليل يفاوض في بغداد بشأن صفقة إجلائهم. وأعلنت الحكومة العراقية في 26 يونيو 1951 عن اكتشاف خلية تجسس في بغداد يديرها أجنبيان ألقي القبض عليهما، وهما يهودا تجّار وهو ضابط إسرائيلي، ومواطن بريطاني يدعى روبرت رودني كان عميلًا للموساد. وقد حققت تلك التفجيرات الغرض الذي توخاه من كان وراءها. فبعد أول اعتداء بالقنابل، أخذ الآلاف من اليهود يصطفون أمام مكاتب التسجيل للهجرة. وفي 5 يونيو 1951 وصل كل أولئك الذين سُجلوا، وعددهم 105000 نسمة إلى إسرائيل. وبحسب الإحصاءات الإسرائيلية، فإن 124646 يهوديًا من مواليد العراق قدموا خلال الفترة منذ تاريخ إقامة إسرائيل في 15 مايو 1948 وأواخر سنة 1953. ويعتبر عباس شبلاق، في كتابه «هجرة أو تهجير: ظروف وملابسات هجرة يهود العراق».، أن دراسة حالة يهود العراق، وهجرتهم الجماعية إلى إسرائيل في الفترة 1950 - 1951، ربما تكون النموذج الأفضل لتحليل وفهم العلاقة بين الحركة الصهيونية ويهود الشرق، والعرب منهم خاصة. فالحركة الصهيونية تبنت - كما يكتب - المنظور الاستعماري الأوروبي وأساليبه بالكامل، وذلك عبر اقتلاع يهود الشرق بصورة قسرية، ونفي وتشويه موروثهم الثقافي وروايتهم وتاريخهم الحافل الممتد قرونًا طويلة في المجتمعات العربية والإسلامية.
الهجرة الجماعية ليهود العراق كانت نتيجة تفاعل عوامل متعددة: الخوف من المستقبل بعد قيام إسرائيل. التمييز والاضطهاد الرسمي وغير الرسمي. تنظيم ودعم من الحركة الصهيونية، التي كانت مستعدة للتهجير الجماعي. أما عن قيام عملاء صهاينة بتفجيرات في بغداد لدفع الناس للهجرة، فهناك اتهامات موثقة أو، لكنها لا تزال موضع جدل بسبب غياب الدليل القاطع حتى اليوم.
............................
مصادر ومراجع:
1- شلومو هليل: العراقي الأخير عملية بابل: قصة إنقاذ يهود العراق، مذكرات عن العملية.
2- إيلي حاييم زعفراني: يهود العراق في القرن العشرين.
3- الوثائق البريطانية 1941–1951.
4- أرشيف الأليانس اليهودية العالمية.
5- عبّاس شبلاق، الزميل الباحث في جامعة أكسفورد، كتابه الصادر في شهر مايو (أيار) 2015 عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ببيروت تحت عنوان: "يهود العراق بين الهجرة والتهجيرــ ظروف وملابسات هجرة يهود العراق".
6- مختصر تاريخ يهود العراق ــ مجاهد منعثر.
7- بغداد أمس ــ البروفيسور ساسون سوميخ ــ ترجمة محمود عباسي ــ دار المشرق.

فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1031 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- أريد ان أنسى ... قصة قصيرة
- كي لا ننسى جرائم أحفاد القرامطة (٨)
- فيديو - كليچة هشة و تذوب بالفم بطريقة سهلة
- "رمضان زمان ذكريات لا تنسى وحنين للماضي لا تزال عالقة في الوجدان"
- "أين الطيار الحقيقي؟".. رسالتان غامضتان في ملفات إبستين يهزّان رواية ١١ سبتمبر
- متى ستتوقف التعابير والأفعال العنجهية الأميركية
- الافق يتجهم أکثر بوجه نظام الملالي
- ماذا يخبرنا عام ١٩٧٩ عما قد يحدث في إيران اليوم؟ - مقال في الغارديان
تابعونا على الفيس بوك




















































































