سقط الأسد.. فلماذا لم ينتقم السنة من العلويين؟؟
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 02 كانون2/يناير 2025 07:42

الطائفة العلوية ضحية أيضا وليست الجلاد
على عكس ما كان متصورا، مر سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد على الطائفة العلوية بسلام ودون انتقام. وعمل النظام السابق على تأجيج المظالم بين الطوائف كجزء من أجندة أوسع للحفاظ على الحكم.
العرب/دمشق - في مجتمعات بعينها، قد تبدو مُشكلا أن تحيا مجموعة من البشر مختلفي المشارب في مكان واحد، بينما يعد الاختلاف في مجتمعات أخرى تعددا وتنوعا وزخما.
وفي منطقتنا العربية شديدة التنوع في الأعراق والأديان والعقائد كثيرا ما أدى هذا إلى حروب دامية. حيث تقودنا محاولة الإجابة على سؤال لماذا، غالبا إلى طريق واحد، هو السياسة.
وجاء زلزال سقوط نظام الأسد في سوريا، أبا وابنا، ليخرج الملف المسكوت عنه من تحت الأرض، الذي جرى الحديث عنه بين جدران البيوت المغلقة، بهمس، حذرا وخوفا وترقبا لما يمكن أن يسفر عنه فتح الأوراق من حرائق.
وشاع طويلا أن الأوضاع التي أرساها النظام السوري لعقود في هذه المسألة، من زاوية أسلوب التعامل مع الطوائف المختلفة، قد نجحت في إقامة استقرار ظاهر، مهما انطوت على ظلم طائفة أو إعلاء شأن أخرى، وأنه منع فتح الجراح مهما أغلقت على تقيحات ملتهبة.
وفي ضوء هذا فإن غياب النظام أو ضعفه يمثل تهديدا شديدا للطائفة العلوية التي ينتمي إليها بيت الأسد. لكن النظام سقط، فما الذي جرى؟
ولا نطرح السؤال هنا على سبيل الاستنكار المسبق للطرح الأسدي الممتد منذ 54 عاما، أو بحثا عن إجابات معلبة تستند إلى أفكار نظرية مثالية قد لا يكون لها انعكاس على الأرض، فبعد سقوط النظام كان سؤال الوقت بالفعل هو: هل يمكن أن تجري عمليات انتقام وحشية من أبناء الطائفة العلوية على أيدي السوريين من الطائفة السنية باعتبار أن هذه الأخيرة واجهت لعقود ظلما وتغييبا عن المواقع البارزة في أركان الدولة؟
خوف وترقب
في سبيل إدراك الحقيقة، سعيتُ خلال الأيام الأولى بعد سقوط النظام إلى التواصل مع أطراف عديدة من كُتاب ومثقفين في مناطق اللاذقية وطرطوس ذات الأغلبية العلوية، والسَلَمية وفيها يغلب أبناء الطائفة الإسماعيلية، لمعرفة طبيعة الأوضاع على الأرض، وما إذا كانت هذه المناطق بالتحديد قد شهدت عمليات لاعتداءات طائفية بأي شكل، بالفعل أو القول، لاسيما أنه قد تم تداول أنباء في هذا الشأن دون ظهور وقائع تؤكدها أو مقاطع فيديو توثقها.
والخوف والترقب كانا عنوان المشهد بالطبع في هذه المناطق، كما تحدثت المصادر، مع وصول فصائل سنية ذات مرجعية جهادية وتكفيرية إلى الحكم، لكن وقائع الأيام الأولى بعد سقوط النظام أوضحت أنه لا نية للانتقام، وجرت اجتماعات للتطمين بين المنتمين إلى تركيبة الحكم الجديد وزعماء العشائر في هذه المناطق، ولم يتم تداول أنباء عن حالات اعتداءات طائفية على العلويين في اللاذقية وطرطوس أو الإسماعيليين في السلمية.
وأصدرت “القيادة العامة السورية”، كما تسمّي نفسها، عدة قرارات في هذا الشأن، أكدت فيها أن أيّ تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين سيُعاقب عليها بالحبس لمدة سنة. وقالت إنه “يمنع منعا باتا التدخل في لباس النساء أو فرض أيّ طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب الاحتشام،” مع التأكيد على أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر.
وأعلنت أنه لا يحق لأيّ شخص المطالبة بدماء الشهداء، فالشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن، وليس لتصفية الحسابات أو المطالبة بالثأر. ومنعت استخدام عبارات مثل “دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر.”
ولا يعني ما سبق أن الدنيا صارت جنة، إذ تزامن مع إعلان هروب الرئيس السابق بشار الأسد قيام الأفراد من قوات الجيش والأمن في اللاذقية بترك مواقعهم صباح الأحد الثامن من ديسمبر الجاري والعودة إلى بيوتهم، ما أحدث حالة من الفوضى العارمة، على حد قول المصادر من أبناء المدينة.
وكان طبيعيا أن يلتزم أبناء الطائفة العلوية من المواطنين منازلهم، في إطار حالة الترقب تخوفا من الخطاب الدائم للنظام البائد الذي روج سرا لمقولة “إن السُّنة سيذبحون العلويين في حالة غياب النظام، فنحن من نحميكم.”
وما جرى على الأرض بالفعل هو أن شبابا من الهامشيين “صيَّاع وبلطجية” من أبناء الطائفة السنية، ومثلهم موجود في كل الطوائف – كما تقول المصادر- استغلوا غياب رجال الأمن واستولوا على أسلحتهم وبدأوا بإطلاق نار كثيف في الهواء دون التعرض لأحد من أبناء الطائفة العلوية، كما جرت عمليات حرق ونهب لمبان مؤسسات تابعة للدولة في اللاذقية، ومنها مبنى إدارة الهجرة والجوازات.
وبعد يومين على سقوط النظام، تمت دعوة الموظفين إلى العودة إلى أعمالهم في المدارس والمصالح الحكومية يوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر، ولم يستجب البعض في ظل استمرار حالة القلق ووجود رجال ملتحين يحملون السلاح في الشوارع، لكن البعض تجرأ، ومنهم موظفات سيدات خرجن إلى أعمالهن، ولم يتعرض لهن أحد في ما يتعلق بالملبس أو المظهر.
والشيء الأهم، بالنسبة إلى من تحدثت إليهم، أنه ليس هناك ذبح أو دم. وفي طرطوس لم يتم تداول أنباء عن عمليات انتقام طائفي، لكن كانت هناك عمليات سرقات لممتلكات خاصة، في ظل عدم وجود قوى تضبط الأمن.
والهاجس المشترك عند الجميع هو الأوضاع الاقتصادية والخدمات، فالخبز غير متوفر، وحال الكهرباء والإنترنت سيئة للغاية، والمياه لا تصل إلى قرى طرطوس الساحلية لأيام إلا في ما ندر، أما اللاذقية فالكهرباء مقطوعة فيها طوال اليوم ما عدا نصف ساعة فقط.
والغياب شبه الكامل للخدمات والسلع الرئيسية وارتفاع الأسعار، أمور كانت وما زالت باقية في مناطق الساحل السوري مثل كل ربوع البلاد. وجاء سقوط النظام ليتيح للأصوات العلوية بأن تنطق أخيرا بالشكوى، بعد أن كان محرّما عليها أكثر من غيرها أن تتفوه بكلمة، فالنقد أو المعارضة أو السخرية السياسية من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قد تذهب بصاحبها إلى غياهب السجون، ليواجه أضعاف ما يواجهه أبناء الطائفة السنية باعتبار أنه لا بد أن يكون مؤيدا للنظام.
وقالت المصادر من المواطنين المنتمين إلى الطائفة العلوية إن الكل سعيد بسقوط نظام بشار الأسد، خصوصا بعد أن تبين عدم وجود عمليات انتقامية كما خوّفوهم دوما، فما أشيع عن إعلاء شأن العلويين في سوريا إنما كان يتعلق بالمنتفعين فقط من النظام ممن ارتبطوا به.
وأما الفقر والتهميش وسوء الحالة المعيشية فقد طالت الكل من مختلف الطوائف، فالشعب السوري الآن صار “مرهقا” بشدة ويتمنى أن يأتي الأفضل، يتمسك برغم كل شيء بالأمل.
ووصف الكاتب المصري محمود السعدني دمشق في شتاء عام 1957، من واقع إقامته فيها وقتها، بأنها كانت واحة الديمقراطية والحرية وحلبة الآراء المتصارعة في العالم العربي، بتياراتها السياسية المتعددة، وصحفها المتنوعة التي تقدر أعدادها “بعدد شعر الرأس”، كما يقول في كتابه “الطريق إلى زمش”.
والمشكلة في سوريا أن الجيش أيضا كان يضم داخله وقتها تيارات سياسية مختلفة؛ تيار حزب البعث بقيادة مصطفى حمدون، والناصريين بقيادة عبدالحميد السراج، والشيوعيين بقيادة عفيف البرزي رئيس الأركان.
وكان طبيعيا أن يقود هذا إلى وقوع عدد من الانقلابات العسكرية، انتهت بوصول الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى السلطة عام 1971، فأدرك ربما أن تسييس الجيش والاعتماد على الموالين سياسيًّا فيه لا يحمي الكرسي بل ربما يهزه، فاتجه إلى الأخطر، وهو التطييف، وعمد إلى إعلاء شأن أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها، وتشير أقصى التقديرات إلى أنها تمثل 15 في المئة من تعداد السوريين، فتم تصعيدهم في الجيش والأجهزة الأمنية مع وضع حدود لترقيات الضباط من الطائفة السنية، ما يفسر انشقاق الكثيرين من هؤلاء بعد اندلاع أحداث عام 2011.
ولعب الأسد الأب على وتر المعاناة التي واجهها العلويون على مر تاريخهم من اضطهاد سياسي وتكفير ديني، وكانت سببا في تأييدهم انقلاب عام 1963 الذي أوصل حزب البعث إلى السلطة، إذ جذبتهم أفكار الحزب حول العلمانية والاشتراكية، وليس الاعتبارات طائفية، لكن الأسد رأى أن الاحتماء بهم كطائفة تمثل الأقلية يدعم سلطته، عبر سياسة العصا والجزرة، فألقى إلى فئة منهم بجزرة التصعيد في المناصب، ولوَّح في الوقت نفسه للكل بعصا التخويف من السُّنة.
لعبة الدكتاتورية
هي ذات اللعبة الدائمة للأنظمة الدكتاتورية، كي تبقى رابضة في مقاعد السلطة، عبر بث الفتنة، والإيحاء لطائفة بأن النظام هو الحامي لها، الداعم لنفوذها، ما يراكم الشعور في المقابل لدى الطوائف الأخرى بأن من ظلمهم وهمَّش وجودهم الطائفة كلها وليس الحاكم الدكتاتور، المتلاعب بكل الطوائف، الذي يعلم أن إقامة حكم ديمقراطي لا يُفرّق بين المواطنين على أساس الأديان والأعراق والطوائف لن يُبقيه يومًا واحدًا في السلطة.
وتشير المعلومات والشهادات التي استمعت إليها “العرب” إلى أن النظام عمد بعد اشتعال الأحداث في حمص عام 2014 إلى إذكاء روح الفتنة بشكل دموي، عندما كان يؤتى بأبناء العلويين لذويهم جثثا مقطعة، ويقال لهم إن أبناء السُّنة هم من فعلوا هذا بهم، فانظروا ماذا أنتم فاعلون.
واليوم، تقول لنا المصادر “لم يكن لدينا طائفية من قبل، كنا جميعا معا، وسوف نظل، سنحاول العودة، سنحاول إعادة تعمير البلد، لدينا أمل،” لكن المخاوف لا تزال قائمة، كبيرة وكثيرة، عززها العدوان الإسرائيلي المباغت على سوريا برا وبحرا وجوا.
وشعر السوريون من مختلف الطوائف بالإحباط، لعدم صدور أي رد فعل مباشر من أحمد الشرع (أبومحمد الجولاني) الذي يتصدر المشهد، ما يماثل مواقف بشار الأسد من قبل، وعبروا أيضا عن القلق بشأن المستقبل، والخوف من إقامة حكم جديد على أساس ديني متزمت، فما يريدونه هو حكم رشيد يجلب الخير والازدهار للبلد بكل أطيافه، معتبرين أن مثقفي سوريا لا بد أن يقوموا بواجبهم لمنع تحويلها إلى أفغانستان أخرى.
ويطالبون اليوم بالحذر من الأعداء الطامعين الذين أسفروا عن وجوههم منذ اليوم الأول، إذ أن مشهد العلم الإسرائيلي أعلى قمة جبل الشيخ الذي احتلته قوت الاحتلال مؤخرا قد “أبكاهم”، كما قالوا، وأشعرهم بأن كل تضحيات وشهداء حرب تشرين قد ذهبت دون جدوى. لكن هذا كله لم يعن لهم، علويين وسُنَّة، لحظة واحدة من الندم على سقوط بشار الأسد، الذي كان هو من فتح الباب بسياسته لوقوع كل ما جرى.
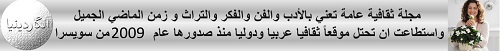
من القلب للقلب
أطفال الگاردينيا
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
908 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- العالم بعيون كوردية ( الجزء الثاني) سياحة في قلب النمسا من السليمانية
- برنامج سيرة من بلادي - عبدالكريم قاسم وأحداث ما بين ١٩٥٨ - ١٩٦٣
- السيدة دالاوي: مرآة الوعي وشروخ الذات
- انهيار الريال الإيراني قنبلة موقوتة تهدد بانفجار الاجتماعي
- جرس الميلاد يملأ الصمت .. وجود مسيحي يتآكل في العراق
- أبرز حوادث الطيران التي لقيت فيها شخصيات معروفة مصرعها
- الجمع بين الفياغرا الكحوليات خطر.. لماذا؟
- من الأهل إلى الزملاء: إليك أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٥
تابعونا على الفيس بوك

















































































