نحت صخري لولوبي في دربند باسره، السليمانية
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 05 أيار 2025 21:03
- كتب بواسطة: د.أسامة شكر محمد أمين
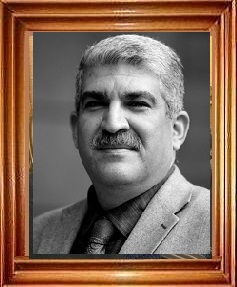
د. أسامة شكر محمد أمين
نحت صخري لولوبي في دربند باسره، السليمانية
يحتضن دربند (ممر) باسره، الواقع ضمن التكوينات الجيولوجية للطيات المحدبة في الجزء العلوي من سلسلة جبال قره داغ، نحتا صخريًا بارزا، ربما يكون لولوبيًا. يرتفع هذا المضيق الطبيعي الضيق حوالي ٦٠٥ أمتار فوق سطح البحر، ويشق طريقه من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، حاملاً معه مجرى مائيًا حيويًا. يقع الممر في الروافد الغربية لمحافظة السليمانية في العراق، على مسافة تقارب ٢٧ كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من دربند (ممر) بازيان الشهير.

دربند باسره. يقطع المضيق الطيات المحدبة للجزء العلوي من سلسلة جبال قره داغ. يؤدي الطريق المعبّد إلى قرية دێلێژه. التُقطت الصورة من الجزء الغربي للمخرج. يقع نحت صخري بارز عند رأس السهم الأحمر. يُعتقد أن هذا النحت الصخري لولوبي، ويعود تاريخه إلى أواخر الألفية الثالثة وأوائل الألفية الثانية قبل الميلاد. السليمانية، كردستان، العراق. الصورة © د. أسامة شكر محمد أمين.
الاسم والدلالات:
يثور جدل حول أصل تسمية "باسره" (بالكردية: دەربەندى باسەڕە). ففي حين تُترجم حرفيًا من الكردية الحديثة لتشير إلى "الريح الباردة" (باسارا)، اقترح الراحل توفيق وهبي (١٨٩١ – ١٩٨٤) أن الكلمة قد تكون ذات جذور هندية إيرانية قديمة ("فاسارا" في السنسكريتية تعني "مزدهر" أو "مشرق"، و"فاهارا" في الفارسية القديمة تعني "الربيع"). تجدر الإشارة إلى وجود قرية صغيرة تحمل اسم "باسارا" بالقرب من رانية (شمال غرب السليمانية)، بالإضافة إلى قبيلة محلية تحمل ذات الاسم. يُلاحظ تنوع في كتابة اسم "دربند باسره" باللغة الإنجليزية.
أهمية الموقع تاريخيًا وجغرافيًا:
يختلف دربند باسره مع دربند بازيان (اذ يتميز الاخير بصيف قائظ وشح في الموارد المائية)، حيث يتمتع الأول ببرودة نسبية وتدفق مستمر للرياح والمياه، ويحول موقعه الجغرافي الضيق وتضاريسه المرتفعة المحيطة دون وصول أشعة الشمس المباشرة إليه في فترة ما بعد الظهيرة. وعلى النقيض، يُعد دربند بازيان البوابة الرئيسية المؤدية إلى الجزء الغربي من مدينة السليمانية الحديثة، وقد لعب دورًا محوريًا في تاريخ المنطقة العسكري لآلاف السنين، إذ كان معبرًا إلزاميًا لأي جيش يسعى للوصول إلى المدن الغربية لسلسلة جبال زاغروس ومن ثم التوغل في الأراضي الإيرانية الغربية. تشير النصوص المسمارية إلى أن الملك الآشوري آشور ناصربال الثاني استخدم هذا الممر عام ٨٨١ قبل الميلاد لقمع ثورة في زاموا (المنطقة تقريبًا تشير الى محافظة السليمانية الحديثة)، اذ سيّر الملك جيشه الإمبراطوري المدرب والمجهز جيدًا الى المنطقة. حصّن زعماء ثورة زاموا دربند بازيان الضيق، من خلال بناء جدار كبير وسميك، في محاولة يائسة لصد الموجة الآشورية الساحقة، ولكن فشلوا، وغزا الآشوريون المنطقة وقتلوا ما يقرب من ١٤٠٠ جندي كانوا يدافعون عن أسوار دربند بازيان.
خلال الحرب العثمانية - الفارسية عام ١٧٣٣، دارت معركة في دربند بازيان بين الجيش العثماني وجيش نادر شاه (مؤسس الأسرة الأفشارية التي حكمت التي حكمت إيران بعد انهيار الدولة الصفوية). لكن الفرس، بدلًا من سلوك الطرق المعتادة، يُرجح أنهم سلكوا طريق دربند باسره غير المعروف للعثمانيين وغير المحصن، مما مكنهم من الوصول إلى المنطقة الواقعة خلف الجيش التركي ومباغتته، ليحقق نادر شاه نصرًا حاسمًا قُتل فيه القائد العثماني الشهير طوبال عثمان باشا. شهدت المنطقة العديد من الصراعات اللاحقة، كان آخرها في أوائل القرن العشرين بين الشيخ محمود البرزنجي (١٨٧٨ – ١٩٥٦) الذي نصّب نفسه ملكا على كردستان (بعد انهيار الدولة العثمانية) والقوات البريطانية الغازية.
اكتشاف النحت البارز:
في تسعينيات القرن الماضي، ونتيجة لمشروع بناء سد لم يكتمل، تفقد السيد عادل مجيد، المدير الأسبق لدائرة آثار وتراث السليمانية، الوادي ولاحظ وجود نحت بارز محفور على واجهة طية محدبة. لم يتسبب هذا الاكتشاف في إيقاف مشروع السد، ولم تخضع المنطقة المحيطة بالمنحوتة لأي تنقيب رسمي. في أوائل عام ٢٠٠٢، قررت مديرية آثار السليمانية صنع نسخة طبق الأصل من المنحوتة تحسبًا لغمره وتلفه نهائيًا مع تشغيل السد. تُحفظ هذه النسخة حاليًا في مخزن متحف السليمانية. لم يكتمل بناء السد الى اليوم، لأسباب متعددة.

يضم هذا النخت أو النقش الصخري البارز تكوينًا فنيًا ثنائي المشهد. يتميز المشهد الرئيسي بإطاره المربع المنحوت بتقنية الحفر الغائر، بينما يجاوره على اليمين مشهد ثانوي نُحت خارج حدود هذا المربع (تم تحديد محيط الشكل القائم فيه باستخدام الطباشير الأبيض لأغراض التوثيق). يُلاحظ وجود آثار للجبس الأبيض الحديث، وهو من مخلفات عملية صنع نسخة طبق الأصل قام بها فريق من مديرية آثار السليمانية، كما هو موثق في هذه الصورة الملتقطة بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٠٢. يُرجح انتماء المشهد الرئيسي إلى الفن والفترة اللولوبية. زيارتي للموقع كشفت عن وجود دهانات بيضاء وصفراء حديثة لم تكن موجودة في هذا التاريخ. يُقدر تاريخ هذا الأثر إلى الفترة الممتدة من أواخر الألفية الثالثة إلى أوائل الألفية الثانية قبل الميلاد. شكرا لمتحف السليمانية لتزويدي بهذه الصورة من أرشيف المتحف.
غموض واكتشافات حديثة:
وفقًا للسيد هاشم حمه عبد الله، المدير الحالي لدائرة الآثار والتراث في السليمانية، فإن الوعي بهذا النقش البارز محدود للغاية، ويقتصر بشكل أساسي على المشاركين في صنع النسخة وبعض علماء الآثار والمؤرخين المحليين. اللافت للنظر أنه على الرغم من وجود العديد من الدراسات الجيولوجية التي تتناول مضيق باسره، إلا أن أياً منها لم يشر إلى وجود هذا النقش. قد قام شخص ما مؤخرًا بتشويه سطح الصخرة بكتابة اسمه بالطلاء الأبيض (ئارام زوراب سه رده شت)، حيث تغطي بعض حروف الاسم جزءًا من النقش، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك متعمدًا أم عرضيًا.
أشار الدكتور كوزاد محمد أحمد (الأستاذ المساعد ورئيس قسم الآثار الاسبق في كلية العلوم الإنسانية بجامعة السليمانية) إلى أنه سمع عن هذا النقش في عام ١٩٨٨ من صديق له من بلدة جمجمال. قبل انتفاضة عام ١٩٩١، كانت المنطقة محظورة بسبب حملة الأنفال العسكرية (فبراير – سبتمبر ١٩٨٨) وتبعاتها. في عام ١٩٩٣، زار الدكتور كوزاد وفريق تلفزيوني الموقع وأنتجوا فيلمًا وثائقيًا قصيرًا عنه، لكن أرشيف القناة فُقد لاحقًا في منتصف التسعينيات خلال الصراع الكردي الداخلي (ما تسمى بالحرب الاهلية في كردستان العراق، ١٩٩٤ – ١٩٩٧).
وصف النحت الصخري:
شاهدت النسخة الجبسية في مخزن المتحف، ولكن تفاصيلها غير واضحة وغامضة، ولذلك في ٨ مارس ٢٠١٨، توجهت برفقة هاشم، إلى دربند باسره. عبرنا طريق السليمانية - كركوك وطاسلوجه، ثم عبرنا قرية ألّايي، ثم اتجهنا جنوبًا مارين بعدة قرى، منها محمودية وخيواته. عند ملتقى دربند سوتاو، وسولا، ودليزه، انعطفنا غربًا وجنوبًا، ووصلنا أخيرًا إلى مخرج دربند باسره. تبين وجود نحتين بارزين على الواجهة الصخرية الجنوبية الغربية لطية قره داغ المحدبة، يرتفعان حوالي ٢,٥ متر فوق مستوى الطريق.

يمكن مشاهدة النحت محفورا على منتصف الواجهة الصخرية المائلة مع وجود طلاء بدهان ابيض واصفر حديث على المشاهد المنحوتة. صورة حصرية. الصورة © د. أسامة شكر محمد أمين.
النحت الرئيسي محفور داخل منطقة مربعة الشكل تقريبا (٦٠ سم عرضًا و٥٢ سم ارتفاعًا) بتقنية النحت الغائر وحواف محددة بوضوح. داخل المربع وعلى اليمين، يمكن تمييز شخص واقف (ارتفاعه ٤٧ سم وعمقه ٣ سم)، يرتدي خوذة مدببة ذات قرون (إشارة الى الالوهية). من غير الواضح ما إذا كان هذا الإله ذكرًا أم أنثى ولا توجد ملامح وجه واضحة. تشير الأقدام إلى اليسار، وبالتالي ينظر الإله إلى يسار المشاهد. يرتدي الإله ثوبًا طويلًا، من الرقبة إلى الكاحلين وليس من الواضح ما إذا كان النصف السفلي من الثوب مكشكشًا أم متدرجًا أم ناعمًا. ذراعا الإله ممدودتان للأمام ومائلتان قليلًا إلى الأسفل، ويبدو أنهما تحتضنان شخصية بشرية أمامها، عند أسفل الصدر.

المشهد الرئيسي يظهر في النصف الأيسر للصورة على شكل نحت غائر داخل إطار مربع مع وجود ثقب بيضوي في المنتصف تقريبا. تم سكب الماء على المشاهد المحفورة لإبرازها، لأغراض التصوير. لاحظ الدهانات الحديثة على المشاهد. صورة حصرية. الصورة © د. أسامة شكر محمد أمين.
نُحتت شخصية بشرية أمام الإله، ولكن من الواضح ان هذه الشخصية لا تلمس الأرض. يُفترض أنها لرجل يرتدي غطاء رأس ملفوفًا الى الاعلى (يشبه أغطية الرأس الموجودة في المنحوتات التي تعود الى فترة أور الثالثة في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد). مرة أخرى، لا يمكن تمييز ملامح الوجه، لكنه ينظر إلى اليمين، نحو الإله. ذراعاه ممدودتان أيضًا إلى الأمام ويبدو أنهما تحتضنان الإله عند كتفيه أو أسفل رقبته. منطقة الحوض للشخصية البشرية قريبة جدًا من الإله، تكاد تلامس الأخير. من جهة أخرى، تحتضن أرجل الشخصية البشرية الممدودة الى الامام خصر الإله. يبلغ ارتفاعه، من طرف غطاء الرأس إلى أدنى نقطة في الحوض، حوالي ١٧ سم. ربما تكون الفتحة البيضاوية داخل النقش البارز في بطن الإله قد تكونت بشكل طبيعي نتيجة للعوامل الجوية أو ربما تكون من صنع الإنسان لتثبيت شيء ما. خلف الإله، وفي الزاوية السفلية اليمنى من المربع، يوجد أثر لما يبدو أنه شكل بشري صغير راكع بذراعين مرفوعتين ويدين متشابكتين. لا يمكن التعرف على أي دليل متبقٍ على أي حبل يربط الإله بهذا الشكل الراكع. يمكن رؤية ثقب آخر في الصخرة عند كاحل الشكل الراكع. يواجه ظهر الإله دربند باسره؛ لذلك، ينظر الإله بعيدًا عن مخرج الوادي. لا توجد آثار لأي طلاء أصلي؛ الطلاءان الأبيض والأصفر الذي يمكننا رؤيته حديثان.
تم تنعيم المنطقة الواقعة أعلى يمين النحت المذكور بقليل، ونُحت نقشٌ آخر غائر (خارج المربع). ومع ذلك، لا توجد حدود واضحة حوله، ولا يُمكن التعرّف إلا على النصف السفلي لشخصية واقفة تنظر إلى الوادي وترتدي ثوبًا طويلًا يصل إلى الكاحل. تفاصيل هذا النقش الثاني وهدفه غامضان. يُثار جدل حول ما إذا كان قد أُضيف لاحقًا، إلى جانب النقش الرئيسي، أم نُحت أولًا؛ ومن غير المرجح أن يكون كلاهما قد نُحت في وقت واحد.
تفسيرات محتملة:
يبقى الغرض من هذه المشاهد غير واضح لعدم العثور على أي نصوص منقوشة مصاحبة. تُعتبر الأيقونات في المشاهد المنحوتة غير عادية إلى حد ما. يختلف الباحثون حول ما إذا كان الإله يُمارس علاقة جنسية مع الإنسان أم لا. قد يعكس هذا الجماع المُصوّر صراحةً بين مخلوق إلهي وإنسان نوعًا من القداسة أو يمنح الحصانة (صاغ السيدان معتصم رشيد وعادل مجيد هذه الملاحظة).
تشير ملامح خوذة الإله وغطاء رأس الشخصية البشرية والشخصية الراكعة إلى التشابه مع النقش الصخري اللولوبي لأنوبانيني (ملك لولوبي، حكم بين ٢٠٠٠ – ١٩٠٠ قبل الميلاد) في سربل ذهاب (في كرمنشاه، غرب إيران، القريبة من الحدود العراقية لمحافظة ديالى المجاورة)، مما يرجح تأريخ نقش دربند باسره إلى أواخر الألفية الثالثة وأوائل الألفية الثانية قبل الميلاد. بينما يرى الدكتور كوزاد، بناءً على قرب الموقع من أراضي الغوتيين، احتمالًا بأن يكون النقش غوتيًا ويعود إلى أواخر الألفية الثالثة قبل الميلاد. كان اللولوبيين مجموعة من قبائل العصر البرونزي التي كانت موجودة واختفت تدريجيا خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد، من منطقة تعرف باسم لولوبوم، وهي الآن سهل شهرزور في جبال زاغروس في محافظة السليمانية، العراق. أما الغوتيون فكانوا شعبًا من الشرق الأدنى القديم، ظهروا واختفوا خلال العصر البرونزي. عُرف موطنهم باسم غوتيوم (بين شمال غرب إيران وبين جبال زاغروس ونهر دجلة). إنتهى الصراع بين سكان غوتيوم والإمبراطورية الأكدية بانهيار الإمبراطورية في أواخر الألفية الثالثة قبل الميلاد. ثم اجتاح الغوتيون جنوب بلاد ما بين النهرين، وشكلوا سلالة غوتية قصيرة العمر في سومر.
تؤكد الأهمية التاريخية للممر، على الرغم من كونه غير معروف نسبيًا، على إمكانية تصوير النحت لمبدأ "ألمنتصرين والمهزومين". يثير موقع النحت على جانب الطريق، على عكس المنحوتات الصخرية الأخرى في كردستان العراق (والتي نُحتت في أعالي الجبال)، تساؤلات حول ما إذا كان قديمًا مُلونًا. الجدير بالذكر هو بقاء النحت سليمًا (نجَى من التخريب وتدمير الأيقونات) رغم سهولة الوصول إليه.
*طبيب استشاري في طب الاعصاب وزميل كليات الأطباء الملكية في ادنبرة وكلاسكو ولندن ودبلن
ملاحظة: ترجمتي (بتصرف) لمقالي المنشور بالإنكليزية في موسوعة التاريخ القديم. جميع الصور حصرية وحقوق الملكية الفكرية لها محفوظة للدكتور أسامة شكر محمد أمين.

فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
897 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- أفكار شاردة من هنا هناك/١١٨
- التمديد المتوقع والانسداد الدستوري في العراق
- فيديو / فشل عملية سطو هوليودية نفذتها عصابة محترفة بإيطاليا يشعل المنصات
- إرشادات مهمة لحماية الأطفال في منصات الذكاء الاصطناعي
- ما هي أقوى جوازات سفر في العالم؟ ... وما هي أضعفها؟ ... وما هو ترتيب الدول العربية؟
- سرد ما قل ودل.. الكتابة المستقبلية للرواية العالمية
- جولة بغدادية /الگاردينيا كانت هناك
- كيف تقوم بتشغيل سيارتك عن بُعد عبر هاتف آيفون؟
تابعونا على الفيس بوك




















































































