عراق يسكنه الحزن
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 22 أيار 2025 09:42
- كتب بواسطة: د.سعد العبيدي
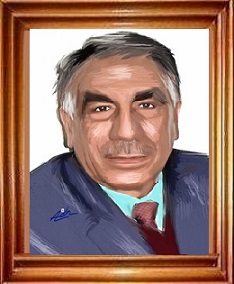
د.سعد العبيدي
عراق يسكنه الحزن
يولد الإنسان وفي داخله قابلية على الحزن، كأن الحزن طيف ضروري لتذوق المعنى. غير أن العيش في أرض مثل العراق تحوّل هذا الشعور إلى شيء آخر؛ يغدو وكأنه بيئة نفسية، ينشأ فيها الفرد محاطًا بهالة من الكآبة، لا تأتي كرد فعل لمثيرات صدمية مؤقتة، وإنما كظلّ دائم يلازمه، حتى تُختزل الهوية ذاتها في مزاج سوداوي لا يفارق الذات إلا ما ندر، شعور مزمن بالضجر، حتى في غياب أسبابه الظاهرة، كأن العقل يرتدي نظارات داكنة يرى بها العالم مشوّهًا، باهتًا، مستعصيًا على الفرح. حالة تضخمت في عراق الزمن الحالي تجاوزت فيها البعد الفردي المعروف نفسيًا، حيث تصيب الكآبة بعض الأشخاص بنسب متوقعة ، لتصبح هنا ظاهرة شبه جماعية تتغلغل في وجدان المجتمع:
عقود من الألم المنظّم، حيث كان الهروب من الجندية يُفضي إلى الإعدام، وانتقاد القائد كذلك إعدام، والتقصير في خدمة الاقطاعي تؤدي الى الجلد، وترك البلاد خيانة، وانتقاد الحزب جريمة تجرّ صاحبها إلى الجحيم. فتعلّم الناس، على إثر ذلك وسواه، أن الحزن هو رد الفعل الطبيعي على كل هفوة، وكل صمت مريب، حتى صار جزءًا من كيانهم. وبالتكرار وتقادم الزمن، كبر الحزن وتحوّل من مشاعر فردية إلى هوية جمعية، ومن حالة عابرة إلى مزاج، ومن انفعال آني إلى طقوس سوداوية مستمرة.
في حالتها، وعندما يختنق الكلام، تتكلّم المواويل حزنًا (أنا اللي ببـچـاهم كل يوم ينشـدونـي وإذا مرّوا علـى داري يـنوحـونـي). وأنين الغياب والمظلومية يرنّ في الطور الريفي غناءً، بصوت مبحوح يلامس الجرح (آه يويلي...).
أغانٍ كثير منها لم تكن احتفالًا بالحياة، وإنما بكاءً ناعمًا عليها. وعند الشروع بالغزل، ينبثق الوجع: "آه اشگد أحبك". وكأن الحب لا يُعاش إلا من خلف غلالة من الحنين والأسى.
وكذلك الحال بالنسبة الى القصائد التي، لا تنشد كثير منها فرحًا؛ إذ يخرج بعضها من أعماق الأسى حتى عند الجواهري المعروف بحبه الدنيا ومباهجها: "فيا ضيّعة العمر إن نفعا – وحزنًا يجرّ إلى الجزعا". إنها مناحات موزونة أكثر منها أدبًا في مدح الحياة.
وفوق هذا كله، جاءت الطقوس الحسينية، لا لتستذكر الفاجعة التاريخية فحسب، بل لتحمل معها هموم الحاضر المكبوتة، حيث لم يعد اللطم فيها وقراءة المقتل مجرّد مشاركة وجدانية، وإنما وسيلة لتفريغ خُذلان زمني مستمر، وإمعانًا في آلية التفريغ زادوها طقوسا لجلد الذات الجمعي بالتطبير والتطيين والتجريح، كأن الجسد نفسه متهم، وغالب أنحاء العراق في محكمة لا تصدر أحكام براءة.
حتى في مواسم الفرح الديني عند أهل الوسط والجنوب، لا يُستدعى الفرح كما يُفترض، وإنما يُستحضر الحزن بثياب جديدة، وتُتلى المراثي في لحظات يُفترض فيها أن تُعزف نغمات البهجة. كأن خزين الذاكرة لا يعرف سوى النحيب، وكأن محاولة تعديل هذا الإرث العاطفي باتت مستحيلة.
لقد تمددت السوداوية في العراق حتى طالت أبسط مظاهر العيش. مراجعة دائرة حكومية، على سبيل المثال، تتحوّل إلى رحلة إذلال معلنة، يفقد فيها الإنسان كرامته مع كل ساعة انتظار بلا جدوى، ويزداد شعوره الحزين باللا جدوى حين يُدرك أن النجاة تتطلب مالًا يقدمه لتجنب المزيد من المهانة المحزنة.
وفي الشارع، حيث الفوضى هي القاعدة، يتحول المرور إلى مواجهة يومية: أعصاب مشدودة، وانفعالات حزينة، كأن الحياة اليومية معركة لا قانون لها. وفي كل لحظة، يشعر المرء أن شيئًا ما مكسور في داخله، لا يُصلّح.
وهكذا، ومع مرور الزمن، تراكم كل شيء: الأحداث الصغيرة، والمآسي الكبيرة، ليشكّل مشاعر عامة مشبعة بالحزن. صار العراقي في حالتها يحزن على كل شيء، وليس لسبب محدد: يحزن على ما فاته، وما لم يحدث، وما لم يولد أصلًا، محملًا ذاته المسؤولية عن ماضٍ لم يختره. إنها نوع من "السوداوية النشيطة"، حيث يواصل الناس العيش، والعمل، والحب، والموت، محمّلين بثقل لا يُرى، كأنهم يسيرون وعلى أكتافهم وطنٌ بأكمله ينزف حزنًا في صمت. وفي دواخلهم، سؤال قديم لم يُجب عنه يومًا: "هل كُتب علينا الحزن إلى الأبد؟"

فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1205 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- مسؤولون أميركيون: خياراتنا في إيران استهداف أفراد أو تغيير النظام
- مسلسل_عمر - الحلقة السابعة
- رمضان في العراق .. مائدة عامرة بطقوس متوارثة ونكهات لا تغيب
- طرائف "رمضانية" من التراث العربي
- كركوك في ذاكرة المؤسسات: إصدار تاريخي جديد للباحث نجات كوثر أوغلو
- الاعتزاز بالموروث الحضاري: وعي الذات وأصالة الانتماء في ذاكرة المدن.
- كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة الام اللغة الكوردية: بين مجد الهوية وخطر التهميش
- كيف يوقف صيام رمضان عجلة الشيخوخة؟
تابعونا على الفيس بوك




















































































