من العشيرة إلى الدولة: تأملات في قيدٍ لم يكسر بعد
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 16 تموز/يوليو 2025 20:08
- كتب بواسطة: ابراهيم فاضل الناصري
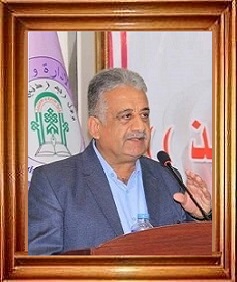
بقلم: إبراهيم فاضل الناصري
من العشيرة إلى الدولة:تأملات في قيدٍ لم يكسر بعد
في قلب كل مشروع نهضوي، ينهض سؤالٌ مقلق: ما الذي يحول بيننا وبين الدولة التي نحلم بها؟ لماذا تبدو مؤسساتنا الحديثة كواجهات زجاجية لمدينةٍ عصرية تُخفي وراءها قبائل من زمنٍ قديم؟ إننا لا نعيش فقط أزمة إدارة، بل أزمة وعيٍ لم يُحسم بعد بين منطق الدولة ومنطق العشيرة، بين عقل المواطنة وعاطفة الانتماء الضيق. ولسنا أمام مجرّد تعارض بين القديم والجديد، بل أمام صراعٍ عميق بين رؤيتين للوجود الاجتماعي:
واحدة تُؤمن بالفرد كفاعل حرّ في منظومة قانونية عادلة، وأخرى تراه تابعًا لسلالةٍ، محكومًا بنظام قرابي يعلو حتى على الدولة نفسها.
(القبلية المقنّعة: حين تلبس العشيرة عباءة الدولة):
في الأزمنة القديمة، كانت القبيلة نظامًا يحمي، يحكم، ويُقيم التوازن في غياب الدولة.
لكن في زمن الدولة الحديثة، حين تعود القبلية بثوب مدني، تتحول من ملاذٍ اجتماعي إلى قيدٍ سياسي. والقبلية اليوم لا تظهر في صحراءٍ معزولة، بل في قلب المدينة. لا تُرفع راياتها على الخيام، بل في الحملات الانتخابية، وفي الوظائف العامة، وفي تقاسم النفوذ بين "البيوتات" السياسية. إنها قبلية بأدوات عصرية، تُصوّت عبر الهواتف الذكية، وتُفاوض من على شاشات التلفاز، لكنها في الجوهر تُعيد إنتاج منطق التبعية وتُفرغ الدولة من مضمونها التعاقدي.
(القبيلة ليست العدو... بل اختطاف الدولة باسمها):
القبيلة ليست مشكلة في ذاتها. هي تشكيلٌ اجتماعي له مكانته، وقد حفظ خلال قرونٍ طويلة شيئًا من القيم والتضامن. لكن الخطر يتجلّى حين تتحول من مرجعية ثقافية إلى سلطةٍ موازية، تضع نفسها فوق القانون، وتُخضع الدولة لمنطق العصبة والانتماء.
في الفراغ الذي تتركه مؤسساتٌ ضعيفة وعدالة مفقودة، تعود القبيلة لتملأ هذا الغياب. لكنها لا تعود كرافعة للهوية، بل كبديل للحق، ومتنفس للخوف، وضمان للنجاة في نظامٍ لا يحمي الضعفاء إلا بانتمائهم.
(الدولة المدنية: تحرير الإنسان من طبقات الإرث):
الدولة المدنية لا تلغي التاريخ، لكنها تُعيد ترتيب الأسبقيات: الإنسان أولًا، ثم الوطن، ثم ذاكرة الجماعة. ليست الدولة المدنية خصمًا للدين أو للتقاليد او للعنصر، بل هي خصمٌ للتسلّط باسم أيٍ منهما. فيها لا يُلغى الانتماء، بل يُصهر في بوتقة المواطنة، ويُوزن العقل لا النَسب، وتُقدَّم الكفاءة على القرابة.
(المجتمع المدني لا يُمنح... بل يُنتَزع ببناء طويل النفس):
لا تولد المجتمعات المدنية من فراغ، ولا تَنمو بشعاراتٍ تُردَّد، بل تُبنى بنَفَسٍ طويل، يبدأ من الطفولة ومن المدرسة، من الإعلام واللغة، من محاربة الامتيازات الخفية، ومن كسر الموروثات التي تُسكت باسم "الخصوصية".
حين يتعلم الطفل أن قيمته لا تتوقف على اسم عائلته، بل على ما يُنتجه من فكرٍ وجهد،
وحين يرى الشاب أن الترقّي لا يحتاج لوسيطٍ عشائري بل لجدارة واضحة،
وحين يشعر المواطن البسيط أن مظلمته تُسمع لأنه إنسان، لا لأنه من آل فلان،
نكون قد وضعنا حجر الأساس لدولةٍ تنتمي للمستقبل لا للماضي.
(خاتمة: بين العيش في الدولة... والعيش حولها):
إن أخطر ما نواجهه اليوم ليس عودة القبيلة، بل فشل الدولة في أن تكون بيتًا للجميع.
حين لا يشعر المواطن بالعدالة، يبحث عن ظهر.
وحين لا يجد القانون، يلجأ إلى العصبة.
وهكذا، نبني دولةً من ورق، ونعيش داخلها كمجموعات متجاورة لا كمجتمعٍ متداخل.
التحدي اليوم ليس نظريًا، بل وجودي:
إما أن نواصل تدوير الماضي، وإما أن نكسر حلقة التكرار.
إما أن نبني دولة المواطنة، أو نرضى بالتقاسم بين العشائر.
في زمنٍ تُحلّق فيه الأمم على أجنحة العقل، لا يليق بنا أن نُقيّد أنفسنا بأثقال الدم والانتماء.
فلنُحرر الدولة من القبلية، ولنُحرر الإنسان من ظلاله الثقيلة.
فلا نهضة من دون حرية، ولا حرية من دون عدالة، ولا عدالة من دون قانونٍ يُساوي بين الناس لا بين الأنساب.

فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
913 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- طرائف رمضانية من التراث العربي
- كلمات على ضفاف الحدث العراق والارقام يكحل العين ...!!
- لماذا ستصعّد إيران الضربات العسكرية الأميركية وخطر الغرق في مستنقع نِيت سوانسون / اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خماس
- عودُ الثقاب في إقليمٍ مكدّس بالوقود هل نحن أمام حربٍ
- الدهرُ يومان ... يومٌ لك ويومٌ عليك
- كتاب معسكر بعقوبة / الجزء السابع و الأخير
- من ذكرياتي " مذكرا عبد العزيز القصاب " - الحلقة الثانية
- بغداد تكشف تجنيد آلاف العراقيين للقتال مع الجيش الروسي وتوقف شبكة متورطة
تابعونا على الفيس بوك




















































































