نحو إعادة فهم لعلاقة الدين بالدولة
- التفاصيل
- المجموعة: ثقافة وأدب
- تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 09 تشرين2/نوفمبر 2017 09:16
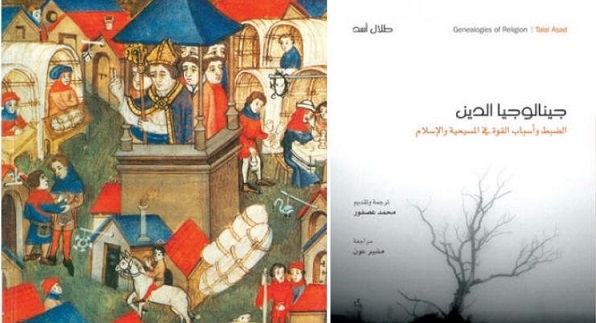
لوحة تعبر عن دور الكنيسة في القرون الوسطى
عالم الأنثروبولوجيا الأميركي طلال أسد يعيد طرح الأسئلة الصعبة
الشرق الأوسط/عبد الرحمن الحاج:هل يمكن فهم تاريخ العلاقة بين الدين والسياسة والقوة في العالم الإسلامي على ضوء الخبرة التاريخية الأوروبية؟ وهل إشكالية علاقة الدين بالدولة قابلة للتعميم على الشعوب غير الغربية؟ أي دور تؤديه الطقوس والرموز والشعائر الدينية في الضبط الاجتماعي؟ وما علاقة ذلك بتاريخ التحول الفكري الديني نحو العلمانية؟ ولماذا تجد الشعوب من غير البلاد الغربية نفسها مضطرة لقراءة تاريخ الغرب في ذلك في حين لا يشعر الغربيين بالحاجة إلى قراءة تاريخ الآخرين؟ هل يمكن أن نقرأ تاريخ الفكر الديني غير الغربي بمعزل عن التاريخ الغربي وخبرته؟ ولماذا ينظر إلى التاريخ الغربي على أنه تاريخ عالمي في حين ينظر إلى تاريخ الشعوب الأخرى على أنه تاريخ محلي؟ هل ذلك مرتبط بعلاقات القوة؟
تشكل هذه الأسئلة الكبرى أساساً لموضوعات هذا الكتاب البحثية لعالم الأنثروبولوجيا الأميركي الشهير في جامعة نيويورك طلال أسد، الخبير بالفكرين الإسلامي والمسيحي، فخلفية تكوينه ورحلاته العلمية تسمح له بقراءة فريدة لهذين الموضوعين من منظور أنثربولوجي؛ إذ تتناول فصول الكتاب موضوعات تاريخية تتباين في الزمان والمكان، وتشمل أموراً تتعلق بالمسيحيين الأوروبيين في القرون الوسطى وبعض العرب المسلمين، وما يجمعها هو الاعتقاد بأن التاريخ الغربي أدى دوراً بالغ الأهمية في تشكيل العالم الحديث، وأن الجيولوجيا الفكرية للتاريخ المسيحي والإسلامي لها دلالات عميقة على الطرق التي تمكّنَ أنماط من التراث غير الغربي بواسطتها من النمو والتغير.
ينظر أسد بشكل تقليدي إلى القوة الرأسمالية الطاغية على أنها هي التي تضع الحبكة الأساسية للقصة، وما تفعله الشعوب المحلية (شعوب الأطراف) هو أنها تأتي بتفسيراتها هي في الصيغ المحلية منها، وهو ما يعني أن الشعوب المحلية هي في أفضل الأحوال عوامل ثانوية ومتلقٍ سلبي، والتخلص من هذه النظرة التقليدية السائدة إلى حد بعيد، ورؤية التاريخ الخاص للشعوب ودينامياته الخاصة في النمو والتغير يكمن في دراسة تاريخ الشعوب المحلية بمشاركة علوم إنسانية متعددة.
يذهب طلال أسد إلى ضرورة فهم كل ذلك في إطار علاقات القوة؛ إذ يمكن أن يكون تغيير الناس أسهل عندما يتم إزاحة ذواتهم عن المركز (الحضاري والثقافي الخاص بهم) عندما يكونون مقتلعين جسمانياً وأخلاقياً، وعندما يكون تحريكهم (تغييرهم) سهلاً؛ فإن ذلك يسهل جعلهم زائدين عن اللزوم جسمانياً وأخلاقياً أيضاً، وبالتالي يكون ممكناً إحلال غيرهم محلها، وجعل الدوافع التي تدفعهم موافقة لأصحاب هذه القوة. إن المسألة لا يمكن اختزالها في «استعارة ثقافية» وحسب، بل يجب فهمها على أنها جزء من إطار أكبر له علاقة بالقوة، فحتى هذه الاستعارة تأخذ معناها ليس من مدلولها الذاتي فقط، إنما من علاقات القوة والإخضاع الواسعة القائمة خلفها.
عدم الرضا عن السرد التاريخي للبلاد غير الغربية التي يحتل فيها الأوروبيون مكاناً بارزاً أكثر من اللازم (بصفتهم فاعلين أو ممثلين لما هو معياري) تخفي فهماً لصنع التاريخ يتطفل على التواريخ الأخرى ويحجبها، فكل ظاهرة تاريخية يتحدد مسارها بالطريقة التي تشكلت فيها، وبعض عناصرها جوهرية لهويتها التاريخية وبعضها ليس بالضرورة كذلك. التحديث (التحول إلى النمط الغربي) مشروع يتضمن صنع التاريخ من دون شك، لكنه مشروع لا يتمتع فيه الفاعلون فيه بالاستقلال الذاتي الكامل، ولا بالوعي الكامل لأبعاده؛ فهو يسمح بفهم جديد للتاريخ وأزمنته ويعيد صياغتها على أساس أن ثمة هوية غربية جماعية تنظر إلى نفسها بالرجوع إلى تاريخية فريدة بالمقارنة مع الهويات الأخرى، وهي تاريخية تتحول من مكان إلى آخر – اليونان، روما، المسيحية اللاتينية، الأميركيتين - إلى أن تنتشر في أنحاء العالم.
إن الأفكار الكبرى التي يستخدمها الأنثربولوجيون ولدت من التقاء أوروبا بالشعوب غير الأوروبية (مثل وصف تلك المجتمعات بأنها «غير حديثة»: «محلية»: «تقليدية»)، فهي تعتمد إلى اليوم على موازنة هذه الصفات مع الحداثة الغربية التي تكتسب صفة معيارية، في حين أن الأساس السليم للمقارنة هو الإصرار على وحدة التجربة الإنسانية وعلى تنوعها في آن معاً.
يخلص المؤلف إلى أن علم الأنثروبولوجيا مشغول بالتعريفات المتعلقة بالغرب، بينما تعمل المشروعات الغربية على تغيير الشعوب، وإذا ما أراد علم الأنثروبولوجيا أن يفهم المجتمعات المحلية و«شعوب الأطراف» الذين «يدخلون» عصر الحداثة أو حتى «يقاومونه» فمن الأفضل أن يعمِّق فهمه للغرب أولاً على أنه ليس مجرد آيديولوجيا قديمة، وسيتضمن ذلك فهم تاريخيه الخاصة والقوى المتحركة التي شيدت بنيانه ومشروعاته ورغباته، حيث الدين هو جزء أساسي من عملية التشييد تلك، والمضي قدماً نحو علم أنثروبولوجيا تاريخي يجعل من الهيمنة الغربية الثقافية موضوعا له، أي الطرق التي تحدد فيها المفاهيم والممارسات الغربية في المجال الديني أشكال صنع التاريخ.
لكن كيف نفهم الدين أولاً لنقوم بذلك؟ ينطلق أسد من أن التوصل إلى تعريف شمولي للدين غير ممكن، ليس لأن مكوناته وعلاقاته متعينة تاريخياً فقط، بل لأن التعريف ذاته ناتج تاريخي لطرق معينة في الخطاب. إن فهم ما يعينه الدافع الديني والشعور الديني الوجداني، وكيف تتشكل عبر الرموز الدينية يقود إلى مفهوم «القوة» الدينية ومفهوم «الحقيقة» الدينية، والعلاقة بينهما وما يعرف بمفهوم «الضبط» بمعناه الذاتي والاجتماعي.
إن الرموز الدينية ليست هي وحدها ما يزرع المشاعر الدينية المسيحية الصادقة مثلاً، بل القوة التي تشملها القوانين (الحكومية أو الكنسية) والعقاب والثواب (نار جهنم، الموت، الخلاص، السمعة الطيبة، السلام...الخ)، وعوامل الضبط التي تفرضها المؤسسات الاجتماعية (العائلة، المدرسة، المدينة، الكنيسة)، وتلك التي تفرض على الأجسام البشرية (الصيام، الصلاة، الطاعة، التوبة)، أي القوة المتأتية من شبكة كاملة من الممارسات القائمة على دوافع خاصة بها، تتخذ شكلاً دينياً. وما حصل الآن ليس سوى أن أنماط القوة وتشكيلاتها تتغير من حقبة إلى أخرى، فما كان في العصور المسيحية الوسطى تغير جذرياً الآن، لكن المبدأ بقي هو ذاته.
إن شعوراً معيناً يمكننا أن نصفه بأنه شعور ديني إنما يكمن في كونه يحتل مكاناً خاصاً في تصور لنا عن الإطار الكوني، والسؤال هو كيف تحتل تلك الرموز والمعاني هذا الموقع الديني وتكتسب الصفة المرجعية للدين؟ من الذي يحدد تلك الصفة؟ إن هذا السؤال سيقود لا محالة إلى إعادة تعريف الفضاءات الدينية وتحديدها في تاريخ المجتمع الغربي، وما يعنيه ذلك من العودة إلى العلاقة السلطات المتعددة والمتحكمة بالفضاء العام وتغيرها. لقد أعيد رسم الخط الفاصل بين الديني والدنيوي مرات عدة قبل «حركة الإصلاح الديني»، لكن السلطة الكنسية الرسمية ظلت هي المرجعية السائدة، وفي القرون التي أعقبت ذلك ومع نشوء العلم الحديث ووسائل الإنتاج الحديثة وولادة الدولة الحديثة اتضح للكنيسة أن هناك حاجة إلى فصل الديني عن الدنيوي، بحيث اتجه وزن الدين باتجاه الحالات الوجدانية الفردية للفرد المؤمن ودوافعه الشخصية، وأدى ذلك إلى أن يهجر الانضباط (الفكري والاجتماعي) الحيز الديني تدريجياً لتحل محله أمور أخرى مثل «الاعتقاد» و«الضمير» و«رهافة الحس».
النظرية الدينية لا تنفصل عن الممارسة، هي في جوهرها مسألة تدخل، مسألة تشكيل الدين في العالم (وليس في الذهن) من خلال الخطابات التعريفية وتفسير المعاني «الصحيحة» واستبعاد بعض الأقوال والممارسات وضمّ سواها. هنا ينشأ السؤال: كيف تشكل القوة الدين؟
هنا تأتي وظيفة الطقوس والشعائر الدينية بما هي أفعال رمزية هي توليد القناعة الدينية، وفقا لبعض الأنثربولوجيين، لكن أسد يذهب إلى أنها هي محل عرض الإيمان لا إنتاجه، وهو أمر يعيد جذرياً التفكير في دور الطقوس والشعائر تلك، فهذا يعين على فهم تلك الظواهر وعلاقتها بالظواهر الاجتماعية الأخرى، بل وتأثير القوى التاريخية في تشكيلها، وبذلك يمكن فهم الطقوس على أساس أنها جزء من نظام «الضبط» الديني، حيث يمكن فهم إمكانية الانفصال بين «الشعائر الدينية» عن «المشاعر الدينية»، هنا أمكن للكنيسة المسيحية مثلا في العصور الوسطى أن تستعمل الشعائر وسيلة لضبط المجتمعات عبر القوة ومفهوم «الدين الصحيح». وأيضاً هذا ما يمكننا من فهم كيف صارت الطقوس الدينية مناسبات رمزية أمراً مقبولاً في المجتمع الحديث، حيث يتخذ المسيحيون مواقف أخلاقية متباينة ويعيشون أنماطاً لا تختلف اختلافاً بينا عن أنماط الحياة لدى غيرهم، ينطبق ذلك على الطقوس والشعائر في الإسلام أيضاً، فهي تفهم على أنها إحياء لحقيقة عميقة في نظر من يؤديها، وهي تتضمن إدراكاً بكون الدين نموذجاً للعالم ونموذجاً من أجل العالم في الوقت نفسه، أي أن وظيفة الضبط تقريباً هي ذاتها في المسيحية.
يقوم الضبط على نوعين من الإجراءات «طرق تشكيل الذات» (الفرد) و«طرق التحكم بالآخرين» (المجتمع)، وهما شكلان من أشكال القوة، أحدهما يتصل بتنمية الفضائل والآخر بتطبيق الشريعة، عبر مبدأين: العقاب، والتعذيب أو العذاب. حيث يحتل مفهوم الألم مكاناً أساسياً في مفاهيم الدين وتقنيات الضبط فيه وتحقيق «الطاعة» لما يعتقد أنها الحقيقة، الضبط الذاتي المسمى «تهذيب النفس» في الفكر الإسلامي أو «إذلال النفس» في الرهبنة المسيحية يقومان على المبدأ ذاته.
لقد استطاع أسد بجدارة إثارة إشكالية وضع تعريف أنثروبولوجي للدين بإلإحالة التاريخية للمعرفة والقوة اللتين شكلتا العالم الحديث. وبالمضي في هذا المنهج لا يمكن عزو المصاعب الكبرى التي يواجهها العالم العربي مثلاً إلى ديمومة التدين في أو إلى صحوة دينية جديدة. كذلك، فإن الفكرة القائلة إن الدولة الحديثة تتطلب فصلاً جديداً بين «الدين» والسياسة» تغدو فكرة غير صحيحة من الناحية المفاهيمية وفقاً لطلال أسد، الذي يرى أن فهم ذلك يتطلب التفكير في السياسة بمنأى عن الثنائيات البسيطة التي لجأنا إليها زمنا أطول من اللازم، ففكرة «الدولة الإسلامية» هي وليدة التفكير القائم على الثنائيات، وهو تفكير يعتقد بأن «الدين» يجب أن يسود الدولة الحديثة ويوجهها، كذلك فإن دعاة الدولة العلمانية يقدمون أفكارهم على أساس هذه الثنائيات، ويصرون على أن الدولة يجب أن تكبح جماح «الدين».
بعض الكتب تشعر المرء بفداحة ما تعانيه الدراسات العربية من فقر وتواضع، وكتاب طلال أسد هذا، الذي يثير الإعجاب في نقده العميق وقدرته الفذة على طرح الأسئلة الصعبة، لا شك أنه واحد منها.
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
مختارات
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
855 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- لانشمت بأحد ولكن نحب أن نذُكر لاغير
- طرائف "رمضانية" - شرطي المرور... والتمر!
- خريف الأصنام ... رحيل مهندس الخراب ومفتي الإبادات الجماعية ودولته على السفود-١
- ميرفت أمين: لن أكتب مذكراتي وحياتي تخصني وحدي
- بغداد ... الوهلة الأولى (١-٤)
- عندما تشوه الحسابات الخاطئة حق الدفاع عن النفس !
- قوة أميركية تنفذ إنزالاً جوياً في صحراء العراق وتشتبك مع الجيش
- فيديو / أجواء رمضانية عربية في اسطنبول
تابعونا على الفيس بوك




















































































