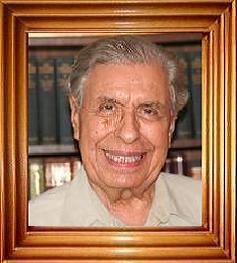القضاءُ والقدَر مُقابل مسؤوليَّةِ الإنسان....
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 30 نيسان/أبريل 2014 07:36
- كتب بواسطة: علاء الدين الأعرجي
علاء الدين الأعرجي
القضاءُ والقدَر مُقابل مسؤوليَّةِ الإنسان
من تجلِّياتِ العقلِ المجُتمَعيّ
ومن أسباب تخلفنا الحضاري
فصل من كتاب الأمة العربية بين الثورة والانقراض
علاء الدين الأعرجي
مقدِّمة
في هذا البحث سنُركِّز على ظاهرةٍ خطيرة كانت وما تزال تؤثِّرُ سلبًا في المسيرةِ التقدُّميَّة للأُمَّةِ العربيَّة وتُساهمُ في تخلُّفها عن رَكبِ الحضارةِ الحديثة، وأَقصدُ بها ظاهرةَ الإيمانِ بالقضاءِ والقدَر، المنتشرةَ في معظمِ أوساطِ المجتمعِ العربيّ، وخاصَّةً الإسلاميّ، بما فيه كثيرٌ من المتعلِّمين، وبوجهٍ أخصّ لدى الطبقاتِ الفقيرة والجاهلة التي تُشكِّلُ قرابةَ 50 في المئة من المجتمعِ العربيّ (حوالى نصف الشعب العربيّ أُمّيّ، حسب ”تقارير التنمية البشريَّة للأُمم المتَّحدة“). وأهمِّـيَّةُ بحثِ هذه الظاهرة تنجمُ عن أنَّها تؤدِّي إلى عدم شعور الإنسانِ العربيّ شعورًا عميقًا وفعَّالاً بمسؤوليَّتِه تجاهَ نفسه وإزاءَ مجتمعِه، وبالتالي تُساهم في شَلِّ المبادراتِ الشخصيَّة والكفاحِ المُثمِر لتغيير الأوضاع المتردِّية الراهنة، وبالتالي في تفاقُمِ أزمةِ التطوُّرِ الحضاريّ. وكمثالٍ على ذلك، أقول: إنَّني كنتُ وما أزال أتعمَّدٌ أن أَخوضَ في الحديث مع العديد من المهاجرين العرب في هذا البلد (أمريكا)، وخاصَّةً عامَّة الناس الذين يُمارسون الأعمالَ التجاريَّةَ الصغيرة مثل أصحابِ المتاجر العربيَّة التي تبيعُ الموادَّ الغذائيَّة مثلاً. وبعد أن نتبادلَ الرأيَ حول أوضاع أُمَّتنا الراهنة المتفاقمة، أُلاحظُ أنَّ معظمَهم، إن لم يكن جميعهم، يُنهي كلامَه، بعد أن يشكوَ مِمَّا يحدثُ في البلدِ الأُمّ من مآسٍ ونكبات، بقولٍ من هذا النوع: ”إنَّها مشيئةُ الله ولا مردَّ لها،“ أو ”ننتظرُ رحمتَه سُبحانَه وتعالى،“ أو ”لا حَولَ ولا قوَّةَ إلاَّ بالله،“ أو ”إنَّ الله مع الصابرين“، أو ”ندعو الله سُبحانه وتعالى إلى خلاصِ الأُمَّة من هذه الغمَّة.“ وأَهمُّ من ذلك أنَّ أحدَهم كان، غالبًا، يُردِّدُ لي بحرارةٍ قولَه: ”كلُّ ما أسالُ الله، سُبحانه وتعالى، أن يُبقيَ الأوضاعَ المتردِّية والجارية حاليًّا على وضعِها من التردِّي ولا يزيدَها سوءًا.“ وهذا قِمّةُ التشاؤم والاستسلام لِما يُعتقَدُ أنَّه قضاءُ الله وقدَرُه. فهو لا يفكِّرُ أصلاً بمسؤوليَّتِه عن هذا التدهوُرِ وما يُمكنُ عملُه لوَقفِه، بل يتركُ مسؤوليَّةَ ذلك على عاتقِ الله سبحانه وتعالى حصرًا.
كما إنَّ جميعَ العباراتِ السابقة تدلُّ، إضافةً إلى ذلك، على العجزِ والتواكُلِ والعزاء، الأمرُ الذي يدلُّ على مدى تغلغُل قِيَمِ القضاءِ والقدَرِ في العقلِ المجتمَعيّ. ونحن لا نُريدُ أن نُقلِّلَ من قدرةِ الله تعالى، ولكنَّنا نتأسَّى بالآيةِ الكريمة: ”وما تُقدِّموا لأنفسكم من خيرٍ تَجدوه عند الله إنَّ الله بما تعملون بصير“ (البقرة 110)؛ وبالحديثِ المنسوبِ إلى الرسول (ص): ”إعقلْ وتوكَّلْ“ أو ”إعقِلها وتوكَّلْ“، وهو جوابٌ لِمَن سأله: ”أأعقلُها [أي الناقة] وأتوكَّل أم أُطلقها وأتوكَّل؟“ لأنَّ إطلاقَ الناقة قد يؤَدِّي إلى ضياعِها. وهذا يُبرهنُ أنَّ على الإنسانِ أن يفعلَ جميعَ ما في طاقته لتجنُّبِ الضرَرِ واستجلابِ الخير، ثمَّ يتوكَّل، لا أن يظلَّ قاعدًا، أو يتركَ الأُمورَ تجري على عواهنِها، وينتظرَ رحمةَ الله أن تُصلحَها. كما نتذكَّرُ القولَ المأثور، المنسوب إلى الإمام عليّ (ع): ”إعمَلْ لدُنياك كأنَّكَ تعيشُ أبدًا واعمَلْ لآخرتِك كأنَّكَ تموتُ غدًا.“
وعندما كنت أدعو هؤلاء الناسَ وغيرَهم من المعارف والأصدقاء المتعلِّمين أو المثقَّفين، إلى الاشتراك في اجتماعاتٍ أو تظاهُراتٍ يُنظِّمُها بعضُ المؤسَّساتِ الأمريكيَّة للتعبير عن الرأي المخالِف، خاصَّةً في ما يتعلَّقُ بقضايانا الساخنة،- قضية فلسطين، الحصار على العراق- لا أجدُ آذانًا صاغية؛ ونادرًا جدًّا ما كان يحضرُ تلك الأنشطة أفرادٌ قلَّة يُعَدُّون على الأصابع، في حين يحضرُها الأمريكيُّون بالآلاف عادةً، ومع ذلك ينبغي أن نكون حَذِرين من التعميم، لأنَّ قليلاً من التظاهرات المتعلِّقة بالقضايا العربيَّة الساخنة حضرَها عددٌ كبيرٌ من العرب.
إذًا تنطلقُ هذه الدراسة من فرضيَّةٍ مَفادُها أنَّ العربَ خاصَّةً، والمسلمين عامَّةً، يميلون في الغالب إلى الإيمانِ بالقضاءِ والقدَرِ أكثرَ من مَيلِهم إلى حرِّيةِ الإنسانِ ومسؤوليَّتِه إزاءَ نفسِه وأُمَّتِه ووطنِه؛ مع التسليم بوجودِ مُحاولاتٍ لتعديلِ هذا الاتِّجاه، سواءٌ بواسطة حركاتٍ دينيَّة أو عَلمانيَّة. لكنَّ هذه الحركاتِ والأنشطةَ ظلَّت محصورةً في أوساطٍ معيَّنة؛ وتأثيراتُها بقيَت محدودة. ونأملُ، مع ذلك، أن تتوسَّعَ أَمثالُ هذه الحركات، خاصَّةً ذات الاتِّجاهِ العقلانيّ المستنير، الذي يتوخَّى بثَّ روحِ المسؤوليَّة الشخصيَّة وإطلاقَ طاقاتِ الإنسانِ العربيّ الخلاَّقة لِحَفزِ قُدراتِه الإبداعيَّة عِوضًا عن الإبقاءِ على روحِ التقليدِ الاتِّباعيَّة، وذلك عن طريقِ تفعيلِ عقلِه الفاعِل ضدًّا لعقله المنفعِل. وأظنُّ أنَّ ذلك يُمكنُ أن يتحقَّق، إلى حدٍّ كبير، بتفعيلِ أركانِ مجتمعِ المعرفة الخمسة، التي حدَّدَها ”تقريرُ التنميةِ الإنسانيَّة العربيّ للعام 2003“، ألا وهي: 1) إطلاق حرِّيـَّاتِ الرأيِ والتعبيرِ والتنظيم؛ 2) النشرُ الكامل للتعليم راقي النوعيَّة؛ 3) توطينُ العلم؛ 4) التحوُّل نحو نمطِ إنتاجِ المعرفة في البِنيةِ الاجتماعيَّةِ والاقتصاديَّة؛ 5) تأسيسُ نموذجٍ مَعرِفيٍّ عربيٍّ عامّ، أصيل، مُنفتِح ومُستنير.
بعضُ تجلِّياتِ الإيمانِ بالقضاءِ والقدَر
لذلك سنُحاولُ أن نُحلِّلَ ونُجذِّر، في هذا الفصل، ظاهرةَ الإيمانِ بالقضاءِ والقدَر، التي نعتبرُها من الآفاتِ التي ترسَّخَت في العقلِ المجتمعيِّ العربيّ، وبالتالي بالعقلِ المنفعِلِ للفردِ العاديّ الذي أصبح يقبلُ القهرَ والظلمَ والكوارث، باعتبارِها قدَرًا مُحتَّمَاً، بل يعتبرُها بعضُهم امتحانًا من الله لمدى صبرِه وإيمانِه: ”فاصبروا إن الله يُحبُّ الصابرين“، ويتأسَّى بصبرِ أيُّوب. كما إنَّ هناك عشراتِ الأمثلةِ والأقوالِ الشعبيَّة التي يُردِّدُها العربيّ، وبخاصَّة المسلم، تدلُّ على مدى تعلُّقِه بالقضاءِ والقدَر، وعجزِ الإنسانِ عن التحكُّمِ بحاضرِه ومُستقبلِه؛ منها الأمثالُ المصريَّةُ السائدة مثل ”إللي انكَتب عالجبين لازِم تشوفُه العين“، و”قِسمتي كِدَه“، و”اجري يا بن آدم جَري الوحوش غير نصيبك ما تحوش“، و”العبد في التفكير والربّ في التدبير“، و”العين صابتني وربّ العرش نجّاني“، و”درهم حظّ ولا قنطار شطارة“؛ والأمثال العربيَّة الأُخرى كـ”لا تفكِّر، لها مُدبِّر“، و”إذا وقع القدَر عَميَ البصر“، و”قِسمة ونصيب“، و”المكتوب ما منه مهروب“، و”سبع صنايع والبخت ضايع“.
ومُقابل ذلك هناك أمثالٌ وأقوالٌ تتضمَّنُ مسؤوليّةَ الإنسانِ عن أعمالِه، لكنَّها قليلةٌ وغيرُ منتشرة، ولا فاعلة كالمجموعةِ الأُولى. منها ”اللي ما يزرع ما يحصد“، و”العيشة تدبير“، و”اقعُدْ على وَكرِ الدبابير وقُلْ هذا تقدير“ (يقال في معرض السخرية)، و”القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود“.
لماذا ظهرَت وبرزَت الأمثالُ والأقوالُ التي تدلُّ على التواكُلِ والاستسلام أكثر من تلك التي تحثُّ على العملِ وتحمُّلِ المسؤوليَّة؟ سؤالٌ سنُجيب عنه فيما بعد، خصوصًا في الفصل الخاصِّ بتعرُّضِ الأُمّةِ العربيَّة للقهرِ والاستبداد خلال الـ14 قرنًا الماضية.
وغالبًا ما تُعزى جميعُ المصائبِ والنوائب التي تحلُّ بالأُمَّة إلى قضاءِ الله وإرادتِه، في نهاية الأمر، أو بالأحرى إلى أسبابٍ يعتبرُها البعضُ عقابًا لأهلها من الله تعالى على تقصيرِهم في شؤونِ دُنياهم أو آخرتِهم. مثلاً: يرى الكاتبُ منير شفيق، في كتابه ”الإسلامُ وتحدِّياتُ الانحطاطِ المعاصِر“، أنَّ هزيمة العام 1967 كانت ”عقوبةً حتميَّة“ كان لا بدَّ من أن ”تدفعَها الأُمَّة...كمُحصَّلة طبيعيَّة لمحاربةِ الإسلام والسَّيرِ في طريق التغريب.“
كما قام الشيخ محمَّد مُتولِّي الشعراوي، وزيرُ الأوقافِ السابق في مصر، بالتوجُّه بالشكر إلى الله في صلاة ركعتَين، شاكرًا له صنيعَه لأنَّ ”مصر لم تنتصر.“ وقيل إن سببَ الهزيمة كان قدَرًا من الله وعقوبةً لأنَّ السلاحَ الذي حاربَت به كان سلاحًا كافرًا.
وفي مطلع عام 2005 حدثَ زلزالٌ أَرضيٌّ عنيف، في أعماق المحيط الهنديّ، فسبَّبَ كارثة ”تسونامي“ في منطقة جنوب شرق آسيا شملَت الفلبّين وأندونيسيا وماليزيا والهند وسيرلانكا وبلدانا أُخرى، ووصلت إلى القرن الإفريقيّ، وحصدَت قرابةَ ثلاثمئة أَلف إنسان، وخاصَّةً من الفقراء وعامَّة الناس. وتفسيرًا لذلك كتبَ أحدُ ”الدكاترة“ المعروفين في مصر في إحدى الصحُف المصريَّة إنَّ هذه الكارثة حصلَت كإنذارٍ وعقابٍ من الله بسببِ ما كان يُقترَفُ من ذنوبٍ في تلك البلدان الساحليَّة التي كان يرتادُها السيّاح من مختلفِ أرجاءِ العالمَ.
وقد وصف نزار قبَّاني ظاهرةَ الإيمان بالقضاءِ والقدَر السائدة لدى العرب على النَّحوِ التالي:
نجلسُ بالجوامع تنابلاً كسالى...
ونشحذُ النصرَ على عدوِّنا من عنده تعالى.
ومع ذلك، هناك في العصر الحديث مَن يُعارضُ هذه النزعةَ الاتِّكاليَّةَ أو القدَريَّة.
يقول أبو القاسم الشابي:
إذا الشعبُ يومًا أرادَ الحياةَ
فلا بدَّ أن يستجيبَ القدَرْ
ولا بدَّ للَّيلِ أن ينجلي
ولا بدَّ لِلقَيدِ أن ينكسِرْ
و يقولُ شوقي:
وما نيل المطالبِ بالتمنَّي ولكنْ تؤخذ الدُنيا غِلابا
وهكذا نحن نُلاحظُ وجودَ صراعٍ بين قِيَمِ الجَبر (كتعبيرٍ آخَر عن القضاءِ والقدَر) التقليديَّة القديمة وقِيَمِ القُدرةِ والتمكُّن وحُرِّيـَّةِ الاختيار التي أنشأت الحضارةَ الحديثة، وأهمِّـيَّةِ مُواجهةِ الإنسانِ لمسؤوليَّاتِه. ومع ذلك فما تزالُ الأغلبيَّةُ العُظمى من العربِ يدينون بالجَبر أكثرَ مِمَّا يَدينون بالاختيار، حسب تقديرنا.
لكنَّ كلَّ ذلك لا يعني أنَّ معظمَ العربِ وحدهم يؤمنون بالقضاءِ والقدَر، بل إنَّ معظمَ المجتمعاتِ البشريَّة، أو ربَّما جميعها، آمنَت، في بعضِ مراحلِ تطوُّرِها الماضية أو الراهنة بالقضاءِ والقدَر. ولكنْ من الملاحَظ أنَّه كلَّما ارتفعَ المجتمعُ في سلَّمِ التقدُّم والرقيّ المادّيّ والفكريّ، استطاع معظمُ أفرادِه أن يتغلَّبوا على هذه النزعة، خاصَّةً إذا تمكَّن، ذلك المجتمع، من تفسير الظواهر الطبيعيَّة، واستطاع أن يُسخِّرَها لخدمتِه وتقدُّمِه. وعلى العكس من ذلك نلاحظُ أنَّ جميعَ المجتمعات البدائيَّة، بما فيها القديمة أو المعاصرة، تؤمنُ بشكلٍ أو آخَر بالقضاءِ والقدَر.
التعريفُ بالقضاءِ والقدَر
القضاءُ في الاصطلاح: ”عبارةٌ عن الحُكم الكلِّيّ الإلهيّ في أعيانِ الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية من الأزلِ إلى الأبد“، مثلَ الحُكمِ بأنَّ كلَّ نفسٍ ذائقةٌ الموت (الجرجانيّ: ”التعريفات“). والقَدَرُ في اللغة: القضاء، والحُكم، ومبلغُ الشيء، والطاقة، والقوَّة، ويُطلَق على ما يَحْكمُ به الله من القضاءِ على عِبادِه، وعلى تعلُّقِ الإرادة بالأشياءِ في أوقاتِها. ويقول الأشعريَّة إنَّ القضاءَ هو قضاءُ الله الثابت في إرادتِه الأزليَّة المتعلِّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. ويعني قَدَرُه إيجادَ الأشياء على قَدْرٍ مخصوص، وتقدير معيَّن في ذواتها وأحوالها.
وكتعريف تقريبّي، وفي المفهوم السائد، على الصعيد العامّ، كما في المفهوم الوارد في هذا البحث، يعني تعبير ”القضاء والقدر“ أنَّ الإنسانَ مُسيَّر لا مُخيَّر، ولا يستطيعُ أن يتحكَّمَ بحياته، حاضرِه أو مُستقبلِه ومصيرِه، أي إنَّه عاجزٌ عن تغييرِ أو تعديلِ ظروفهِ الخاصَّة ناهيك عن التحكُّم بالعالَمِ الخارجيّ. وغنيٌّ عن القَول إنَّه سينشأُ تناقضٌ بين هذا المفهومِ ومدى مسؤوليَّةِ الإنسانِ عن أعمالِه سواءٌ قانونيًّا أو أخلاقيًّا أو دينيًّا. فكيف يُمكنُ أن يكونَ الإنسانُ مسؤولاً عن أفعالِه ما دامت مُقدَّرة عليه من قِبَلِ سلطةٍ خارجةٍ عن إرادتِه؟ كما يتعلَّقُ الأمرُ بموضوعاتٍ تتعلَّقُ بالفلسفةِ بوجهٍ عامّ وفلسفةِ القانونِ والأخلاق، بوجهٍ خاصّ، مِمَّا يطولُ فيه البحثُ والحديث. لذلك سنكتفي في هذه الحلقة بالتحدُّث عن القضاءِ والقدَر في التاريخ العربيِّ الإسلاميّ، بما فيه الفكرُ الإسلاميّ، لأننا نفترضُ أنَّ العقلَ المجتمعيَّ العربيَّ متأثِّرٌ بالجانبِ المظلمِ من ذلك التاريخ.
القضاءُ والقدَرُ في التاريخ العربيِّ الإسلاميّ
سنقسِّمُ هذا الفصلَ إلى ثلاثةِ فروع: الأوَّل يتعلَّقُ باستعراضِ النصوصِ الدينيَّة التي تدعمُ القضاءَ والقدَر، أو تدعمُ مسؤوليَّةَ الإنسانِ وحرِّيـَّتَه. والثاني يتعلَّقُ بواحدةٍ من أهمِّ الحركاتِ المُعارِضة للقضاءِ والقدَر في الإسلام، ألا وهي حركةُ ”المُعتزِلة“. والثالث يتعلَّقُ بالحُكم الاستبداديّ ”المُلك العَضوض“ وأثرِه في توطيدِ عقليَّةِ الاستسلامِ للقضاءِ والقدَر.
أوَّلاً، في النصوصِ الدينيَّة: يُمكنُ القولُ إنَّ التفسيرَ الإسلاميَّ لظاهرة القضاء والقدر يستندُ إلى كثيرٍ من الآيات الواردة في القرآن الكريم، ومنها ﴿إنّا كلّ شيءٍ خلقناه بقدَر﴾ (القمر: 49)، و﴿ قُلْ لن يُصيبَنا إلاَّ ما كتبَ الله لنا﴾ (التوبة: 51). و﴿ قُلْ لا أَملكُ لنفسي ضَرًّا ولا نفعًا إلاَّ ما شاءَ الله﴾ (يونس: 49)، و﴿ما أصاب من مُصيبةٍ في الأرضِ ولا في أنفسكم إلاَّ في كتابٍ من قبل أن نَبْرَأَها إنَّ ذلك على الله يسير﴾ (الحديد: 22)، و﴿وكلُّ صغيرٍ وكبير مُسْتَطَر﴾ (القمر: 53)، و﴿إنَّ الله يُضِلُّ مَن يشاء ويهدي من يشاء﴾، و﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلَهم﴾ (الأنفال 17) وغيرها.
ولكنْ ينبغي أن نلاحظَ وجودَ آياتٍ أُخرى مُناقضة ومُعدِّلة تخالفُ ظاهرَ هذه النصوص. ومنها ﴿إنَّ الله لا يُغيِّرُ ما بقومٍ حتَّى يُغيِّروا ما بأنفسهم﴾، فإذا أَتممنا الآية فسينقلبُ المعنى إلى ضدِّه: ﴿وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مردَّ له﴾ (الرعد: 11)، و﴿مَن عملَ صالحًا فلنفسِه ومَن أساءَ فعليها، وما ربُّكَ بظلاَّمٍ للعبيد﴾ (فُصِّلت:46)، و﴿ذلك بما قدَّمَت يداك وإنَّ الله ليس بظلاَّمٍ للعبيد﴾ (الحجّ: 10)، و﴿قُلْ يا قوم اعملوا على مكانَتِكُم إنّي عامل، فسوف تعلمون﴾ (الأنعام: 135)، و﴿ومن يكسبْ إثمًا فإنَّما يكسبُه على نفسِه﴾ (النساء: 111)، و﴿ما ظلمناهم ولكنْ ظلموا أنفسَهم﴾ (هود: 101). وهناك عددٌ كبير آخَر من أمثال هذه الآيات. ولكنْ من الملاحَظ أنَّ الآياتِ الأُولى المتعلِّقة بالقضاءِ والقدَر معروفةٌ ومُعتبَرة ومُتَّبعة أكثر من آياتِ المجموعة الثانية المعاكِسة التي تُشدِّد على مسؤوليِّةِ الإنسان، وذلك لأسبابٍ تتعلَّقُ بالعقلِ المجتمعيِّ العربيِّ والإسلاميّ الذي يستنجد، في عصرِ الانحطاط، بكلِّ الوصفاتِ الجاهزة، المُهدِّئة أو المُخدِّرة، على النحوِ الذي سنُحاولُ تفسيرَه فيما بعد.
تفسيرُ الجابري: في كتابِه ـ”التراث والحداثة“
يرى المفكِّرُ محمَّد عابِد الجابري أنَّ في القرآن آياتٍ تُفيدُ الجَبْرَ وأُخرى تُفيدُ الاختيار. ولكنْ يجبُ أن نأخذَ بنظرِ الاعتبار أسبابَ النزول ومُراعاةَ قصدِ الشارع. ويرى أنَّ الآياتِ التي تُفيد الجبرَ إمَّا أن تتعلَّقَ بالماضي باعتبار أنَّ ما حدثَ في الماضي لا يمكنُ تغييرُه، مثل﴿سنَّة الله التي خلَت من قبل ولن تجدَ لسنَّةِ الله تبديلا﴾، وإمَّا أنَّها نزلَت للحَثِّ على الصبرِ والتضحية في الصراع مع قُرَيش أوَّلاً، وحين الغزواتِ والحروب مع الكفَّار ثانيًا. يقول: ”إنَّ الآياتِ التي تُفيد الجبرَ في هذا المقام لم تكنْ تدعو إلى الاستسلام، بل بالعكس، كانت تحثُّ على الصبر وتدعو إلى التضحية. ولكنَّ السياسةَ فيما بعد هي التي وظَّفَت هذه الآياتِ في أغراضِها بعد أن قطَعَتها من سياقِها وعزلَتها عن أسبابِ نزولها، أي عن تاريخيَّتِها.“ ومع تقديرِنا لرأي الجابري، فإنَّنا نرجح أنَّه يَنـْصَبُّ على ما يجب أن يكون، أكثرَ مِمَّا ينصبُّ على ما هو كائنٌ فعلاً.
ثانيًا، القَدَريّـِـة والمُعـتزِلة
منذُ أن ظهرَت مسألةُ القضاءِ والقدَر أو الجَبر التي رفعَها الأُمويُّون في الشام، لتبرير حكمهم، انبثقَت حركةٌ فكريَّةٌ وسياسيَّةٌ مُعارضة تقولُ بحرِّيـَّةِ الإرادة أُطلِق عليها اسمُ ”القَدَريّة“ (بمعنى القُدرة أو الاستطاعة، لا الجَبر)، رفعوا شعارًا يقول بقدرة الإنسان على ”خَلـْــقِ أفعاله، وبالتالي مسؤوليته عنها...“ فأطلقَ عليهم خصومُهم مُصطلحَ ”القَدَرِيَّة“ (من قَدِرَ قدَرًا بمعنى اقتدَرَ، لا من القضاء والقَدَر الخارج عن إرادة البشر)، استنادًا إلى حديثٍ نسبوه إلى الرسول (ص) يقول فيه:”القَدَريّة مَجوسُ هذه الأُمَّة.“ وكان الذين يؤمنون بحرّيـِّةِ الإرادة يرفضون هذا الوصف ويقولون إنَّه يصدقُ على الذين يقولون بالقضاء والقدَر، ومع ذلك لُصقَ بهم هذا الاسمُ حتَّى اليوم.
والمسألةُ التي أُثيرت بين المتكلِّمين الأوائل هي صفةُ ”العِلم“ التي تُسبَغُ على الله تعالى، باعتباره عالمًا بكلِّ شيء، بما في ذلك علمُه منذ الأزَلِ بما سيكون. ومن هنا ظهرَت قضيَّةُ التناقُضِ بين عِلمِ الله السابق وبين عَدلِه. وثار السؤالُ الخطيرُ التالي: كيف يُمكنُ أن يُحاسِبَ الله الإنسانَ على أعمالِه وهو يعلمُ مُقدَّمًا ما سيحدثُ له، ولماذا يطلبُ منه القيامَ بأُمورِ معيَّنة ويمنعُ عنه أُمورًا أُخرى، وهو عالِمٌ مُسبَّقًا بأنَّه سيتبعُها أو لا يتبعُها؟
يقول أحمد أمين: ”نشأَت الأبحاثُ الدينيَّة في هذا الموضوع لمَّا نظرَ الإنسانُ فرأى أنَّه، من ناحية، يشعرُ بأنَّه حرُّ الإرادة يفعلُ ما يشاءُ وأَنَّه مسؤولٌ عن عملِه، وهذه المسؤوليَّة تقتضي الحرِّية. فلا معنى لأن يُعذَّبَ أو يُثابَ إذا كان كالريشة في مهبِّ الريح لابدَّ أن تتحرَّكَ بحركته وتسكنَ بسكونه. ومن ناحية ثانية رأى أنَّ الله عالِمٌ بكلِّ شيء، أحاط عِلمُه بما كان وما سيكون، فعَلِمَ بما سيصدر عن كلِّ فرد من خيرٍ أو شرّ، وظنَّ أنَّ هذا يستلزمُ حتمًا أنَّه لا يستطيعُ أن يعملَ إلاَّ على وَفقِ ما علمَ الله، فحارَ في ذلك بين الجبرِ والاختيار، وأخذ يُفكِّر: هل هو مُجبَر أو مُختار.“ ومن جهةٍ ثالثة، برزَ السؤالُ الخطيرُ الآخَر: إذا كان الإنسانُ يعملُ وَفقَ عِلمِ الله، أو إرادته، فهل يُمكنُ أن يفعلَ الله الظلمَ أو القبيح؟ ولماذا يُعذب الكافر الطالح، ويُثاب المؤمن الصالح، إذا كان الإنسان مُجْبَرٌ وليس مُخَيَّر؟
وبالإضافة إلى المناقشات ”الكلاميَّة“، والفلسفيَّة، كان لهذه القضيَّة انعكاساتٌ وتداعياتٌ سياسيَّة خطيرة. ذلك لأنَّ من المُمكن أن يغتصبَ الحاكمُ سدَّةَ الحُكم بالقوَّة، ويدَّعي أنَّ ذلك كان بعِلمِ الله وإرادته. فضلاً عن أنَّ بإمكانِه أنْ يظلمَ ويقتلَ جميعَ مُعارضيه ويسلبَ وينهبَ الأموال، ويرتكبَ جميعَ الموبِقات، مُدَّعيًا أنَّ ذلك يحدثُ بناءً على إرادةِ الباري عزَّ وجَلّ. وقد ظهرَت هذه المسألةُ في مطلعِ العصرِ الأُمويّ، كما قلنا. فالأُمويُّون الذين استولَوا على الحُكمِ بالقوَّة استنَدوا في شرعيَّةِ حُكمِهم إلى قضاءِ الله وقدَرِه، كما سيأتي شرحُه.
ويذكر التاريخ أنَّ أسبقَ مَن بشَّرَ بمبدإِ حُرِّية الإرادة ومسؤوليَّةِ الإنسان عن أعماله مَعَبد الجُهني وغَيلان الدمشقيّ. الأوَّلُ قتلَه الحجَّاج صَبرًا (أي بعد أن أَوثقَه ومنعَ الطعامَ عنه)، وقام هشام بن عبد الملك بقَطعِ يدَي الثاني ورجلَيه وقتلِه وصَلبِه، وكان ذلك في عام 106 للهجرة (724م). وكان غَيلان الدمشقيّ قد تعلَّم مع واصل بن عطاء على يَدِ اثنَين من آلِ البَيت من أحفاد عليّ بنِ أبي طالب وأولادِ محمَّد بنِ الحنفيَّة. ثمَّ ذهبَ إلى البصرة لينضمَّ إلى حلَقةِ الحسَن البَصريّ الذي كان يتحدَّثُ في مسجِدِ البصرة، مُفنِّدًا آراءَ مَن يُبرِّرُ أعمالَ الملوكِ الدامية بأنَّها قَدرٌ من الله.
وكان الحسَن البصريّ يتمتَّعُ بمكانةٍ دينيَّةٍ وعِلميَّة واجتماعيَّة عالية. وبينما كان يستشيرُه الخليفةُ الصالحُ عُمَر بنُ عبد العزيز في كثيرٍ من المناسبات، كان يختلفُ معه بقيَّةُ الخلفاءِ الأُمويِّين وخاصَّةً الخليفةَ عبدَ الملك بنَ مروان (65-86هـ/685-705م). وقد أبقى عليه الأُمويُّون لعدَّةِ اعتباراتٍ سياسيَّة ومَصلحيَّة. يذكرُ الدينوري في كتابه ”الإمامة والسياسة“: ”أنَّ مَعبد الجُهَني وعطاءَ بنَ يسار دخَلا على الحسَن البَصريّ، وهو يُحَدِّثُ في مجلس البصرة كعادتِه، فسألاه: ’يا أبا سعيد، إنَّ هؤلاء الملوك يسفكون الدماء، ويأخذون الأموال، ويفعلون كذا وكذا، ويقولون: إنَّما تجري أعمالُنا على قدَرِ الله.‘ فأجابَهما الحسَن:’ كَــذبَ أعداءُ الله.‘ “
ويُذكَرُ أنَّ عبدَ الملك بنَ مروان أرسلَ إلى الحسَن البصريّ رسالةً مُطوَّلة، عبَّر فيها عن قلقِه عمَّا بلغَه عنه من كلامٍ حول ”القدَر“، وطلبَ فيها توضيحَ موقفِه؛ وفيها كثيرٌ من التهديدِ المبطَّن، إذْ يتَّهمُه بأنَّ ما يقولُه قد يُعتبَرُ ”بِدعة“، لأنَّه لم يسمعْ به من قبل، ويطلبُ منه سندَه ومرجعيَّتَه. فأجابه الحسَنُ البصريّ برسالةٍ مُطوَّلة أُخرى تتضمَّنُ كثيراً من التحدِّي. ومِمَّا قاله فيها: ”واعلَمْ، يا أميرَ المؤمنين أنَّ الله لم يجعل الأُمورَ ’حتماً‘ على العباد، ولكنْ قال لهم إن فعلتم كذا فعلتُ بكم كذا، وإنَّما يُجازيهم بالأعمال... ولكنَّ الله قد بيَّنَ لهم مَن قَدمَ لهم ذلك ومَن أضلَّهم، فقال: ﴿وقالوا ربَّنا إنَّا أطعنا سادتَنا وكُبراءَنا فأَضلُّونا السبيلا﴾ (الأحزاب 67).‘ ويقول الله تعالى: ﴿إنَّا هَديناه السبيلَ إمَّا شاكرًا وإمَّا كَفورا﴾“ (الإنسان: 3).
ويُعلِّقُ الجابري على هذه الرسالة الهامَّة قائلاً إنَّها ”تضعُنا أمام خطابٍ جديد في المعارضة، خطابٍ ينسفُ إيديولوجيَّة الجَبر الأُمويّ فيؤَكِّدُ أنَّ أعمالَ الناسِ ليست حتماً عليهم بل هم يأتونها باختيارهم، وبالتالي فهم مسؤولون مُحاسَبون. والخطابُ مُوجَّه مُباشرةً إلى أمير المؤمنين، صيغةً ومضمونًا؛ فإضافةً إلى استعمال صيغة النداء ”يا أميرَ المؤمنين، وذِكر ”فرعون“ و”السادات“ و”الكُبراء“... الذين أضلُّوا أقوامَهم، نجدُ النصَّ يستحضرُ هؤلاء ليُعطيَ لمسألةِ الجَبرِ والاختيار كاملَ مضمونِها السياسيّ. ومن هنا ستنطلقُ حركةٌ تنويريَّة جعلَت قضيّتَها الأساسيَّة نشرَ وَعيٍ جديدٍ بين الناس، الوعيِ باَّنَّ الإنسان، والحكَّام في المقدَّمة، يفعلُ ما يفعلُ بإرادتِه واختياره، وأنَّ الله لا يرضى الظلمَ فكيف يُجبرُه على فِعلِه؟“ ومُجملُ القول إنَّ الذين قالوا بحرِّيةِ الإرادة أُطلِق عليهم ”القَدَرية“، كما أسلفنا، ثمَّ اشتُهِروا بـ”المُعتزِلة“ فيما بعد. وقيل كثيرٌ عن سببِ إطلاقِ هذه الصفةِ الأخيرة أو هذا الاسمِ على هذه الفرقة. ومن ذلك قولهُم إنَّ واصلَ بنَ عطاء وعَمرو بنَ عُبيد اعتزلا حلَقةَ الحسنِ البصريّ، لاختلافِهم معه في مسألةِ مُرتكبِ الكبيرة. وقال الشريفُ المرتضى في كتابِه ”المـــُــنية والأمل“، إنَّ تسميتَهم بالمعتزلة جاءت ”لاعتزالهم كلَّ الأقوالِ الـمُحدَثة“، أي الأقوالِ السابقة في مُرتكبِ الكبيرة. وقيلَ غيرُ ذلك.
وتتلخَّصُ أُصولُ فرقةِ ”العَدل والتوحيد“ التي سُمِّيَت فيما بعد بـ”المُعتزِلة“، في خمسة مبادئ هي: التوحيدُ والعَدلُ والمَنزلةُ بين المنزلتَين، والوعدُ والوعيد، والأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المُنكَر.
والذي يهمُّنا من هذه الأُصول، في المقام الأوَّل، هو ”العدلُ“، بما أنَّه يرتبطُ بموضوعِنا. ومعناه عدمُ نسبةِ الظُّلمِ إلى الله. أمَّا الظلمُ الذي يجري في الواقع، فإنَّه من صُنع الإنسان، باعتباره خالقًا لفِعلِه لأنَّه حرُّ الإرادة وقادرٌ على الفِعلِ الحسَن أو السيِّئ، الحقِّ أو الباطل. وهكذا يكونُ الإنسانُ حرًّا ومسؤولاً عن أفعالِه، وإلاَّ كيف يمكنُ أن يُحاسبَه الله (العادل). ويُقرِّرُ المُعتزلة ” أنَّ للإنسانِ قدرةً وإرادةً ومشيئةً واستطاعة قد خلقَها له خالقُه، وأنَّها تؤَدِّي وظائفَها، بشكلٍ مستقلٍّ وحُرّ، فيما يتعلَّقُ بالأفعالِ المقدورة للإنسان، ومن ثَمّ فإنَّ الإنسانَ هو خالقُ أفعالِه، على سبيلِ الواقع لا المجاز، ونسبةُ هذه الأفعالِ إليه هي نسبةٌ حقيقيَّة، وبالتالي فإنَّ الجزاءَ، ثوابًا أو عقابًا، هو أمرٌ منطقيٌّ ليست فيه شُبهةُ جَور تلحقُ بالباري سُبحانَه، كما هو الحالُ إذا قال المرءُ برأيِ المُجْبِرة.“
فهؤلاء يرفعون لواءَ الجبرِ، ويُنكرون حرِّيةَ الإرادة ولا يجعلون العقابَ ولا الثوابَ مرتبطًا بالفاعلِ البشريّ بل بمشيئةِ الله، إن شاءَ عاقبَ، وإن شاءَ لا يُعاقِب. .
ومن المعروفِ أنَّ أصحابَ الفكرِ الجَبريِّ يستندون في دعواهم إلى ”العِلمِ الإلهيِّ السابق“، الذي وردَ في القرآنِ الكريم في كثير من الآيات؛ منها: ﴿ألم تعلمْ أنَّ الله يعلمُ ما في السماءِ والأرض، إنَّ ذلك في كتاب﴾ (الحجّ:70). كما استندوا إلى آيات يدلُّ ظاهرُها على الجَبر، منها ﴿ولو شئنا لأتَينا كلَّ نفسِ هُداها ولكنْ حقَّ القولُ منِّي لأملأنَّ جهنَّمَ من الجنَّةِ والناسِ أجمعين﴾ (السجدة: 13).
وأوَّلُ مَن قال بـ”الجَبْريَّة“ جَهم بنُ صَفوان، لذلك سُمِّيَت هذه الفرقة ”الجَهْمِيَّة“. وكان يقول ” إنَّ الإنسانَ مجبورٌ لا اختيارَ له ولا قدرة، ولا يستطيعُ أن يعملَ غيرَ ما عمِل، وإنَّ الله قُدَّرَ عليه أعمالاً لا بدَّ أن تصدرَ منه، وإنَّ الله يخلقُ فيه الأفعالَ كما يخلقُها في الجماد، فكما يجري الماءُ ويتحرَّكُ الهواءُ ويسقطُ الحجر، فكذلك تصدرُ الأفعالُ عن الإنسان، يُصدرُها الله فيه وتُنسَبُ إلى الإنسانِ مجازًا كما تُنسَبُ إلى الجمادات. فكما يُقالُ أثمرت الشجرةُ، وجرى الماءُ، وطلعَت الشمسُ، وأمطرت السماء، وأنبتَت الأرضُ، كذلك يُقالُ كتبَ محمَّد، وقضى القاضي، وأطاع فلان، وعصى فلان، كلُّها من نوعٍ واحد على طريقِ المجاز. والثوابُ والعقابُ جَبر، كما إنَّ الأفعالَ جَبر، والله قـــَـدَّرَ لفُلانٍ فِعلَ كذا وقدَّرَ له أن يُثاب، وقدَّرَ على الآخَر المعصية وقدَّرَ أن يُعاقَب.“
نلاحظُ هنا هذا الصراعَ المتواصلَ بين العقلِ والنَّقل. فالمعتزِلةُ آمنوا بالعقلِ وفسَّروا النصوصَ الدينيَّة تفسيرًا منطقيًّا فلسفيًّا. وهم أسدوا بذلك خدمةً كبيرةً للإسلام حينما تعرَّضَ لهجماتِ عقائدِ الفرسِ المانويَّة وغيرِها من العقائد غير الإسلاميَّةِ الأُخرى التي انتشرَ دُعاتُها مُستفيدين من إباحةِ حرِّيةِ الجدَلِ والمناظرة، في العصرِ العبَّاسيِّ الأوَّل. فلم يكُن أصحابُ الحديث (النقل) مُسلَّحين إلاَّ بالنصوص؛ القرآنِ والسنَّة. بينما يتطلَّبُ الأمرُ مُحاجَّةَ الخصمِ بالدليلِ العقليِّ الذي يُتقنُه المعتزلة. أمَّا الفلاسفة فكانوا لا يتعرَّضون للدين إلاَّ إذا تعارض مع الفلسفة، فيعملون على تكييفِ الفلسفة بُغيَة أن لا تتعارضَ مع الدين. فهم فلاسفةٌ أوَّلاً ثمَّ مُتديِّنون ثانيًا. بينما يتَّسمُ المعتزلة بكونهم مُتديِّنين أوَّلاً وآخرًا، ومع ذلك فهم مُسلَّحون بالحُجَجِ المُقنِعة والأدلّةِ الدامغة. وكان بينهم خُطباءُ بُلَغاء، وعُلماءُ فُقهاء، من أمثال النظّام والجاحظ وبِشر بنِ المعتمر وأحمد بن أبي دؤاد. وهم الذين اخترعوا علومَ البيانِ والبلاغة. فكانوا يتحدَّثون بلُغةٍ فصيحةٍ سائغة ومؤَثِّرة تفهمُها العامَّة وتُقدِّرُها الخاصَّة. ويُمثِّلُ هؤلاء الجيلَ الثاني بعد عُلماء وخُطباء بارزين من أمثال الحسَن البصريّ وواصل بن عطاء. أَمَّا الفلاسفة فيتحدَّثون ”بعباراتٍ جافَّة غامضة، كأنَّها رموزٌ وإشارات.“
ثالثًا: ”المُلكُ العَضوض“
الاستبدادُ والقهرُ يؤَدِّيان إلى الإيمانِ بالقضاءِ والقدَر
لعلَّ أوَّلَ مَن صرَّحَ بقضاءِ الله أو بـ"الحقِّ الإلهيِّ" في مُواصلةِ الحُكم، في الإسلام، هو الخليفةُ عثمان بن عفَّان، حين طُلِبَ إليه التنحِّي عن الخلافة، فقال قولتَه المشهورة: ”واللهِ لا أنزعُ ثوبًا سربلَنيه الله.“
ويُمكنُ القولُ إنَّ فكرةَ القضاءِ والقدَر طُرِحَت لأوَّل مرَّة لتتَّخذَ أبعادًا سياسيَّة أسفرَت عمَّا أُطلِق عليه تسميةُ ”المُلك العضوض“، عندما خاطبَ مُعاوية بنُ أبي سفيان جيشَه في صفِّين، وهو يستعدُّ لقتال الإمام عليّ بن أبي طالب، قائلاً، بين أُمورٍ أُخرى: ”وقد كان من قضاءِ الله أن ساقتنا المقاديرُ إلى هذه البقعة من الأرض، ولفَّتْ بيننا وبين أهلِ العراق.“ ثمَّ تلا قولَه تعالى ”ولو شاءَ الله ما اقتَتلوا، ولكنَّ الله يفعلُ ما يُريد﴾ (البقرة: 253).
وأدركَ مُعاوية، بعد أن استتبَّ له الحُكم، أنَّه يحتاجُ إلى التماسِ الشرعيَّة في الحُكم بعد أن اغتصبَه بالقوَّة، ففقدَ شرعيَّةَ الشُّورى التي أُسِّسَ عليها الحُكمُ في الإسلام. وهكذا فإنَّه لجأَ إلى التماسِ الشرعيَّةِ في القضاءِ والقدَر، وكأنَّ الله هو الذي قضى بسابقِ عِلمِه أن يتولَّى الأُمويُّون الحُكم. فخطبَ في أهلِ الكوفة قائلاً: ”يا أهلَ الكوفة، أتراني قاتلتُكم على الصلاةِ والزكاةِ والحجّ، وقد علمتُ أنَّكم تُصلُّون وتُزكُّون وتحجُّون، لكنّي قاتلتُكم لأتأمرَ عليكم وعلى رقابِكم، وقد أتاني الله ذلك وأنتم كارهون.“
وخطبَ بمناسبةِ تنصيبِ ابنِه يَزيد خليفةً له قائلاً: ”إنَّ أمرَ يزيد قد كان قضاءً من الله، وليس لِلعبادِ الخيرةُ من أمرِهم.“ ثمَّ ردَّدَ عُمّالُه هذا المبدأ، فقال زياد بن أبيه في خطبتِه المعروفة بـ”البتراء“: ” أيُّها الناس، إنّا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة، نسوسُكم بسُلطانِ الله الذي أعطانا، ونذودُ عنكم بفَيء الله الذي خوَّلَنا.“
كما قال مُعاوية بعد أن تمَّت له البيعة في المدينة: ”إنّي ما وليتُها بمحبَّة علمتُها منكم، ولا مسرَّة بولايتي، ولكنَّي جالدتُكم بسيفي هذا مُجالَدة.“ وأضاف: "إنَّني أردتُ أن أَتَّبعَ سُنَّةَ أبي بكر وعُمر، ولكنَّ نفسي نفرَت من ذلك نفارًا شديدًا... فإن لم تجدوني خيرَكم، فإنِّي خيرٌ لكم ولاية... وإن لم تجدوني أقومَ بحقِّكم كلِّه، فاقبلوا مني بعضَه...“
وقصَّةُ أَخذِ البيعة ليزيد مشهورة، تذكرُها كتبُ التاريخ. ومُلخَّصُها أنَّ معاوية بعد أن جمَعَ الناسَ ودعا الوفودَ من جميع الأمصار، في عام 55 هـ؛ قام يزيد بنُ المقفَّع خطيباً، فقال: ”أميرُ المؤمنين هذا“ مُشيرًا إلى معاوية، ”فإنْ هلكَ فهذا“ مُشيرًا إلى يزيد، ”فمَن أبى فهذا“ مُشيرًا إلى سيفِه. فقال له مُعاوية: ”اجلِسْ فإنَّكَ سيِّدُ الخطباء.“
وعندما تُوفِّيَ مُعاوية، خطبَ ابنُه يزيد قائلاً: ”الحمدُ لله الذي ما شاءَ صنَع، ومَن شاءَ أعطى، ومَن شاءَ منَع، ومَن شاءَ خفَض، ومن شاءَ رفَع. “ 25 كما جرى توظيفُ الحديثِ النبَويِّ لِدَعمِ وجهةِ نظرِ الأُمويِّين، فقالوا إنَّ الله لا يُحاسبُ الخلفاءَ لأنَّه هو الذي جعلَهم أُمراء، ووضعوا حديثًا مَفادُه ”إنَّ الله تعالى إذا استرعى عبدًا رعيَّةً كتبَ له الحسنات ولم يكتبْ له السيِّئات.“ وذُكِرَت أحاديثُ أُخرى، منها أنَّ ”من قام بالخلافة ثلاثةَ أيَّام لم يدخل النار.“ وقال مُعاوية: ”قد أَكرمَ الله الخلفاءَ الكرامة، أنقذَهم من النار، وأوجبَ لهم الجنَّة، وجعلَ أنصارَهم أهلَ الشام.“ وخطبَ هشام بنُ عبدِ الملك حين وَليَ الخلافة فقال: ”الحمدُ لله الذي أنقذَني من النار بهذا المقام.“ ويُقال إنَّه جمعَ أربعين شيخًا شهِدوا له أنَّ ما على الخُلفاء حسابٌ ولا عِقاب.
ويُشير الشيخ علي عبد الرازق إلى أنّ ”الخلافة في الإسلام لم ترتكزْ إلاَّ على القوَّة الرهيبة، وأنَّ تلك القوَّةَ كانت، إلاَّ في القليلِ النادر، قوَّةً مادِّيةً مُسلَّحة.“ ويُذكِّرُنا، بين أُمورٍ أُخرى كثيرة، بالطريقةِ التي فرَضت البيعةَ ليزيد بنِ مُعاوية المذكورة آنفًا، ثمَّ يُشيرُ إلى ”استباحةِ يَزيد لدَمِ الحُسَين ابنِ فاطمة الزهراء، بنتِ رسولِ الله (ص)“، وكيف ”انتهكَ حُرمةَ مدينةِ الرسول“، وكيف ”استباحَ عبدُ الملك بنُ مروان بيتَ الله الحرام ووطئَ حِماه.“
كما تذكرُ كتبُ التاريخ أنَّ عبدَ الملك بنَ مروان ارتقى مِنبرَ رسولِ الله (ص) في المدينةِ المنوَّرة، وقال قَولتَه الشهيرة: ”واللهِ لا يأمرُني أحدٌ بتقوى الله بعد مقامي هذا إلاَّ ضربتُ عُنقَه.“
كما حكمَ العبَّاسيُّون استنادًا إلى مبدإ ”الإرادة الإلهية“. خطب أبو جعفر المنصور قائلا: ”أيُّها الناسُ إنَّما أنا سلطانُ الله في أرضه، أسوسُكم بتوفيقِه... وحارسُه على مالِه، أعملُ فيه بمشيئتِه وإرادتِه وأُعطيه بإذنه.“
وهكذا، ومنذ أن تحوَّلَ الحُكمُ إلى ”مُلكٍ عَضوض“، بعد الخلافةِ الراشدة، تداولَ السلطةَ الملوكُ الذين حكَموا بقضاءِ الله وقدَرِه. وتوطَّدَ هذا المفهومُ أكثر عن طريقِ تبريرِ الفُقهاء للمُلك العَضوض تحت ذريعةِ ”دَرءُ المفاسدِ مُقدَّمٌ على جَلبِ المصالح“، و”مَن اشتدَّت وطأتُه وجبَت طاعتُه،“ حتَّى قال قائلُهم:
وطاعةُ من إليه الأمرُ لـَـزْمٌ وإن كانوا بغاة ًفاجرينا
وتُصوِّرُ أبياتُ دِعبِل الخُزاعيّ هذا الوضعَ الاستبداديَّ المتواصِل:
الحمد لله لا صبرٌ ولا جَلدٌ ولا عزاءٌ إذا أهلُ البِلى رقدوا
خليفة مات َلم يحزنْ له أحدٌ وآخرٌ قامَ لم يفرحْ به أحدُ
فمرَّ ذاكَ ومُــــرُّ الشؤم يتبعُه وقامَ هذا وقام النحسُ والنَـكدُ
ويقول أبو بكر الخُوارزميّ في وصفِ سيرةِ حاكم: ”فما زال يفتحُ علينا أبوابَ المظالم، ويحتلبُ فينا ضَرْعَ الدنانير والدراهم، ويسيرُ في بلادِنا سيرةَ لا يسيرُها السِّـنَّورُ في الغار، ولا يستجيزُها المسلمون في الكفَّار، حتَّى افتقرَ الأغنياء، وانكشفَ الفقراء، وحتَّى تركَ الدِّهقانُ ضيعتَه، وجحدَ صاحبُ الغلّةِ غلَّتَه، وحتَّى نشفَ الزرعُ والضَّرع، وأُهلِكَ الحرثُ والنسل، وحتَّى أخربَ البلاد، بل أخربَ العِباد، وحتَّى شوَّق إلى الآخرة أهلَ الدنيا، وحبَّبَ الفقرَ إلى أهلِ الغنى... والله ما الذئبُ في الغنَمِ بالقياسِ إليه إلاَّ من المصلحين، ولا السّوس في الخَزِّ في الصيف عنده إلاَّ من المحسِنين.“
وأستدركُ فأقول إنَّ ذلك الظلمَ والقهرَ يُصاحبُه إغداقٌ كبيرٌ على العُلماءِ والشعراء، فقيل في ذلك: ”يَهبُ الأمير ما لا يملك.“ لذلك ازدهرت العلومُ والآداب بل ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية بوجه عام. ونحن هنا لا نبحث هذه النقطة لأن بحثنا ينصب على تعوّد العقل المجتمعي العربي على الاستبداد والقهر حصراً.
ومن جهة أخرى، يقول أحمد أمين إنَّ الخُلفاءَ ”على الجملة نهَّابون وهَّابون.“ أمَّا قُضاةُ بعضِ الخُلفاء، فحدِّثْ عنهم ولا حرَج.
قال بديعُ الزمان الهمذانيّ في وصفِ أحدِ القُضاة: ”يا للرجال وأين الرجال؟ وليَ القضاءَ مَن لا يملكُ من آلاتِه غيرَ السِّباب، ولا يعرفُ من أدواته غيرَ الاختذال! وما رأيُك في سوسٍ لا يقعُ إلاَّ على صوفِ الأيتام، وجرادٍ لا يسقطُ إلاَّ على الزرعِ الحرام، ولصٍّ لا ينتقبُ إلاَّ على خزانةِ الأوقاف؟“.
ولئنْ طفقَ المتنِّبي يُدبِّجُ القصائدَ العصماءَ في مَدحِ سَيفِ الدولة، فإنَّ هذا كان ”ينهبُ الناسَ ويُصادرُ أموالَهم ليمنحَها للمتنبِّي وأمثالِه، فيصوغون له قلائدَ المدح، فينطبقُ عليه الحديث ’ليتَها ما زَنتْ ولا تصدَّقتْ.‘ وكان قاضيه يُسهِّلُ له كلَّ مَظلمة حتَّى قال يومًا: ’من هَلَك فلِسيفِ الدولة ما ملَك.‘(انطر المرجع السابق).
ويقول الجابريّ: ”إنَّ التاريخَ العربيَّ لم يعرفْ قطُّ ظاهرةَ الصراع من أجل الحدِّ من سلطةِ الحاكمِ الفَرد أو فرضِ قيودٍ أو رقابةٍ عليه“... ”ألم يُضطرَّ الفقهاءُ في كلِّ عصرٍ من الإفتاءِ بجوازِ توليةِ المفضولِ على الأفضل؟... أمَّا الخروجُ على الإمام فقد تجنَّبوا الإفتاءَ به بدعوى اتِّقاءِ الفِتنة.“ ومن هنا جرى ترسيخُ روحِ الاستسلامِ ومبدإ ”ليس بالإمكان أحسنُ مِمَّا كان،“ أو بالأحرى الاستسلام للقضاءِ والقدَر ومشيئةِ الله، بغيةَ تعزيةِ النفسِ ومُصالحةِ الذات للقبول بالأمر الواقع.
ومع اعترافِنا الكامل بالجانبِ المشرِق للتاريخِ العربيِّ الإسلاميّ، وإكبارِنا له، فيجبُ أن لا نغفلَ بحثَ الجوانبِ المعتمِة منه أيضًا. وقد أسهَبنا في الشرحِ وتثبيتِ بعض الحقائقِ التاريخيَّة المُرَّة، لأنَّنا غالبًا ما ننسى أو نتناسى هذا الجانب، ونتمسَّكُ بترديدِ الجانبِ المشرِق والمعروف، وبذلك نفشلُ في تفهُّمِ إشكاليَّتِنا، وتشخيصِ أدوائنا، بعقلٍ فاعِلٍ لا مُنفعِل.
وفضلاً عن كلِّ ذلك، فقد تفاقمَت خصائصُ الاستبداد خلال فترةِ الانحطاطِ والسيطرةِ العثمانيَّة، مع وجودِ فتراتٍ تتميَّزُ بقَهرٍ أكثر أو أقلَّ نسبيًّا، حتَّى وصلنا إلى عصر الاحتلالِ الغربيِّ في العصرِ الحديث، ثمَّ الحُكم الوطنيّ الذي ظهرَ أنَّهُ أدهى وأمرَّ من عصرِ الاحتلال، أحيانًا، وخاصَّةً في العراق، الذي كان يُمثِّلُ أهمَّ مركزٍ للحضارةِ العربيَّةِ الإسلاميَّة.
وهكذا فإنَّ هذه الأوضاعَ الاستبداديَّة استمرَّت على نحوٍ أو آخَر حتَّى اليوم، على وجهِ العموم، في معظمِ أجزاء العالَمِ العربيِّ والإسلاميّ. لذلك يلجأ الإنسانِ العربيِّ المظلوم إلى الإيمانُ بالقضاءِ والقدَر، وتسليمُ أمرِه إلى الله تعالى باعتبارِ أنَّ الدنيا فانية وأنَّها جسرٌ للآخِرة، والعاقبةُ للصابرين والمتَّقين.
ولمَّا كان العقلُ المجتمعيُّ يُمثِّلُ ذاكرةَ الأُمَّة ومُحصَّلةَ ظروفِها وتاريخِها، فإنَّه يُصبحُ في هذه الحالة مشحونًا بهذه القيمة (القضاء والقدَر)، إلى جانبِ قِيَمٍ أُخرى متعدِّدة. بَيدَ أنَّ القِيمَ المتفوِّقة، أي التي تؤَثِّرُ في الوحدةِ المجتمعيَّة أكثرَ من غيرها، خاصّةً بسببِ طولِ الفترةِ التي توالت فيها الأحداثُ والظروفُ المُفضِية إلى هذه القيمة، أقولُ في هذه الحالة، تظهر تلك القيمة (أي القضاء والقدَر) في سلوك أعضاء المجتمع بقَدرٍ أكبر. ويُمكنُ أن نُفسِّرَ ذلك بأنَّ العقلَ المجتمعيَّ يُشبهُ، إلى حدٍّ بعيد، العقلَ الباطنَ بالنسبة للفرد، بموجب مدرسةِ التحليل النفسيّ، كما ذكرنا سابقًا. فهو يخزنُ التجاربَ المختلفة. ولكنَّ التجاربَ القاسية والمتواصلة، خاصَّةً في فترة الطفولة، تُؤثِّر في سلوك الفرد أكثر، وتظهرُ بأشكالٍ مختلفة، وقد تُشكِّلُ عُقدًا نفسيَّة أو سلوكيَّاتٍ مرَضيَّة معيَّنة. ويُمكنُ مقارنةُ طفولةِ الفردِ بتاريخ المجتمع البشريّ أو طفولتِه، وقد لاحظنا بعضَ ملامحِه التي توحي بتغلُّبِ فكرةِ القضاءِ والقدَر على العقلِ المجتمعيّ وبالتالي على العقلِ المنفعِل للفردِ، العُضوِ في ذلك المجتمع.
وهكذا فقد أوضحنا آنفًا كما في بحثِنا الموسَّع المعنوَن بـ”حالُ العربِ في المهجر“أنَّ القهرَ الطويلَ الذي تعرَّضَ له الفردُ العربيُّ خلال تاريخِه الماضي ظلَّت آثارُه ترافقُه حتَّى بعد أن انتقلَ إلى المهجر، حيث توافرَت له سُبلُ حرِّيةِ التفكيرِ والتعبيرِ والنشرِ والتجمُّع والتنظيمِ السياسيّ، والتصويتِ الحرّ، أي جميع الحرّيات الأساسيّة التي كان يفتقدُها في وطنِه الأُمّ. ومع ذلك نجدُه يكاد يكونُ مشلولاً، في الغالب، حتَّى في حالِ تعلُّقِ الأمرِ بحقوقِه ومصالحِه في المهجر، فضلاً عن مصالح ومُعضلاتِ وطنِه الأُمّ. فهو لا يُشارك، على الأغلب، في الانتخاباتِ العامَّة أو المحلّيَّة، ولا في الاجتماعات والتظاهرات العامَّة، ونادرًا ما يُناقشُ أو يعترضُ على الآراءِ المُتجنِّية على العربِ والمسلمين التي تحفلُ بها وسائطُ الإعلام الأمريكيَّة خاصَّةً. لذلك نجدُ المنظَّماتِ العربيَّة والإسلاميَّة ضعيفة في أمريكا، ونلاحظُ أنَّ اللوبي العربيّ معدوم أو هزيل جدًّا، بالمقارنة مع سواه، مع أنَّ العربَ والمسلمين يعدُّون حوالى ستَّة ملايين في الولاياتِ المتَّحدة، حسب معظم التقديرات، وعلى الرّغم من أنَّ جماعاتٍ كبيرة من العرب الذين يعيشون في أمريكا هم من المتعلِّمين.
والسببُ في هذا التقاعس، كما أرى، هو أنَّ التعرُّضَ الطويلَ للقَهرِ والاستبداد الذي مرَّ به المجتمعُ العربيّ أدَّى إلى أن يألفَ الفردُ ذلك القَهر. ولا يحدثُ ذلك من خلال ما يتعرَّضُ له الفردُ من قَهرٍ في حياتِه فحَسب، بل ما تعرَّضَ له آباؤه وأجدادُه خلال الأجيالِ السابقة، لأنَّ ذلك الفردَ يتأثَّرُ بالقِيَمِ الراسخةِ والمتوارَثة التي تُشكِّلُ نسيجَ ذلك العقلِ المجتمعيّ السائد (أي العقل العربيّ والإسلاميّ في هذه الحالة، مع إمكانِ تعميمِ هذه القاعدة على أيِّ عقلٍ مجتمعيٍّ آخَر، وذلك في خصائصَ أُخرى مختلفة؛ وهذا بحاجةٍ إلى بحثٍ يخرج عن موضوعنا). فالعقلُ المجتمعيُّ يحتفظُ بهذه الخاصِّـيّة (القهر)، لِكونِها تُصبحُ جزءًا فعّالاً من ذلك العقلِ المجتمعيّ الذي يُؤثِّرُ بدورِه في ”العقلِ المنفعِل“ للفردِ العربيّ.
وهكذا يتحوَّلُ إلى قَهرٍ داخليّ مُعشِّش وُمتشعِّب ومُتجذِّر في أعماقِ الذاتِ العربيَّة، يصعبُ جدًّا الفكاكُ منه حتَّى لو تحرَّرَت منه من الخارج. لذلك لم يتمكَّن العربُ من الاستفادةِ من حرِّيتِهم في المهجر إلاَّ القليلَ النَّزر، خلال عشرات السنوات الماضية.
وهنا أُعيدُ إلى الأذهانِ مثالاً ذكرتُه في كتاباتٍ سابقة: الطيرُ الذي يولَدُ في القفَص يتعذَّرُ عليه التمتُّعُ بحرِّيتِه، بل يعجزُ عن الطيرانِ إذا أُطلِقَ سراحُه، ويظلُّ حائرًا متردِّدا كيف يتصرَّفُ بحرِّيتِه، ثمَّ يسعى إلى العودةِ إلى سجنِه (قفَصِه) الأبديّ، لأنَّه يُشكِّلُ بيتَه الوحيد، وعشَّه الذي ألفَه منذ ولادتِه. وقد جربت ذلك مع بعض من طيور الحبّ التي كنت أعتني بها في فترة سابقة.
ومن جملةِ الشواهدِ على وجودِ هذا القَهرِ الكامن والمغروسِ في العقلِ المجتمعيِّ العربيّ، وبالتالي العقل الفرديّ، أنَّ الجيلَين الثاني والثالث وما بعدهما، من الجالية العربيَّة في المهجر، تكون أقلَّ تهيُّبًا وتحفُّظًا، بل أكثر عقلانيَّةً وتقحُّماً ونشاطًا سياسيًّا أو اجتماعيًّا. وسببُ ذلك، كما هو واضح، أنَّ أبناءَنا وأبناءَ أبنائنا يتحرَّرون من سلطةِ عقلِهم المجتمعيّ الأصليّ وينتقلون إلى التأثُّرِ أو الخضوعِ للعقلِ المجتمعيِّ الجديد تدريجيًّا. هذا العقلُ الذي يرتبطُ بالتطوُّراتِ التي حدثَت في المجتمعِ الغربيّ، خاصَّةً خلال القرونِ الثلاثةِ الماضية، لاسيَّما في ما يتعلَّقُ بحقوقِ الإنسانِ وحرِّيته ومسؤوليَّتِه، في الوقتِ الذي كان فيه المجتمعُ العربيّ خاضعًا لجميعِ أصنافِ الاستبدادِ والقَهرِ والاستغلال، سواءٌ من الداخل (الحاكم المستبدّ)، أو من الخارج (المستعمِر الأجنبيّ).
* * *
خاتمة
خلاصةُ القول إنَّ العقلَ المجتمعيَّ العربيَّ السائد ميَّال، بوجهٍ عامّ، نحو التواكل والاستسلام (لا تُفكِّرْ، لها مُدبِّر). والسببُ في ذلك، كما لاحظنا، أنَّ العقلَ المجتمعيَّ العربيّ المعاِصر متأثِّرٌ بوجهٍ خاصّ بالجوانبِ المتخلِّفة من ماضي الأُمَّة، جانبِ القَهرِ والاستبداد، الذي استمرَّ، منذ أربعة عشر قرناً تقريبًا، أكثرَ مِمَّا هو متأثِّرٌ بالجوانبِ الحضاريَّة من تاريخِها، كما ذكرنا سابقًا.
والمحصَّلةُ العامَّةُ النهائيَّة لحركةِ المجتمعِ العربيّ تنحدرُ نحو التراجعِ والتخلُّف، إن لم نقُلْ تنزلقُ نحو هاويةٍ ليس لها قرار، وذلك في جميع الميادين، كما تؤَكِّدُ تقاريرُ ”حال الأمَّة“ السنويَّة، التي يُصدرُها ”المؤتمرُ القوميُّ العربيّ“، والتقاريرُ السنوِيَّة التي أصدرَها مؤخَّرًا ”برنامجُ الأمَمِ المتَّحدة الإنمائيّ“ تحت عنوان ”تقريرُ التنميةِ الإنسانيَّة العربيَّة“.
وهكذا أرى أن هذا العقل المجتمعي العربي المتخلف يشكل السبب الرئيس لفشل مشروعُ النهضةِ الذي رفعَه رُوَّادُها منذ منتصفِ القرنِ التاسعَ عشَر، فضلاً عن فشلَ مشروعُ الثورةِ الذي رفعَه رموزُها منذ الخمسينيَّات من القرن الماضي. كما قد تفشل الثورة الأخيرة التي أطلق عليها صفة الربيع العربي، الذي تبدو عليه طلائع الخريف. ونحن نُرجِّحُ أنَّ من أهمِّ أسبابِ فشلِ مشاريعِ إنقاذِ ما يُمكنُ إنقاذُه من بقايا هذه الأُمَّة، كان وما يزال عقلَها المجتمعيَّ التراثيّ الذي أُعِدَّ للماضي ولم يُعدَّ للحاضِر ولا للمستقبل، وخاصَّةً فيما يتعلَّقُ بالإيمانِ بالقضاءِ والقدَر، الأمرُ الذي يؤَدِّي إلى اليأسِ من قُدرةِ الذاتِ على تحسينِ الأوضاع. وما لم نَسعَ لتغييرِ هذا الحال، من خلال تعديلِ وغربلةِ عقلِنا المجتمعيِّ التقليديّ، وبالتالي تعديل وتعقيل عقلِنا الفرديِّ المنفعِل بذلك العقلِ المجتمعيّ، بواسطة عقلِنا الفاعل، الذي اعتكفَ وتقزَّمَ منذ عشرة قرونٍ تقريبًا، فإنَّ جميعَ المحاولاتِ السطحيَّة والحركاتِ الإصلاحيَّة ستبوءُ بالفشَل، كالسابق.
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
مختارات
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
2111 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- قراءة في رواية ( في سبيل التاج )
- بيان من المجلس الوطني للمعارضة العراقية
- حظور الملك فيصل الثاني حفل تخرج إحدى دورات الكلية العسكرية الملكية العراقية
- تركيا تنفى طلب مخابراتها من بريطانيا حماية الرئيس السورى إثر محاولة اغتياله
- اسرائيل تكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال المرشد الايراني
- ثري إيراني متهم ببناء إمبراطورية عقارية في لندن لمصلحة نجل المرشد
- الحرب على إيران تشعل الأسواق العراقية تحسبا للحصار
- بذكريات الحصار .. أدوات التسعينيات "اللالة" و"الچولة" تعود إلى منازل العراقيين
تابعونا على الفيس بوك