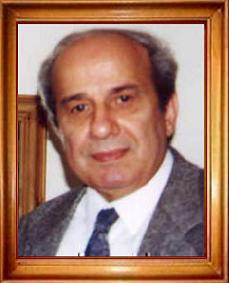بدون قضاء مستقل لا يمكن أن يستتب الأمن ويتراجع الفساد والإرهاب في البلاد
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 14 كانون2/يناير 2015 10:38
- كتب بواسطة: عادل حبه
عادل حبه
يُروى أنه في عقد الأربعينيات من القرن الماضي وفي خضم حريق الحرب العالمية الثانية، تصاعدت موجة الانتقادات في بريطانيا حول استشراء الفساد في الحكم الذي كان يقف على رأسه الشخصية البريطانية المعروفة وينستون تشرتشل زعيم المحافظين.
وقتها اجتمع رئيس الوزراء بمستشاريه وأطراف سياسية أخرى. واشتكى الجميع من تفشي الفساد في مفاصل الدولة. فطرح تشرشل عليهم السؤال التالي :"هل أن الفساد طال القضاء البريطاني؟؟". وكان جواب الجميع هو النفي، إذ أكدوا على أن القضاء نزيه ولم يطاله بعد هذا المرض الخبيث. عندها انبرى رئيس الوزراء وقال: لا تقلقوا فالدولة البريطانية بخير.
أورد هذا الحادث وأقارنه بحال قضائنا العراقي وما تعرض ويتعرض له من فساد وتسييس لصالح السلطة التنفيذية ونوازعها. فالقضاء العراقي ومنذ تأسيسه لم يكن سلطة مستقلة خلافاً لما نص عليه الدستور العراقي الأول، وكما يجري العمل به في الدول الديمقراطية على مبدأ فصل السلطات الثلاث. فالسلطتان القضائية و التشريعية عندنا كانتا على الدوام رهينة خاضعة لأهواء السلطة التنفيذية ومنافعها وبالتالي بعيدتان عن العدالة والنزاهة. فالقضاء كان يبصم على نتائج الانتخابات المزورة سواء في العهد الملكي أو لاحقاً في العهد الجمهوري وبعد ردة 8 شباط السوداء. كما تولت السلطة القضائية في بلادنا إصدار الأحكام الجائرة طوال عقود الدولة العراقية ضد الوطنيين طبقاً لإرادة الحكم وحماتهم من خارج الحدود. فهكذا وعلى سبيل المثال، تم الحكم بالاعدام على قادة الحزب الشيوعي ونفذ الحكم بهم في شباط عام 1949 دون أن يستند هذا الحكم الجائر على أبسط المبررات القانونية التي ينص عليها الدستور العراقي المعمول به آنذاك. فلم يقدم هؤلاء القادة على تدبير الانقلابات العسكرية، ولم يبادروا إلى تشكيل ميليشيات مسلحة كما تفعل بعض الأحزاب والقوى السياسية الآن، ولم يتم العثور على إطلاقة واحدة عند الإارة على مقرات الحزب. فقد مارس الحزب الشيوعي نشاطه سلمياً عبر المظاهرات أو تقديم العرائض، ومن أجل أهداف محددة هي صيانة استقلال البلاد وتأمين الحدود الدنيا من رفع الحيف عن كاهل الفئات الكادحة من شعبنا.
لقد جاء هذا الحكم الجائر تنفيذاً لإرادة السلطة الحاكمة التي وقفت ضد تحديث النظام السياسي وإرساء دعائم الديمقراطية في البلاد، وبضغط من حماتها في الغرب ضمن سياق الحرب الباردة التي اندلعت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. واستمرت ماكنة القضاء العراقي غير المستقل والتابع في إصدار أحكام ثقيلة ضد الآلاف من الوطنيين والوطنيات العراقيات في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل في إحداث سجناً خاصاً للناشطات السياسيات العراقيات. ولم يكتف حكام لعراق بذلك، بل راحوا يمارسون ظاهرة جديدة في العراق وهي المحاكم العرفية عند أول بادرة للاعتراض السلمي أو عند انطلاق أية مظاهرة احتجاج سلمية تخرج في شوارع العراق. فقد عُطلت المحاكم المدنية، رغم ما يعتريها من ثغرات جدية في العهد الملكي ومن عدم استقلاليتها، خلال فترة تقرب من نصف الفترة التي حَكَم بها الحكم الملكي العراق. ورافق ذلك إعلان الأحكام العرفية بما يزيد على 15 مرة.
ولم يتخل الحكم الجمهوري عن هذا النهج القائم على هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وسلب استقلاليتها بعد ثورة تموز، إلاّ لفترة قصيرة، حتى عادت "حليمة إلى عادتها القديمة". وجرى تسييس القضاء بما يخدم إرادة الحاكم، ليعود السجناء من جديد ليُحشروا في السجون بقرارات أصدرها القضاء العراق الذي كان يتلون حسب تلون مواقف الحكم وينفذ إرادته. واتخذت هذه الظاهرة شكلها الأبشع في ظل حكم حزب البعث بعد انقلابيه في شباط عام 1963 وفي عام 1986. فقد تعطلت حتى المظاهر الشكلية لاستقلال القضاء العراقي، وتحول القضاء إلى شاهد زور على ممارسات للحكم سواء في التفنن في الأحكام القاسية ضد معارضيه أو في التغطية على الحيتان الكبار ونهب موارد الدولة وعلى الفساد الذي راح ينخر في جسد الدولة العراقية وسحق كل القيم الايجابية في مجتمعنا. وتروي لي أحدى المحاميات العراقيات الفاضلات التي واكبت الفترة التي سبقت سقوط النظام في عام 2003، إلى أنه أصبح من الشائع آنذاك أن يتم تبرأة الجناة وتلبيس التهمة بضحايا أخرى لقاء الرشاوي التي كان يتلقاها بعض القضاة والمحامين على حد سواء. وقد أوردت هذه السيدة الفاضلة أمثلة على ذلك. وهكذا وبعد أن شاع هذا المرض الخبيث في جسد السلطة القضائية، وترسخت هذه "الثقافة" في المجتمع، فقدأصبحت الدولة العراقية مبتلات بأمراض خبيثة يتطلب جهوداً استثنائية وإرادة وطنية لشفائها. وقد انعدمت تلك الإرادة لدى الحكم آنذاك. وهكذا ولجت الدولة دهاليز الفساد ودوامته في كل شرايينها، بحيث لم يعد في استطاعة المواطن مراجعة أية دائرة من دوائر الدولة بدون أن يحمل معه "رزم" من الرشاوي لتمشية أيسط معاملة من معاملاته. وقد طال هذا الفساد جميع مؤسسات الدولة، وأخطرها . حيث انتشرت الرشاوي وبدأت تنخر في القوات المسلحة المسؤواة عن أمن البلاد والمواطنين، والتي أصبحت وسيلة لهروب الجنود والضباط وباقي أفراد القوات المسلحة من آتون المفامرات والحروب التي خاضها الحكم خلال سنوات تسلطه على رقاب العراقيين.
لقد تمنى العراقيون بعد تداعي النظام السابق أن يتم معالجة هذا " المرض العراقي" المزمن بشكل جدي. ولكن يبدو أن جذور هذه الممارسات قد تعمقت في مجتمعنا وبشكل خطير. فما أن تولى المسؤولين الجدد زمام الأمور، حتى أعادوا إحياء أو الإبقاء على نفس الأجهزة السابقة وتعايشوا مع نفس المرض السابق وقبلوا به وتحت رايات جديدة. فلم يحصل أي تغيير أو إصلاح في أجهزة الدولة وفي كل مرافقها وبضمنها المؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات الخدمية الإدارية، وفي المقدمة منها القضاء العراقي الذي وقف على رأسه رموز كان لهم دور في الترويج وشرعنة الانتهاكات الدستورية والقانونية في عهد البعث. كما لم يجر التخلي عن هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتحكم بها خلافاً للدستور الجدي وخلافاً لدعوات هؤلاء في التمسك بالقواعد الديمقراطية. وهذا ما عمق الفساد بشكل خطير، بحيث أخذ المواطن يلمس عواقب استشراء هذا المرض الخبيث ويستغيث ويطالب بالإصلاح بعد أن توفر له قدر من الفرصة في التعبير عن رأيه. ولكن كان الجواب سلبياً أو لفظياً دون فعل أوبطيئاً ومتعثراً وغير مجدي تمثل في تشكيل هيئات ولجان غير مستقلة في واقعها وخاضعة جميعها للسلطة التنفيذية مما عرقل أي مسعى جدي للقضاء على الفساد، بل زاد قوة، ومهد الطريق لتصاعد النشاط الإرهابي والنشاط المعادي للشعب العراقي. كل ذلك لأن الفساد قد عصف بأهم مرفق من مرافق الدولة التي يقع على عاتقها مراقبة هذا الفساد والمبادرة إلى تطويعه.
ولا نريد أن نعدد "شماءل" هذا الفساد وعواقبه والي باي الذي يهدد مصير البلاد ووجوده. بل نعود لنلقي الضوء على بضع أمثلة من ممارسات السلطة القضائية ودورها وحقيقة استقلاليتها. فبعد أن جرت لملمة نواة السلطة القضائية بعد سقوط النظام في عام 2003، تولت السلطة القضائية طبقاً لمسؤوليتها في البت في العديد من الجرائم والانتهاكات التي جرت في البلاد في ظل انهيار أركان الدولة. وكان من أول ما قامت به هو تسلم ملف التحقيق في قضية اغتيال المرحوم عبد المجيد الخوئي. ولكن هذا الملف اختفى في الأدراج بعد تدخل السلطة التنفيذية وإعمال نفوذ القوى التي تصدرت النشاط السياسي وذاب في أمواج المساومات السياسية بين الكتل التي تصدرت المشهد السياسي، ونتيجة لذلك تم اغتيال العدالة. هذا السلوك والقصور في مراقبة سير العدالة من قبل السلطة القضائية هو الذي فتح الطريق أمام موجة الاغتيالات التي طالت خيرة المفكرين والمهنيين والأطباء واساتذة الجامعات و والصحفيين وو...دون أن برف جفن للسلطة التنفيذية آنذاك. والقائمة تطول لو جردنا كل الانتهاكات التي تتحمل مسؤوليتها السلطات التنفيذية في الحكومة الاتحادية أو في المحافظات والإقليم. فقد شهد العراقيون كيف أن العديد من من المطلوبين للقضاءالعراقي قد تم الإفراج عنهم أو أنهم يسرحون ويمرحون ويمارسون نشاطهم ضد الدولة العراقية في محافظات أخرى أو سمح لهم بالخروج من العراق دون اتخاذ أبسط الإجراءات لاعتقاله، وليعودوا ويشكلوا عصابات الاجرام ليدقوا أعناق العراقيين الأبرياء.
ومن الغريب أن رئيس السلطة التنفيذية السابق كان يلوح مراراً في مجلس النواب أو في تصريحاته حول امتلاك ملفات ضد هذا وذاك، ولكنه لم يسلمها إلى القضاء العراقي لملاحقة المتهمين كما يفرضه الدستور العراقي، في حين كان هناك عدد غير قليل من المعتقلين يقبعزن في السجون جراء وشايات أو معلومات غير دقيقة من المخبر السري.
ولم تخل كل هذه الممارسات من هدف محدد يكمن في إبعاد كل من يتمتع بالنزاهة والخبرة والحرص على البلاد من ممارسة وظيفته في انتشال هذا البلد العزيز من مأزقه والخراب الذي لحق به. ولنا في قضية إحالة رموز عراقية وطنية نزيهة في البنك المركزي إلى القضاء كمثال واحد للحصر من جملة آلاف الأمثلة التي ترتكبها السلطات التنفيذية في حرمان الأيدي النزيهة والخبراء من خدمة البلاد والاستعانة بعناصر متخلفة أو ثيت أنها تتلاعب بمقرات الشعب. والأمثلة لا تخفي على المواطن العراقي ولا على القارئ الكريم. فقد حرى تعيين الشخصية الوطنية سنان الشبيبي ومظهر محمد صالح في منصبيهما في البنك المركزي بعد انهيار النظام السابق. وقاما بمعونة جمع من الموظفين النزيهين في البنك بعمل جبار تمثل في توفير احتياطي وغطاء للعملة العراقية في البنك بلغ حوالي 70 مليار دولار بعد أن "گشول" رموز النظام السابق آخر فلس في الخزينة المركزية قبل انهياره. إن ما قام به السيد سنان الشبيبي ومساعديه في البنك ترك آثاراً ايجابية في استقرار العملة العراقية بعد ذلك الانهيار الذي جرى في ظل النظام السابق، كما أضفى قدراً من الاستقرار على العملية الاقتصادية. هذا العمل لم يلق التثمين من السلطة التنفيذية آنذاك، وأثار الحيتان الجديدة في البلاد من أضراب القطاع الريعي والتجاري ضد سنان وزملائه، خاصة بعد أن رفض سنان الانصياع لطلبات السلطة التنفيذية التي غرقت في تبديد أموال الدولة. وهكذا عمدت الأخيرة إلى تحريك بيادقها في السلطة القضائية وفبركة الاتهام لطاقم البنك المركزي وإحالتهم إلى القضاء بتهمة "الفساد"؟؟. وفي آخر المطاف اتخذت الإجراءات وبسرعة تثير التساؤل، وتم إزاحة سنان الشبيبي ومظهر محمد صالح من منصبيهما والحكم على السيد سنان الشبيبي بالسجن لمدة سبع سنوات.
ولكن ما أن مرت الأيام وتغيرت الأحوال في السلطة التنفيذية حتى فوجئنا بتعيين السيد مظهر محمد صالح مستشاراً اقتصادياً لرئيس الوزراء الجديد!! بعد كل ذلك الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له هذا الإنسان النزيه. ثم سارع طاقم السلطة القضائية بعد التغيير الذي طرأ على السلطة التنفيذية نفاقاً بإعادة النظر في الحكم الصادر السابق ضد سنان الشبيبي وآخرين كما جاء على لسان رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وتقرر تبديل الحكم من سبع سنوات إلى الحكم ببراءة سنان الشبيبي لعدم كفاية الأدلة؟؟، أين هي الإدلة التي اعتمدتها المحكمة السابقة إذن. إن هذا القفز على الوقائع والتغيير المفاجئ إن دل على شىء فإنما يدل على خضوع السلطة القضائية لإرادة السلطة التنفيذية ، وإنه يدل على أن القضاء عندنا هو سلطة غير مستقلة خلافاً لما يشاع عن ذلك في دستورنا العراقي.
كما إن هذا السلوك والنهج القائم على الاستهانة بالقواعد الدستورية وعلى التنكيل بالأيادي النزيهة وتهميشها في بلادنا لا يؤسس لدولة مستقرة، بل دولة تتنازعها الأهواء والطوائف والقيم العشائرية البالية والدين المزيف الذي يشيعه "داعش" وأضرابها. ويجب أن لا ينتظر العراقيون الأمن والاستقرار والعمل الشريف ما دامت هذه العقلية في إدارة الدولة هي القائمة، ومادام جشع ونهم السلطة التنفيذية والمتنفذين فيها هو القاعدة في بناء مثل هذه الدولة الفاشلة.
13/1/2015
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
مختارات
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
622 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- برنامج ألأمثال البغدادية ( "يد وحدة ما تصفك" )
- النماذج الأصلية في اللاوعي الجمعي في مجتمعات شكسبير وموليير
- التعرض الجوي الامريكي / الاسرائيلي لاسقاط النظام الايراني / د.علوان العبوسي
- ١٧ رمضان .. يوم "الفرقان" الذي ثبّت أركان دولة الإسلام الأولى
- "أنا مسلم أكثر من كوني ملاكما"!
- كيف تغيرت سياسات إسبانيا الخارجية من حرب العراق إلى إيران؟
- هل طلبت إيران أسلحة من روسيا؟ الكرملين يجيب
- الموساد: لا يهمنا من سيتم اختياره مرشداً.. مصيره مكتوب لدينا مسبقاً
تابعونا على الفيس بوك