ألإنسان بين عقله وقلبه
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 23 أيلول/سبتمبر 2016 15:13
- كتب بواسطة: يعقوب أفرام منصور
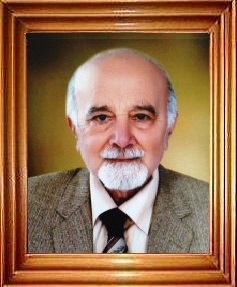
يعقوب أفرام منصور -أربيل
يتميّز الجنس البشري ، من بين أنواع المخلوقات الحيّة، بكون أفراده الإنسانيين يمتلكون العقل الذي هو مصدر التفكير.
ولما كان التفكير على مستويات متباينة لدى الأفراد، تبعًا لمدى تأثّرها برغبات القلب وأهواء النفس القصيّة عن العقل، وتبعًا لما يستمدّه التفكير من (العقل الكبير) من صواب وحكمة وفضيلة، أو نقيضهما : خطأ وجهل ورذيلة، إذا كان (العقل صغيرًا)، فالخلائق التي تعمل في مراحل حياتها وفق الأفكار المستمدّة من عقولها بلا توقّف أو إستكانة، تكون عقولها عقولاً مُنتِجة؛ أمّا نقيضها العقول التي تعطّل أصحابَها عن التفكير، فتؤدّي بأصحابها أن يصيروا غير نافعين في الحياة الإجتماعية. وأناس لا جدوى منهم في مثل هذه الحياة، يغدون بلا قيمة في الوجود الحضاري، وربما يغدو نفعهم في المجتمع في مجال الإضرار به. فالمخلوق الذي لا ينفع ولا يضرّ في المجتمع يُمسي بلا قيمة في هذه الحياة. والفرد الذي لا يفكّر في ناحية أو حاجة نافعة، أو لا يفكّر في غرض أو عمل ضار، يكون حتمًا فاقد العقل أو خامله، لعدم استعماله، لأن البارئ الذي أوجد العقل في الكائن البشري، إنما كان الغرض منه أن يستعمله مالكُه في تدبير شؤون حياته ودوره في الكينونة على الوجه الأمثل والأنفع للحياة الأجتماعية على هذه البسيطة، أي أن يكون فردًا نشِطًا متحرّكًا، وليس جامدًا، خاملاً، حتى لو كان تحرّكه ونتاجه في مجالات الضرر. ولكن لماذا يلجأ إلى الإضراروالإيذاء، إن كان لا يروم أو لا يستطيع النفع والإفادة؟ فهل يصحّ أو يليق بكائن بشري ، وهبه البارئ نعمة حيازته على العقل ليصبح كائنًا مُهمَلاً ؟ وهل الكائن المهمَل بين الأنام مصيره غير النبذ والرفض والإزدراء وعدم الإحترام ؟ لذا يجدر بالكائن الإنساني أن يكون ذا شيء له قيمة أو جدوى في هذه الحياة الأرضية. فإن كان نافعًا لمجتمعه أو للبشرية، أضحى وسيلة فاعلة في ميدان ما، وإن كان مُؤذيًا وضارًا لمجنمع ما أو للبشرية ، بات الناس يخشون أذاه وضرره، ويعرفون فيه إنسانًا مفكّرًا في جوانب الشر وصانعًا له، ويحتاطون على أنفسهم من أذاه، ويتخذون الحذر منه.
غير أن العقل أحيانًا يميل أو يخضع، في اتخاذ قراراته واختياراته، لنوازع القلب المجانبة للحِجى الصرف ـ مصدر التفكير والفطنة ـ تبعًا للأمزجة والثقافة والرواسب القديمة المتخلّفة عن قِيم وتقاليد تسودها العواطف كالحب والكراهية والإنحياز والشجاعة والتهوّر والحماسة والطمع، فهذه كلها مصدرها القلب وليس العقل المفكّراالذي يفرز التبصّر والصواب، والنائي عن مؤثّرات النزعات والأهواء.
لكن الله تعالى ـ إذ منح الإنسان عقلاً كي يفكّر به ويستعمله في الإستشارة والإرشاد، وليس ليعطّله ويُبطِلَ مفعولَه ـ أمره وأوصاه، من خلال الرسائل السماوية في الكتب المقدّسة، أن يكون في الحياة الإجتماعية عضوًا نافعًا، وذلك من خلال ما أبان له من سبل الرشاد والخير، وسبل الضلال والشرّ، تاركًا له حرية الإختيار بوساطة التفكير بعقله أن ينتهج سبل نفع البرايا، وجلب الخيرات إليهم، وتحاشي انتهاجه سبل الإضرار بهم واجتلاب الشر وارتكاب السوء نحوهم. فضلاً عن ذلك إن القوانين الوضعية تدعم هذه الشرائع السماوية.
لذا يتجلّى مما أسلفت أن التفكير صار منذ البدء، ويبقى إلى المنتهى فريضة شبه مقدّسة واجبة على الفرد الإنساني السويّ؛ فهو إن فكّر وأصاب بتفكيره السليم المستقل، في ضوء الوصايا الإلاهية والشرائع المدنية، إكتسب فضيلتين : فضيلة التفكير وفضيلة إدراك الصواب، في حين إذا فكّر فقط بدون أن يصيب، فهو حينئذٍ يكون قد إكتسب فضيلة واحدة هي فضيلة التفكير.
يتبوأ المفكرون الأعلام، ألذين أوردت صفحات تاريخ الأمم والحضارات، منزلة طلائع الأمم المتمديِنة، إذ هم الذين يفكّرون في قضايا صالح أممهم وأوطانهم، ويرسمون لها سبل تحقيق التقدّم والإرتقاء، ولنا في مفكّري الإغريق ومفكّري الموسوعيين الفرنسيين، ومفكري ألمانيا وإيطاليا وأمريكا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ومفكّري النهضة العربية في منتصف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشربن حتى أوساطه خير مثال للتدليل على تلك المنزلة الطلائعية للمفكّرين الحاذقين الألبّاء المخلصين.
لا مشاحة أن إختلاف رأي المفكّرين في أمّة أو شعب لهوّ طبيعة بشرية مألوفة، لكن إختلافها الطويل أو الدائم في شأن المصير يؤدّي إلى النكسات وربما إلى الضرر والهلاك، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ عبد الله زكريا الأنصاري في كتابه ( خواطر في عصر القمر) 1976 بشأن (التفكير والمفكرون) : " ويلٌ للأمّة التي لم يُجمع مفكّروها على رأي، لا سيّما إذا كان الرأي يتعلّق بالمصير." إذ ثمة حالات يكون فيها إختلاف الآراء مفيدًا وضروريًا، ومؤدّيًا إلى الفلاح والنجاة، تقابلها حالات يكون فيها إختلاف الأفكار والآراء مُؤذِيًا يؤدّي إلى الخسران والشقاء والبوَار.
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
مختارات
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1372 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- طرائف "رمضانية" من التراث العربي / صيام ... بالنيابة!
- بريطانيا تعرض آلاف الدولارات على مهاجرين مقابل العودة لبلادهم
- يوم المرأة العالمي : ما أصله و كيف سيحتفل به هذا العام!؟؟
- مسلسل_عمر - الحلقة ١٩
- رقصة الموت
- قراءة في رواية ( في سبيل التاج )
- بيان من المجلس الوطني للمعارضة العراقية
- حظور الملك فيصل الثاني حفل تخرج إحدى دورات الكلية العسكرية الملكية العراقية
تابعونا على الفيس بوك




















































































