ألجنس البشري عند مفترق الطرق
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 03 تشرين1/أكتوير 2016 08:19
- كتب بواسطة: يعقوب أفرام منصور
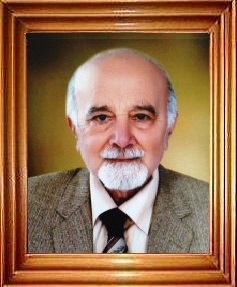
يعقوب أفرام منصور-أربيل
عام 1948 ـ أي بعد ثلاثة أعوام من نهاية الحرب العالمية الثانية ـ نشرت (مكتبة المفكّر) اللندنية كتابًا عنوانه [ ألإنسان سيّد مصيره ] للكاتب أرشيبالد روبرتسون.
وبمناسبة صدور عملي الجديد في كتاب (ألأماني والأهواء بين الدين والدنيا) في كانون الأول 2015، واشتماله على مقالات وبحوث تمتّ بصلة إلى عنوان هذا المقال ومواضيع مضامينه، منها مقالاتي : العالم الذي نتمناه ـ البلاد المحجوبة ـ الإنسانية والمجتمع ـ ألأنانية قاتلة الحب ـ وبحثي " تقنيّة السلاح ومستقبل الإنسان"، شئتُ أن أنقل من الفصل الأول من كتاب (روبرتسون) ، المعنون [ ألجنس البشري عند مفترق الطرق ] معظم الأفكار والآراء في مواضيع كتابه، المشابهة لمضامين كتابي، والمخالفة لها أحيانًا.
في مطلع الفصل الأول، المذكور عنوانه في أعلاه، ورد إن الغرب قد غدا في حيرة بعد دحره أشرس تآمر على حضارته وقيَمِها، ومع ان حقيقة كون الغرب نفسه قادرًا على قهر المؤآمرة يُثبت كون الغرب غير مفلِس ماديًا أو معنويًا، يبقى الإعتقاد بأن الإنهزامية تتنامى بمقدار غير يسير. إذ يعمّ الإرتياب إنْ كان في مقدور الإنسان هيمنته على القوى المادية التي وجب وجودها لأجل الحياة، سواء أكانت تلك القوى غير مقدّرٍ أن تُدمّره ،أو أنّ قرعة ناقوس مُنذِرة بكارثة الحضارة لم تُقرَع بعدُ.
فالناطقون بدين معترَف به، يقولون في هذا الصدد، إنهم خلال القرون الأربعة المنصرمة كانوا سائرين في المسلك الخاطئ، إذ إن فكرة [ جعل الإنسان سيّد الأشياء ] وجعل [ الحياة على الأرض سعيدة للجميع ] كما يُقال لهم إنها فكرة خاطئة وشرّيرة تمامًا. فكما قيل لهم إن الصورة العلمية للكون هي نصف الحقيقة في أحسن الأحوال، وفي أسوأ الأحوال هي تضليل، وكما قيل لهم إن الحقيقة الجذرية بشأن الإنسان هي كونه إنسانًا ساقطًا، عاجزًا وحَدَه عن إدراكه الحقيقة أو فِعل الصحيح. فأنانيته علّة كل رزايا العالم، إذ يعجز عن البدء بكونه غير أناني، ويفعل الصحيح بدون (نعمة الله) التي بشأنها يُجاز للناطقين بدين مُعترَف به أن يتحدّثوا.
كي يعلم أبطال معركة بريطانيا، وحركات المقاومة في أوربا والعلَمَين وستالينغراد وسواحل نورماندي وهجمات الصواريخ أن مصائب العالم ناجمة عن أنانيتهم، يبدو ذلك أمرًا مُهِينًا لغير المؤمنين، كما يبدو سُخفًا لِمن يُراد إعلامهم بأن رأس الحكمة يكمن في الخضوع لتعليم دين مُعترَف به. فإذا كان الكل في أوربا وأمريكا قابلين وطيّعين للتعليم المسيحي، فإن فُرَص نجاتنا ونجاتهم من دمار حرب قابلة لن تغدو أكبر مما هي الآن (1948)، بل دونها حتمًا. فسبل النجاة المنشودة لا تقوم على قبول تلك التعاليم والعقائد وتطبيقها والبرهنة على صحتها، ولا على ملاحظة أسلوب [ " مبدإِ هادٍ " في الإيمان والمناقب ]، بل تعتمد على تدريب تفكيرنا، وتفهّم العالم طبيعيًا واجتماعيًا، وعلى تعلّمنا السيطرة عليه وفق هذه المناداة:
أخي، أخي، إستخدم ذهنَك !
تعلّم التفكير، قبل ان تقضي نحبك !
أخي، أخي، تحوّل لمواجهة اليوم !
أخي، أخي، إرمِ عنك أصفادك !
إن الجنس البشري على مفترق الطرق، لكنّ الخيار ليس بين الأنانية واللاأنانية. فأغلبنا تقريبًا قد تدرّبنا منذ الصغر على الخضوع للآخرين، وخلافًا لذلك نكون غير محتمَلين، بيد انّ اللاأنانية لا تكفي. لأن التعساء، الذين أرسلهم ( هتلر) إلى الهلاك في ثلوج روسيا وصحارى أفريقيا، لم يمضوا إلى حتفهم بباعث من الأنانية. ألخيار هو بين فوضى عالم ما قبل المرحلة العلمية، حيث الإنسان لا يحاول تفهّم عالمه والسيطرة عليه، بل هو يتقبّل توجيهات الكهنة والحكّام، بكونها تتجاوز إدراكه وسيطرته عليها، وبأن واجبه الخضوع لمشيئة الله ـ كما يفسّرونها هم ـ وبين نظام عالم قائم على أسس علمية حيث يستخدم البشر وسائل المعرفة والقوة والتعاون والتهذيب التي طوّرها الإنسان ليُهَيمن على مصيره. لذا ينبغي الخيار في نواحي الإقتصاد والسياسة والدين والفلسفة والقانون،وقد عالج الكتاب ناحيتَي الدين والفلسفة. وإذا أشار أحيانًا إلى نواحٍ أخرى، فلأن كل ناحية لا تخلو من تأثير في الناحية الأخرى. ففي الدين والسياسة ينبغي التخيّر بين الإيمان بوجود الخالق، الذي يؤدّي إلى صيغةٍ من دين سلطوي، وبين عدم الإيمان بوجود البارئ. فالمسألة بالتالي هي : في أيّ شكل من عالم نحيا، إذ عليه يُبنى تحديد معيار الحقيقة.
لدى الأناس الإعتياديين، لا تظهر مشكلة في تحديد معيار الحقيقة، فعندما يؤدّي شاهدٌ ما قسَمًا في المحكمة بكونه مطابقًا للحقيقة، فهو عارف ما متوقّع منه، ألا وهو الإدلاء بالحقائق التي يعرفها، وبما أن المحاكم دليلها الأحكام الصائبة الحصيفة (أي معيار الحقيقة الشائع لدى العقلاء)، فجميعنا نستخدم الحكم الصائب في أعمال حياتنا اليومية، ونطبّق هذا بدقّة على فهم وسيادة الطبيعة، لنسمّي ذلك (عِلمًا)، لكن العلم ليس طقسًا دينيًا، بل هو شيء يستطيع إستيعابه إيّ فرد مستعد لبذل الوقت الوافي لإجادة تقنيته. نتائج العلم مذهِلة أحيانًا، لكنها واضحة لكل صبور يتابع الخطوات المؤدية إليها، وتتجسّم خلال معيار الحكم الصائب الحصيف للحقيقة. غير أنه عِبر تاريخ الفلسفة، كان ثمة نزعة دائمة للإستخفاف بالحكم الصائب الحصيف، إذ شاع القول بأن الحواس خدّاعة، وبأن ملَكات الإنسان العقلية فاسدة، وبأنها لا تكشف عن سوى محتوى عقله، وبأن شاهدها مناقض، وعنت هذه الأقوال وجود وسائل أخرى لبلوغ الحقيقة: الإلهام أو الحدس الباطني الصوفي أو الرمزي، أو عن سبيل عقلٍ مَحض مستغنٍ عن الحواس والأدلّة المقبولة قانونيًا. ومهما كانت هذه الوسائل الفُضلى جليّة، فهي غير متّسعة للأناس العاديين الذين عليهم أخذها آنئذٍ من غير تحقّق أو برهان ـ أي ممن يدّعون إحتيازَها. وعَودًا إلى " المبدأ الهادي" ـ الآنف ذكره ـ نجد أن سيطرة الإنسان على الطبيعة آخذة في الإزدياد، وأن الإمكانية تكشف إمتداد تلك السيطرة نحو العمليات الإجتماعية التي قد زاغت عن السيطرة حتى الآن، فالصارخ يضاعف الصياح بأن معرفة الناس للطبيعة مُضلِّلة، أو ضارّة إلى حد تدمير البشرية حتمًا، إلا إذا أذعنَا إلى موزّعي الإلهام المتخصّصين.
هذه موعظة مثابِرة إنهزامية ذات عامل فعّال في زيادة الحَيرة التي تترعرع البشرية على أرضها، فصعاب تكييف مؤسساتنا الإجتماعية والسياسية طبقًا للعالم الجديد الذي خلقه العلم والصناعة، لهي صعاب جليّة، لكن إذا فُهمت وعُولجت بروحيّة علمية، فلن تكون عصيّة على الحل. فالدعاوة التي تستثمر تلك المصاعب لبث التشخيصات والعلاجات الزائفة، وتواصل انتقاص وشتم العلم، تستحق التعامل معها بكونها رتلاً خامسًا أخلاقيًا وثقافيًا.
وفي سياق مواضيع الكتاب يتم فحص معيار الحقيقة الذي إليه يحتكم العلم والدين على التعاقب، وفحص الأسباب المؤدّية إلى تفاوتهما، والإسهامات التي قام بها كلٌ منهما، وإمكانية المُتوقّع منهما لقولبة العالم العصري، وحل معضلاته. إن الفحص المذكور والمنشود سيثبت أن إتهامات الإفلاس الخلقي والثقافي ، الموجّهة إلى الإنسانية العلمية من قِبل ناطقي الأديان ترتد على مبدعيها، وآنئذٍ ستتمكّن البشرية من اختيار سبلها، والسير قُدمًا بثقة. والمواضيع المراد فحصها هي: ألبحث عن اليقين ـ تحدّي الإنسان نظريًا ـ تحدّي الإنسان عمليًا ـ إدّعاء الكنيسة ـ الثورة والتطوّر ـ حرب الإيديولوجيات ـ المُخادع متورّط في وضعٍ حرِج.
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
مختارات
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1348 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- طرائف "رمضانية" من التراث العربي / صيام ... بالنيابة!
- بريطانيا تعرض آلاف الدولارات على مهاجرين مقابل العودة لبلادهم
- يوم المرأة العالمي : ما أصله و كيف سيحتفل به هذا العام!؟؟
- مسلسل_عمر - الحلقة ١٩
- رقصة الموت
- قراءة في رواية ( في سبيل التاج )
- بيان من المجلس الوطني للمعارضة العراقية
- حظور الملك فيصل الثاني حفل تخرج إحدى دورات الكلية العسكرية الملكية العراقية
تابعونا على الفيس بوك




















































































