تيه الجنوب - صفحات القسم الثاني من ثنائية حفل رئاسي / ج٣
- التفاصيل
- المجموعة: ثقافة وأدب
- تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 18 نيسان/أبريل 2024 08:38

تيه الجنوب - صفحات القسم الثاني من ثنائية حفل رئاسي / ج٣

سأترك وطني هذا، تاريخي، حاضري، مستقبلي.
سأهرب من نفسي، ومن كوابيس تقلق منامي.
من محنة أبقت في داخلي شرخاً، مثل شق أحدثه زلزال.
من قناعات بحاضر أمة تَبينَ زيفه ومستقبل لها، سطرهُ الحالمون في كتب لا تُقرأ، وقالوا عنه بعض حكايات تبين أنها وهمٌ، ومحض خيال منفر.
من رفقة سياسية فيها السباق للوصول على كرسي قائم على قطع الرقاب.
من نفسي كي لا أعثر بها، فَيُحسب العثر خطأً متعمداً لتدنيس الأرض، يعيدني بسببه صديقي الرئيس الى السجن ثانية، حيث لا خروج منه بعفو يأتي بساعة رحمن، ولا بمكرمة تحل في ساعة يغيب فيها الشيطان.
عبارات قلتها حال جلوسي على السرير بعد الاستفاقة من الكابوس، وأكملتها بأخرى جاءت للتأكيد على عهد أقطعه على نفسي في هذه الليلة التي كاد چاسب يقتلني فيها، خلال حلم عابر في منام كان متقطعاً مثل التيار الكهربائي الذي بات يأتي متقطعاً في أيام الحرب هذه. لكنها لم تتنبه، وكأن عقلها شردَ منها الى عالم آخر، فمسكتُ يدها وأكملت قولي، من أن هذا القرار لا مناص عنه، ولا أخفي سراً من أن فكرته راودتني منذ أول ضربة تلقيتها في باحة السجن، وقد تَركت على جبهتي جرحاً، أقنعني تحسس الدم النازف منه، أني ما زلت موجوداً على قيد الحياة. فكرة انطبعت في مخيلتي مثل نقش على حجر. كانت ضربة أعادني على اثرها رفاقي محمولاً على أكفهم إلى زنزانتي، أبقوني محصوراً بين جدرانها الصماء، وقد أمحت العصا الغليظة مخزون ذاكرتي، إلا ما يتعلق منها بالانتقام. من ذاك اليوم وانا قلق حد الهياج من فكرة الموت التي أضحت في نظر الرئيس والسجان، لا تعدو أن تكون قضية اعتيادية، وفي نظري أشباح شياطين بلا ملامح واضحة، يسمعوني حكايات الانتظار لموجة تعذيب تدفع آخرين لأن يكونوا من بين الموتى. لقد تحولت الفكرة هذا اليوم الى قرار أصرُ على تحقيقه، تفادياً لاحتمالات العود ثانية الى عالم الموتى والأشباح.
سأهرب. لا سنهرب معاً وإن كان دفعاً الى المجهول. ولما تنبهت الى شرود عقلها كان الصباح قد هل، وكان صقاع الديكة يتعالى، وتبين أنها منشغلة بقراءة سورة الفاتحة وبعض آياً من القرآن لتطرد عني الكوابيس.
وضعت رأسي على صدرها الحنون، أتخيل المجهول وطناً بلا حزب يقتل أبناءه، ولا رئيس يتفيأ بظل الاله.
رفعت رأسي قليلاً، نظرت من شباك الغرفة المطل على السماء بفضائها الواسع، كانت هناك أسراب طائرات للحلفاء تغطي سماء بغداد، وهناك أسراب أخرى تغطي أماكن أخرى من هذا الوطن الجريح.
تابعت تلك التي قصدت بغداد بنظرات أحستني وكأنها أسراب نسور جارحة، جذبتها الى أجواء العراق رائحة الموت التي نشرتها الحرب في كل مكان، فاعتصرني وجع المقت، وزاد في داخلي شدة الدافع على تنفيذ فكرة الهروب.
قلتُ بلعاب متجمد:
ـ سأنفذها وإن كانت تقتلعني من جذوري، وأهلي ومن وطني العليل، مثل اقتلاع السدر المعمر من مكانه، لا يمكنني الآن استبدال فكرتها بكل متع الدنيا.
كانت الرؤيا من الشباك واضحة، السماء واسعة منفتحة لهذه الأسراب المحلقة بلا وجع، ملائمة لأولئك الطيارين الذين تسيدوا وحدهم أجواء بلاد خسرت الحرب قبل دخولها، خسروها بشماتة ملأت نفوسهم بمن أراد الحرب مجداً له شخصياً، وأرادوها هم خسارة له كي يتخلصوا من أمجاد يريد بناءها وهماً على أكتافهم.
الطيارون أو لنقل النسور، يمعنون في الغل حتى العظم، فقللوا من ارتفاعات تحليقهم بالتدريج، لتصبح مرئية لأهل بغداد بوضوح، وكتبوا بعوادمها كلمة النصر (v) كناية لهزيمتنا، وزيادة في الاذلال، ثم انسحبوا بتشكيل النسق، نسور حومٍ شبعت لتعود أخرى من دون عناء في التعرف على المكان. آلاتهم الحديثة تدلهم على المكان وإن كان علَيّقَة وسط صحراء أو بئر جف منه الماء. قالت:
- لِمَ لا تحاول النوم بعد طلوع الصباح حبيبي وقد أرهقك السهاد.
- لا أريد النوم ونصف أوصالي مقطعة من الداخل، ونصفها الآخر منشغل بهموم الطريق الى ذاك المجهول.
- أرجو أن تخفض صوتك خشية إيقاظ البنات من نومة الصبح التي يحبون.
- لقد تعودت الكلام بصوت عالٍ في اللحظة التي دق فيها چاسب قلم الرصاص في إذنيَّ عمداً لتمزيق الطبلة يوم كنت نزيلاً في الزنزانة الرقم (5)، تلك الزنزانة الذي اعتاد الذباب الصفير في ربوعها حد القيئ، في أوقات الظهر القائظ على وجه الخصوص. ها هو ألم التمزيق يعاودني الآن. وكذلك رائحة الدم كأني أشمها، هي الرائحة ذاتها عندما لم يسمح چاسب آنذاك بمسح الدم النازف من بعض شرايينها، لكي يتفرج على حالي النزلاء الآخرون في ذهابهم الى حمامات الصباح ويتعظوا.
..............................
عدت الى البيت مبكراً، فالدوام في الدائرة التي أعمل بها ودوائر الدولة الأخرى مرتبك جداً، بسبب القصف الجوي الذي بدأه الحلفاء على بغداد وبقية أنحاء العراق في حرب خليجية يقولون عنها الثانية، ويقول عنها الرئيس أُم المعارك، سعياً منه لإعطائها قيمة معنوية تدفع العسكر الى الموت بلا ألم، ويكسب هو المجد دونما عناء، هو هكذا وقادته أيضاً، يعطون لمعاركهم سيماء ذات وقع على السامعين، وإن كان بعضها خاسراً. إنهم لا يعترفون بالخسارة، كل عمل يقومون به مضمون ربحه، يقوي الأمة، يعيد بناءها موحدة من جديد، شعارات يعتقدون أن السامع قد صدقها، ويعتقد السامع أنهم صدقوا وهمَ صدقٍ لم يحصل أصلاً.
لقد بلع الطعم، قُلتَها ونظرت الى من حولي، فوجدت الحبيبة وأربع بنات في ريعان الشباب وطفلتين، كأنهن جميعاً يرغبن الاستفسار عن العبارة المبهمة ومجريات الحال، لكني أغلقت باب الاستفسار بالالتفات اليهن طالباً التهيؤ للخروج من بغداد التي تنعق في سمائها الغربان. ومع هذا الغلق المتعمد من جانبي أدرَكَتْ هي بذكائها الفطري حلول وقت الرحيل الى المجهول.
نظرتُ اليها في هذه اللحظة الحرجة من الحياة، كانت أشبه بالضائعة، تتحرك في المكان. تأخذ شيئاً ما، فتتركه الى غيره لتعود اليه. تفتح خزانة ملابسها لتأخذ منها ثوباً ثم تعيده الى مكانه، وكأنها لم تعد بحاجه اليه. تدخل المطبخ لإعداد وجبة غذاء سريعة، ثم تتركه لتعود الى خزانة الملابس، كأنها نسيت نوع الغذاء الذي ذهبت لإعداده. لم يكن الحال ارتباكاً، لا يمكن تسميته ارتباكاً، بل كان قلقاً يؤشر حصوله كثر التحرك في المكان وشدة النسيان.
مَسحت دمعةً نزلت غصباً قبل اكتشافها، لا تريد إظهار ضعفها أمام البنات، فالمشوار طويل، ومليء بالمفاجئات من العيار الثقيل. وهي منشغلة ومرتبكة، تتكلم مع نفسها كلاماً غير واضح، فَتحتُ أنا المذياع قبل أن ينقرض، وخشية هذا الانقراض أبقيتهُ مفتوحاً لأتابع أَخبار العراق في صوت أمريكا، أتنقلَ منها الى الاذاعة البريطانية، ثم مونت كارلو، أرى أنها جميعاً قد اتفقت في الرأي على أن العراق دخل أتون الفوضى، ولن يخرج منها سالماً. فعاودتُ تكرار عبارتي السابقة "لقد بلع الطعم".
وضعتُ في مخيلتي رسم الحدود مع إيران، ومعلومات جمعتها عن انتقال غالبية القطعات العسكرية المدافعة عنها قبل أشهر الى الكويت لتشارك في صنع المجد. أظن سهولة عبورها، وأظن المجازفة في مجالها ليست عالية، آخذاً في الاعتبار وضعاً يزداد ارتباكاً، بإصدار الرئيس أوامره للقطعات المدافعة بالانسحاب فوراً من داخل الكويت، الدولة التي حسبها قبل أشهر محافظته التاسعة عشرة، بما يناقض أوامر سابقة له بعدم الانسحاب وإن جاءت مذيلة باسمه شخصياً، الأمر الذي زاد من وتائر الفوضى وانكسار المدافعين، وأوقف العسكر على أطلال حدودهم، يذرفون الدمع من وجع الانكسار بعد أن صَيَّرهم الزمن أو صَيَّرَ عيونهم دامعة بسهولة. وها أنا الآن وفي هذا البيت الذي أسعى الى تركه، والتوجه صوب المجهول بتّ أذرف الدمع معهم حسرةً على العراق، وخوفاً من الانكسار في الطريق الى المجهول، أنعصرُ ألماً من شدة الاحساس بالانفصال عن بلاد أحببتها، كأني أجتاز وإياهم خط الحدود وخزاً بحراب العدو، فصحتُ من وجع النفس "لعنة الله عليه"، صيحةً لم يفهمها الموجودون. ولكي أتجنب صيحة أخرى تضعفني أمامهم، سحبت نفسي أو سحبني عقليَّ الباطن الى ذكريات اتهامي بالمشاركة في مؤامرة قيل دبرها محمد عايش.
هززت رأسي من بطلان دوافع الاتهام، وقبل التمتع بفرصة هدوء، بادرتني أُم شيماء بالسؤال عن لفحة اصفرار غزت عموم جلدي المكشوف، وعن حبات عرق تناثرت بغزارة على وجهي الحزين.
لم أجب، وبدلاً عن الاجابة سحبتُ نفسي الى قعر الذاكرة البعيد، بتّ أقلب أقنيتها وعيناي مفتوحتان، كأنهما اندفعتا الى خارج محاقهما، واصطبغتا بلون الدم الذي يكاد يعميني. قلبتُ وقَلبتْ، حتى َشَلَّ كثر التقليب خلايا عقلي فأصبحت لا تستجيب، وكأنها شاخت قبل الاوان، فعاودت الكرة ثانية، لكي أبعد اليأس عن خطوط دفاعي، فجاء المشهد الذي ظهرتُ فيه عصر أحد أيام الصيف في سجن أبو غريب، لا أدري أي صيف، أتذكر فقط أنه كان صيفاً، وكان المسؤول عن قاطع السجن هو چاسب، وكان أن ابتسم فيه لأول مرة، تعجبنا من هذه الابتسامة التي شبهها حليم مثل نور ساطع من السماء، لكنه وبعد لحظة ودون أي سبب انقلب الى حيوان بائس، غاضب من شيء ما، وقد اكتسى صوته بنبرة عداء عندما ناداني بكنيتي "أبو صماخ" طالباً مني بصيغة الأمر الفوري أن أتجه الى أنبوب حديدي ممدود من زاوية الشباك الخاص بغرفة الخفراء، الى حافة البناء المؤدي الى الحمامات. ثم قال:
تعلق بكلتا يديك، أيها الحقير الباقي على قيد الحياة وسط أكوام الموتى.
قالها وهو يغزني من مؤخرتي عندما قفزت سريعاً دون تفكير بماهية الأمر، اذ لا أستطيع أنا ولا غيري من الرفاق السجناء، التأخر عن التنفيذ حتى لو كان الأمر خطوة واضحة باتجاه الموت.
تعلقت وَحْمَيديْ السجان الضخم بوزن يزيد عن المائة والعشرين كيلوغراماً، وطول يقترب من المترين، يقف "ببسطاله" المليء بالقاذورات على أصابع يديَّ التي أمسكت بالأنبوب المذكور، يضغط عليها بثقل حسبته أطناناً من برادة حديد، ليقدم جسدي مرتعشاً مثل سعف النخيل الى سالم السجان الواقف في الأسفل، ليضرب بأنبوب مطاط "الصوندة" على أصابع قدميّ. كان الضرب شديداً وقاسياً ومتواصلاً، لم أعرفه من قبل في عموم حفلات التعذيب التي سبقت.
ما بك سألت حبيبتي؟. كأنك لا تقوى على الوقوف.
فأجبت:
- لا. ليس هناك من أمر يستحق القلق، شعرتُ بقليل من الرعشة في جوفي، سأجلس على هذه الأريكة، أرتاح قليلاً. أكملوا أنتم جاهزية الرحيل.
جلست منهك القوى، كأن وقع الضرب يحدث هنا والآن، وفي أثناء جلوسي استمر شريط الذكريات، المصحوب بألم استحضار الانفعال المكبوت فاعلاً، حتى أحسست وجعاً وكأن دبوس قد غُرزَ تواً في أصابع قدميّ، بعد أن استحضر العقل الباطن، صور الضرب المتكرر على جذر الأظفر لإبهام قدمي اليمنى، حتى خرج من مكانه، وتلك الكلمات التي وجهها چاسب الى سالم ليزيد وقع الضرب على الابهام الاخر لقدمي اليسرى لاقتلاع اظفره أيضا.
كان سالم وحشاً في تكراره الضرب على جذور الأظافر، وكان چاسب حيواناً في اشتهاء فريسته مخضبة بالدماء. لقد دام المشهد وقتاً كان طويلاً، لا يمكنني تذكر مقاديره، لكنه طويل جداً، وكان الوجع يتحول فيه من القدمين عندما يرفع سالم خيزرانته استعدادا لإسقاط الضربة الاخرى الى رسغ اليدين التي تسحق أصابعها ضغطاً من حْمَيدي ذاك الحيوان الواقف فوقها من الأعلى، ليطال مفاصل الكتف التي تمزقت بعض أوتارها، وتمددت مثل رقبة مظلوم التهمته ماكنة الشنق. كان حفلاً خاصاً، هُم يسمونه الحفل، ونحن نسميه البرزخ، فيه حميدي فناناً في الضغط، وتحريك (البسطال) نحو اليمين والشمال، وچاسب الذي يتفاخر من أنه يسبق مراجعه الكبار بإماتة سجنائه، يطلب المزيد من الضغط، شَرِهاً لم يَشبع غريزته في الايذاء حتى سقوط آخر اظفر من أصابع القدمين وامتلاء المكان بدماء اسودت من فرط الغيظ.
عاوَدتْ هي السؤال عن حالي وشدة الاصفرار، وعاودتُ نكران تعرضي لأي شيء، وطمأنتها حبيبة، بات وجودها القوي ضروري لإنجاح الغوص في جنبات المجهول. أخذتها جانباً، لا أريد أحداً يسمع شيئاً مما أقول. همست بملاءمة الظرف السائد للمجازفة في معاقرة المجهول الذي انتظرته طويلاً.
سألتها عن رأيها في تحقيق الحلم الذي سبق أن أخبرتها عنه من قبل، أجابت بالثقة ذاتها:
- إني والبنات معك الى الموت.
- لا يا عزيزتي لا تطرقي على مسامعي سيرة الموت، لأريده لكم. ما أريده الانتقال وإياكم الى حياة بلا عذابات، حياة من نوع آخر لا توجد فيها تهم ولا افتراءات، ولا تصفيق آثم للرئيس. أذهب بكم بعيداً الى عالم بلا نفاق. سألتني:
- عن ماذا تتكلم؟. وكأنك تهذي، وهل الوقت مناسب لتحقيق الأحلام في ظروف لم يعد فيها أحد يعرف نفسه أو مصيره؟. فأجبت:
- انه ملائم، بل هو الوقت الملائم، إذ وعندما تختلط الأمور ويتوه القوم، ولم يعد أحد منهم يعرف نفسه، يقل التركيز علينا، وتختفي عيون الرقابة، وينتقل الجهد لحماية أنفسهم من عاديات الزمان. ألم تلاحظي كم يحب كبيرهم نفسه، وكم يخاف الموت؟. يمكنك معرفة هذا بسهولة من خلال أرتال الحمايات وإجراءات الأمن التي يعدها في تنقله والسير، ومن مقادير الشك في نفس له أضناها الشك.
للراغبين الأطلاع على الجزء الثاني:
https://www.algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/thaqafawaadab/62186-2024-02-10-11-31-02.html
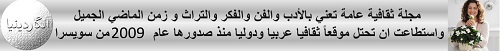
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1211 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- مسؤولون أميركيون: خياراتنا في إيران استهداف أفراد أو تغيير النظام
- مسلسل_عمر - الحلقة السابعة
- رمضان في العراق .. مائدة عامرة بطقوس متوارثة ونكهات لا تغيب
- طرائف "رمضانية" من التراث العربي
- كركوك في ذاكرة المؤسسات: إصدار تاريخي جديد للباحث نجات كوثر أوغلو
- الاعتزاز بالموروث الحضاري: وعي الذات وأصالة الانتماء في ذاكرة المدن.
- كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة الام اللغة الكوردية: بين مجد الهوية وخطر التهميش
- كيف يوقف صيام رمضان عجلة الشيخوخة؟
تابعونا على الفيس بوك




















































































