أَيــامُ أَبــي (سيرة .. وذكريات) ح٥
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 25 كانون2/يناير 2017 20:06
- كتب بواسطة: د.عبدالستار الراوي
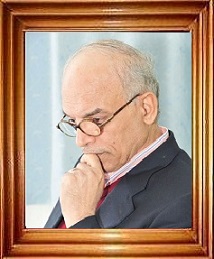
د.عبدالستار الراوي
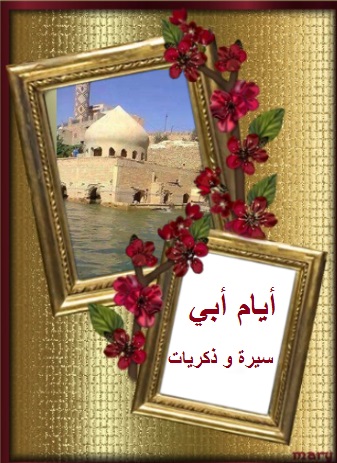
ايام أبي الحلقة الخامسة
وقائع الخدمة العسكرية
(1935 – 1939)
[1]
حين بلغ عزالدين الثامنة عشرة سيق إلى تجنيد عانة. حيث تقرر إلحاقه بمعسكر الوشاش(١ ) في بغداد لأداء خدمة العلم الإلزامية بوصفه جندياً مكلفاً.
وعندما حان موعد السفر إلى العاصمة، كان على عز الدين الذي لم يعتد مغادرة راوة أو السفر البعيد عنها إلا مرة واحدة في حياته أن يعاني من مشاعر مختلطة، بين التوق إلى بغداد التي سمع عنها كثيراً واقترب منها يوماً في رحلة تجارة (الأغنام) إلا إنه لم يرها، وبين مشاق الاغتراب عن الأهل والمرابع والأقران.
يقول أبي:
"... كان مشهد الوداع مؤثراً. مليكة توصيني بنفسي خيراً، وأن أرسل (خطاً) ( ٢) فور وصولي، وأبو أمين – مطني العساف- يعانقني ويذكرني بأن لا أنسى أن أبعث (مكتوباً) عن أحوالي ويحملني سلاماً حاراً إلى أخته فتحية وخالي جبير والأولاد.
ودعت الصحب والناعور، والفرات، وبيت دخيل، وارتقيت مفازة الجبل وانحدرت إلى (الشعبة)، ومن شاطئها عبرت بـ (الزورق) إلى عانة، ووجدت حافلة البريد ( ٣) في موقفها المعهود في (رأس الغربي)، واتخذت مكاني فيها.
بدأت الرحلة في ذلك صباح شتائي شديد البرودة، بدا الطريق طويلاً، وأنا كالتائه بين الهواجس والخواطر، ولا يقطع هذه الفوضى النفسية إلا محطات الاستراحة، فقد نزلنا في حديثه وهيت، واستبدلنا حافلة البريد بأخرى في الرمادي، ووصلنا بغداد. قبيل المغرب، حيث أنزلتنا الحافلة في كراج خزعل العاني ( ٤) بمنطقة علاوي الحلة ومضيت إلى بيت خالي في الرحمانية ( ٥) قبل أن ألتحق بمعسكر الوشاش. ولم يكن في جيبي إلا ديناراً واحداً وصرة ملابسي.
[2]
يقول عز الدين: التحقت في اليوم التالي بمعسكر الوشاش، في البداية واجهتني وزملائي الجند الآتين من القرى البعيدة معضلة ارتداء ما لا عهد لنا به الملابس العسكرية، وبشكل خاص البنطال والحذاء الثقيل – البسطال- الذي يزن رطلاً، فوجد في البداية صعوبة في نقل خطواتي، ولكن مع مرور الوقت ومضي الأيام اعتدنا عليها، بل كان يجب علينا أن نتكيف معها، تلاحقنا أوامر رئيس العرفاء، وهو يتوعدنا بالثبور وعواقب الأمور إن أخطأنا أو تجاهلنا النظام.
بوق القيام، كان بمثابة الإعلان الأول للقيام والنهوض، والجند كل منهم يستعجل صاحبه، لئلا يتأخر عن موعد التدريب، الذي كان في الأيام الأولى للخدمة عنيفاً ومرهقاً، ولكنني تقبلت مشاقه في كل الأوقات والفصول، فقد أمدتني تجربة (المدادة) بخبرة تحمل التعب المر والعمل العنيف، وزودتني بطاقة جسدية ونفسية مكنتني من تحمل الأعباء والالتزام بالواجبات. أمضيت في الوشاش حوالي أربع سنوات، كانت خدمتي العسكرية طوال هذه الفترة موضع تقدير زملائي، كما حظيت باحترام الآمربن ، وكان الرئيس (النقيب) أحمد فؤاد فارساً يحب الخيل حباً شديداً فعهد إليّ شخصياً برعاية حصانه الأصيل (أجود).
وبمرور الوقت وتوالي الايام أصبحت قادرا على قيادة (أجود) وتعايشنا معا آنست بوجود هذا الكائن النابه، وشغفت به، وتعلق بي، حتى تعود كل منا الآخر، وأصبح هذا الحصان شغلي الشاغل، إذ كان علي الاعتناء به، نظافة وتدريباً.
وكنت أقوم بتدريبه (أخبه) كل يوم في أوقات العصاري، فامتطي صهوته، واختال به في شوارع وطرقات الكرخ، كان فطناً وذكياً، ناعماً، جميلاً، أحمر اللون، يخب الأرض بشمم وكبرياء.
وكنت في أيام الجُمع والعطل الرسمية أطوف به علاوي الحلة والرحمانية، وساحة الشهداء وخضر الياس. ثم نأتي النهر فيرد الماء. وفي فصل الصيف ننزل معاً الشط فنعوم معاً.
وبمرور الأيام اكتشفت في (أجود) خصائص نبيلة، فهو كائن نابه لمّاح، أحاوره بلغة الإيماءات يفهمني وأفهم طباعه ومزاجه. وكان مفرط الحساسية، شفيفاً، فحين كنت انقطع عنه وتطول الغيبة بيننا، تراه منكفئاً على نفسه، عزوفاً عن الطعام. وما أن يلمحني مقبلاً حتى يثب، فيجيء إلي، وكأني ألمح في عينيه عتاباً وشوقاً، فأعانقه وأقبل غرته البيضاء.
إنه يتحدث ولكن بطريقة اللفتة، النظرة، الحركة، صار ( اجود) صديقي المفضل، أمضيت بصحبته أيام العسكرية، حتى أصبح الكائن الأقرب إلى نفسي.
[3]
حين ينأى الطريق فإن المسافة تتباعد بين الكلمات، لكن الليالي وحدها هي التي تتحد وتتكثف، فيصير الانتظار وكأنه دهر بلا نهاية أو حدود، هكذا وجدت نفسي وحيداً غريباً، وأنا أرقب أخبار أهلي التي انقطعت فجأة عني، فلم يعد بوسعي إلا أنْ أمّني النفسَ بـ (خطٍ) أو (مكتوب) يبدد وحشة قلبي.
وحين تنقطع الأنباء أو تتباعد أخبار راوة، فإني لا أجد أنيسا أقرب إليَّ من الحصان الأصيل (أجود) ، يخفف عني أوجاع الغربة ومفارقة الديار ، والآن ونحن في سنة 2004 كما يقول عز الدين، وعقب مرور ما يقارب الستين عاماً على فراقي لـ( أجود)، فلا يزال هذا الصديق الجميل يحتل جزءاً من وجداني وذاكرتي، إلى جوار رفقتي الآخرين:
- عبد الحميد إبراهيم
- نوري أرحيم
- ساكن الجلعوط
- محمد الكرحوت
[4]
خلال خدمتي العسكرية في معسكر الوشاش جربت الدخول إلى (سينما قدري) بدافع الفضول الدخول لاكتشاف ما هو غامض ومجهول وكذلك لإلحاح الصحبة والأصدقاء. لكني لم اطل المكوث حتى نهاية الفيلم . فخرجت من السينما فراراً أبحث عن الهواء، إذ لم أطق القاعة المغلقة كما استوحشت الظلمة الثقيلة؛ بحيث أحسست بانقطاع أنفاسي، فغادرت قاعة العرض أبحث عن الحرية والضوء والاتساع.
[5]
قررت أن أمنح نفسي تجربة الرغبة الحرة، فملأت عيني وحواسي الأخرى بصخب بغداد ولياليها الزاهرة فكانت التياترو (الملهى) إحدى المتع الأثيرة ووجدت في مرابعها، ما لم أره في حياتي فالغناء والرقص، الطبل، والمزمار. أصوات تملأ المكان والناس هنا يتمايلون يميناً وشمالاً، وظفرت وصحبي القرويون بعدة ليال في تياترو (الفارابي) وتياترو (الجواهري) في منطقة الميدان، وقد اعتاد الجند الدخول سويا فنمضي السهرة أو (التعلولة) مساء الخميس، وعند انتصاف الليل، نعود نتسلل إلى معسكر الوشاش لنهجع في عنبر النوم.
[6]
بوسع الذاكرة أن تستعيد فصول مغامرة الملاهي الليلية، فقد كدنا نحن القرويون الخمسة نسقط أرضاً، فقد أصبنا بصدمة تشبه الزلزال، إذ كادت المفاجأة تقتلع قلوبنا.
نحن الآتون من قرية زادها الإيمان والتقوى، لم يرّ أيّ منا قبل اليوم امرأة حاسرة الرأس، عارية الصدر، ولم تلتقط العين القروية قط مثل هذه المشاهد شبه العارية.
فزينة المرأة وفقا للثقافة الدينية السائدة تكتمل بحيائها، واحتشامها، أما الذي شهدناه في (الملهى) فيبدو غريباً وعجيباً، فالدهشة عقدت ألسنتنا ، وكان كل منا يتفرس في وجه صاحبه ذاهلاً، وعلى لسانه سؤال محيّر هو: ما الذي يجري هنا ؟ أشهد أنني ورفقتي الآخرين بعد أنْ ترددنا على (التياترو) أربع أو خمس مرات كنا نلوم أنفسنا عقب العودة إلى معسكر تحت وطأة الإحساس بـ (المعصية). على أن أيّاً منا لم يطأ حراماً، وقررنا في تلك الليلة أن تكون آخر عهد لنا بـ (التياترو). ورفعنا أيدينا بالدعاء أن يغفر الله ( آثامنا) عن الليالي التي ترددنا خلالها على الملهى.
[7]
يقول أبي ؛ في أيام صباي كنت أسعى إثر الصوت الرخيم، أياً كان الأداء، ترتيلاً أم غناء. وظلت هذه الهواية تلازمني حتى الآن، فليس هناك أجمل من النغمة الشجية التي تبعث في الروح الغبطة والمسرة، وحين نزلت بغداد، كان صوت حضيري أبو عزيز (٦ ) هو الصوت الأثير إلى نفسي، فقد شغفت به حباً وإعجاباً، وولعت بأغانيه ومواويله، وقد سحرتني أغنية:
"عمي يا بياع الورد.. كلي الورد بيش .. كلّي ..
بالك تدوس على الورد وتسوي خله كلّي.."
وقد أصبح حضيري أبو عزيز ميقاتاً ثابتاً في كل يوم خميس أترقب قدومه بلهفة شديدة، فما إنْ ينتهي الدوام، وننصرف من معسكر الوشاش حتى أعدو إلى الشارع على عجل ومن ورائي القرويون الأربعة وهم يحاولون اللحاق بي إلى (مقهى ناصر حكيم) ( ٧) في علاوي الحلة، نجلس نحن الخمسة على تختين متقابلين، نهز رؤوسنا طرباً. ونحن ندور مع (الاسطوانة) ونردد "عم يا بياع الورد كلي الورد بيش كلي".
ومن الغريب أن تبقى كلمات هذه الأغنية تطوف بخاطري إلى اليوم وقد تخطيت الثمانين، وكأني استشعر الأجواء الندية لكلمات حضيري أبو عزيز لأيام الشباب الأولى، التي تشرح الصدر بإيقاعها وأدائها.
وأتذكر الآن تماما ونحن في عام 2005ً، بأننا كنا نطلب بصوت واحد أن يعيد صاحب مقهى ناصر حكيم ( "القوانة") ( ٨) مجدداً، بمجرد أن تنتهي دورة الأغنية، لنجدد المتعة ولنواصل مسراتنا. وما بين دورة وأخرى يتعين على زبائن المقهى احتساء – استكان – جديد من الشاي.
[8]
تتوالى يوميات الجندية بين الواجب العسكري والتدريب على السلاح ، وصحبة صديقي الحصان (أجود) ، ورفقة القرويين الأربعة، والتردد على مقهى ناصر حكيم، ونزولي الرحمانية لزيارة بيت خالي عبد الجبار. والتطواف في ساحة السويدي (الشهداء)، ومراجعة كراج خزعل للوقوف على إخبار راوة وأهلها وسؤال القادمين منها لعلّ أحدهم يحمل خطاً أو مكتوباً من الأهل والأصحاب.
[9]
طوال خدمتي العسكرية لم أحظ بإجازة مديدة إلا مرة واحدة، فقد منحني الرئيس (النقيب) أحمد فؤاد إجازة أمدها ثلاثون يوماً تقديراً منه لانضباطي العسكري، ولقاء خدماتي في رعاية (حصانه أجود).
"لا تسلني ما الذي كانت تعنيه مثل تلك الفرصة الذهبية التي تتاح أمامي للمرة الأولى، فقد شعرت بفرح عظيم ، إذ سأعود إلى الفرات، وإلى أهلي وأصدقائي، سأنزل النهر، وأجوب راوة من شرقها لغربها، وسأتجول في بيت طلاع، والخليج والهلالية، والزراشية ( ٩) وقد أصل إلى (الخربية) وربما أعبر إلى الجزيرة.
حزمت متاعي، بعد أن ابتعت بعض (الصوغات) الصغيرة لزوجتي وابنتي وأمين. اتجهت إلى (كراج خزعل) باحثاً عن حافلة إلى عانة، غير أني لم أجد أي واسطة للنقل، وقيل لي بأن من المحتمل أن تتوفر سيارة في المساء. ووجدت أن الأمر غير مضمون، فقد يطول انتظاري دون جدوى، فقررت السفر إلى الفلوجة ( ١٠) أولاً، وحال وصولي ظفرت بعربة (لوري) متجها إلى عانة ،( ١١) لكن السائق اعتذر عن (الصدر)، فلا مكان لي فيه، واشترط على أن أصعد إلى حوضها، فلم أجد غضاضة في ذلك وقبلت شرطه، فتسلقت العربة واتخذت مكاني في (السيباية). واستغرقت المسافة بين الرمادي وعانة حوالي ثماني ساعات، وقد أنزلتني عربة اللوري في منطقة (السراي).( ١٢)
إثروصولي باشرت قطع المسافة الطويلة ماشياً صوب منطقة (رأس الغربي) ( ١٣) بدا المسير الليلي موحشاً ومديداً في الطريق (البراني).. وعند بيت الكحلي( ١٤) شعرت بالإعياء وبأن خطواتي أثقلها النعاس ولم يعد بوسعي مواصلة السير، فأرخيت جسدي على حافة رصيف النهر بانتظار النهار، كيما أعبر الفرات في الصباح إلى الضفة الأخرى فخلدت للنوم.
أيقظتني شمس عانة في اول الصباح ، فأبصرت جمال الطبيعة الباذخ الألوان، فالشمس تنهض من النهر تمد نحو أفق العين خيوطاً من ذهب وحرير، زقزقة العصافير تنبئ بأن يوماً جديداً قد أتى فيمتلئ صدري بعبق الربيع وقداح البساتين.
لا شيء في الوجود يعادل المرابع والديار، وعندما عبرت الفرات أحسست وأنا على ضفة الاخرى ، كما لو أنني أولد من جديد، فطفقت أعدو منشرح الصدر مغتبطاً أحث الخطى جهة دار الأهل، وأنا في أشد الشوق للقاء زوجتي وابنتي وأخي.
الأيام الثلاثون تصبح كاللحظة العابرة، فقد تناثرت بين فرح العودة ومسامرة الأصحاب، والاستئناس بالأحبة، وزيارة الأهل، وشوق النهر والناعور و(عصاري) البساتين وتلبية الدعوات.
الغيبة واللهفة: الأولى تبعث في النفس أشواق اللحظة، واللهفة إيذان بالوصل والخلق والتكوين،.
لا أدري كيف انصرفت الأيام الثلاثون: فقد كنت أمضي النهار ما بين الضحى والظهر برفقة الأصدقاء في المقاهي، وعند حلول العصر نتمشى صوب جهة (الغرب) تحت ظلال البساتين. أما المساء فـ(التعاليل) ذات المذاق العذب غالباً ما تعقد في بيت مطني العساف، فيما لازمني أخي أمين فكان يصحبني في الزيارات والدعوات.
لم أتناول في بيتنا طوال الأيام الثلاثين إلا وجبة الصباح، فيما كان علي تلبية دعوات الأهل والأقارب والأصدقاء في الغداء والعشاء، ابتداء من بيت دخيل إلى بيت نعمان، إلى جوار الدعوات الأخرى،
وبانقضاء الاجازة عدت إلى بغداد ولمايزل مذاق الأيام الحلوة يملأ نفسي ..
[10]
في منتصف شهر كانون الثاني 1939 بلغنا الآمر بخبر التسريح، إذ لم يبق على انقضاء الخدمة العسكرية إلا أياماً معدودات. بعد القيام بفرضية عسكرية في منطقة ديالى قد تستغرق أكثر من عشرة أيام ـ
وفي صباح بارد حملتنا نحن الجند (قيد التسريح) عربة لوري متهالكة تدب على طريق ترابي ذي شقوق وأخاديد وحفر يزيد العربة وهْناً على وَهْنْ، اجتزنا مدينة (بعقوبة) ( ١٥) المثقلة أشجارها بالليمون والبرتقال، ثم اتجهت العربة نحو (المقدادية)، ( ١٦) مدينة أخرى لم أرها أو أسمع بها من قبل، توقفت العربة بأرض قفر جرداء، ذات فضاءات واسعة، وأمرنا أن نقيم فيها معسكرنا، فبادر الجند بنصب الخيام.
علمنا بأن مجيئنا إلى هذه المنطقة لدواعي القيام بفرضية عسكرية، وهو تقليد عسكري يجري عادة قبيل التسريح.
عند حلول الليل، بدأت الفرضية فعالية قتالية تحت اسم (قرغان) توزع الجند زمراً انتشروا على (المواضع). وفي الساعة الثانية عشرة ليلاً، شرعت المجاميع الحركة تجاه الأهداف المحددة لها.
وقد تواصلت الفعاليات العسكرية حوالي عشرة أيام، ولعل مشاقها الصعبة إن لم تزد فهي تعادل عاماً من الخدمة العسكرية. فاليوم الواحد تحسبه في حسابات التعب المرهق شهراً، بعد أن أخذت منا الأيام العشرة مأخذها، عطشاً وجوعاً، ونصباً.
[12]
تقضي تعليمات التسريح، إجراء فعالية الرمي بوصفها خاتمة الخدمة العسكرية. ومع خيوط الفجر الندية، حملتنا عربات الجيش إلى منطقة (أم الطبول) ( ١٧) التي كانت في ذلك الوقت "ميدان الرمي". وبانقضاء هذه الفعالية وإتمامها، بلغنا رئيس عرفاء الوحدة، بأن نباشر بإجراءات التسريح في اليوم التالي، فكدنا نطير فرحاًَ فتعالتْ أصواتنا بالهوسات، الهتاف بحياة الملك غازي، على طول طريق العودة إلى معسكر الوشاش، وكل جندي منا يهنئ زميله وهو في أشد حالات السعادة والفرح.
لذلك لم يعرف أحد من الجند الهجوع في تلك الليلة إلا لماماً، ونحن نتحدث بفرح عن الغد، وعن أحلامنا، وعودتنا إلى الأهل والديار، فيما تغير كل شيء في صباح اليوم التالي، إذ فوجئنا بصدور أمر عسكري يقضي التريث، وإرجاء التسريح إلى إشعار آخر. فأصابنا الإحباط، بدأ الزمن منذ تلك اللحظة يستحيل قلقاً مضنياً. ونحن نضرب أسداساً بأخماس، فالترقب والانتظار والأمر المجهول، والتأويلات والشائعات من حولنا جعلتنا في حيرة من أمرنا لاسيما بعد أن صار أمر التسريح قاب قوسين أو أدنى بعد أن كنا نمني النفس بالعودة إلى حياتنا المدنية الأولى.
ولم تطل الأيام بالأمر الغامض حتى انجلى ما وراءه، فقد علمنا بأن تأجيل التسريح يعود سببه إلى ما سمّيَ في حينه بـ (حركات شيخ بشتر)، ولم يكن هذا الحدث الطارئ، هو المفاجأة الوحيدة، التي أعاقت تسريحنا، بل تلاها فاجعة وطنية عظمى أشد إيلاماً على النفس من أي مصيبة سواها، ففي يوم 4/4/1939 الذي أوشكنا فيه إنهاء إجراءات إتمام التسريح من الخدمة العسكرية صدمنا بمصرع الملك المحبوب غازي!
ولا أظن أن بوسع كائن من كان وصف مشهد الأحزان العظيمة لهذا الرزء الذي أصاب العراقيين. فأي عبارة مهما كانت بليغة، لا يمكن لها الإحاطة بالمشهد المهيب لهذا اليوم الذي يستحيل أن توجزه مقالة أو تلم بتفاصيله الكلمات.
فقد تحول المعسكر كما بغداد كلها إثر إعلان النبأ المروع إلى كتل بشرية متفجرة بالهتاف والبكاء والعويل فيما كانت طرقات العاصمة وشوارعها تردد صدى النائحات وهن يندبن ويلطمن الوجوه والصدور. وعند رأس الجسر العتيق (الشهداء) كانت الكرخ تضج بالهتاف والنواح. وأفواج الناس تتدفق من كل الجهات كسيل منهمر من غير انقطاع.
(١ ) معسكر الوشاش : يقع قرب مركز العاصمة في جانب الكرخ ثم تحوّل في سبعينيات القرن الفائت إلى (منتزه) كبير عرف باسم (الزوراء) .
( ٢) الخَط : هو (الرسالة) وقد تسمى (مكتوب) أيضاً.
( ٣) كان لهذه الحافلة مواعيد محددة وثابتة في الذهاب والإياب من عانة إلى الرمادي وبالعكس. إلى جانب نقل الركاب كانت تحمل أيضاً أكياس البريد بين المدن التي تنتقل بينها.
( ٤) يقع في جانب الكرخ قرب علاوي الحلة وهو (الكراج) الأكثر شهرة منذ الثلاثينيات حتى ستينيات القرن العشرين، المخصص لنقل المسافرين والبضائع بين بغداد ومحافظة الأنبار.
( ٥) الرحمانية : منطقة مجاورة للشيخ معروف في الكرخ.
( ٦) من مطربي العراق الذي إ شتهر بأداء اللون الريفي ، وظل الصوت الأقرب إلى قلوب الناس وخاصة القرويين منهم منذ أواسط الثلاثينيات حتى نهاية الستينيات من القرن الماضي .
(٧ ) تقع قرب علاوي الحلة في الكرخ وينسب اسمها إلى ناصر حكيم المطرب الريفي الذي أبدع في أداء ضرب من الغناء يسمى (الصُبيّ) المفعم بالشجن العميق. وقد أصبحت هذه المقهى وعلى مدى تأريخها ملتقى القرويين الذين يرغبون في سماع الغناء
الريفي الذي اختصت به مقهى ناصر حكيم.
( ٨) الاسطوانة التقليدية التي كانت توضع في جهاز الغرامفون قبل ظهور (الأشرطة الصوتية)، ولازال البعض يفضل استعمالها حتى اليوم.
(٩ ) الزراشية : إحدى مناطق البساتين غربي راوة، سميت بهذا الاسم نسبة إلى ( أرد دشير بن عانات) ملك الحضر، بعد أن اتخذها منتجعاً صيفياً له ولأفراد عائلته وحاشيته .
( ١٠) قضاء تابع لمحافظة الأنبار، وهي (الفلوجة) أشهر من أن تعرف، بعد أن أصبحت مركزاً رئيسياً= للمقاومة الوطنية في مواجهة العدوان الأمريكي عام 2003، بل تعد في المرحلة الراهنة مدينة العرب الأولى بعد أن استطاع أبناؤها هزيمة جيش الولايات المتحدة في العديد من المعارك والمواجهات و هي في ذاكرة أحرار العالم مدينة البطولة والصمود.
( ١١) مركز محافظة الأنبار تبعد عن مركز بغداد حوالي (110) كيلو متر.
( ١٢) مركز مدينة (عانة).
( ١٣) إحدى محلات عانة الغربية تتميز بإطلالتها على الفرات وهواؤها عذب.
( ١٤) إحدى محلات عانة.
( ١٥) أم الطبول : كانت في الثلاثينات تقع في الطرف القصيّ من بغداد، تعد اليوم ضمن الحدود البلدية للعاصمة وهي آهلة بالسكان تجاور حيّ اليرموك وتطل على طريق المطار الدولي ويعد جامع (أم الطبول) أحد أبرز معالمها.
( ١٦) المقدادية : أحد أقضية محافظة ديالى .
( ١٧) أم الطبول : كانت في الثلاثينات تقع في الطرف القصيّ من بغداد، تعد اليوم ضمن الحدود البلدية للعاصمة وهي آهلة بالسكان تجاور حيّ اليرموك وتطل على طريق المطار الدولي ويعد جامع (أم الطبول) أحد أبرز معالمها.
للراغبين بالأطلاع على الحلقة السابقة:
http://algardenia.com/maqalat/28034-2017-01-20-12-07-32.html
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
850 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
تابعونا على الفيس بوك





















































































