مظلوم
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 31 آذار/مارس 2023 15:00
- كتب بواسطة: بهنام سليمان متي
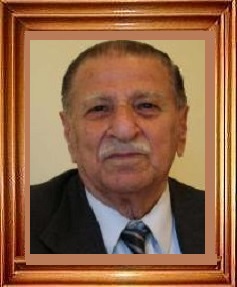
بقلم : بهنام سليمان متي - أبو ذكرى
مظلوم
ظلت صورة مظلوم تعيش في اعماق ذاكرتي فترة طويلة من الزمن تنوف على خمسين عاما، تغوص احيانا الى قاعها، وتطفو احيانا اخرى على سطحها، لكنها ما أن رأتني قد بلغت من العمر ما بلغت، حتى بدأت تحثني على تحريرها من هذه القارورة التي ظلت حبيسة فيها طوال هذا الزمن ، ونزع لباس الكتمان عنها ليطلع أبناء هذا الجيل على قصة انسان بائس ، عاش على هامش الحياة وحيدا منفردا ، وتفاعل معها بكل ما كان يملك من ادوات التفاعل، ورحل عنها ذات يوم بهدوء وتواضع، كأنه ما ولد ولا غاب.
عرفت مظلوم ذات خريف بعيد في مكان ناء من بلادي على اطراف الهور، حيث المياه تحيط بك من كل جانب، واسراب الحمام ترفرف فوق تلك المساحات الخضراء بجذل وبهجة تنسيك هموم الدنيا.. كنت يومذاك حديث العهد بالعمل وكانت قسمتي أن أشتغل في تلك المنطقة النائية التي كانت تدعى (سوق شعلان) . كانت قرية صغيرة لا تجد فيها غير المدرسة والمخفر والمستوصف والسوق الذي تسمت بأسمه، أما الدور فكانت صرائف متناثرة في اعماق ذلك الريف، وكان مظلوم واحدا من اولئك الناس الذين يعيشون الى جانبك وسط السوق ... كنت أراه كل يوم يجلس على حافة الطريق باسطا عباءة سوداء بالية أمامه، ناثرا عليها عدته البسيطة المكونة من بضعة أبر خياطة باحجام مختلفة، وخيوط ناعمة ملساء فيها الذهبية والفضية. كان مظلوم يصلح لاهل السوق والوافدين اليه ، ما بلي من ثيابهم، يعالج تلك التي جاء عليها العث فنخرها ليعيدها بمهارة واتقان افضل مما كانت عليه، يطرز عباءاتهم بتلك الخيوط الذهبية والفضية فيوشيها بذلك الطوق الجميل ، ليزيد من أناقتها على اكتافهم . كان مظلوم يوم عرفته قد تجاوز الاربعين من عمره، ربع القامة دامع العينين ،يستعين بنظارة طبية يضعها على ارنبة أنفه الصغير، يرتدي ثوبا داكنا يغطيه بعباءة سوداء، ويعتمر كوفية وعقالا يخفي تحتهما شعيرات رأسه البيضاء .. غامق اللون، لوحته شمس الجنوب فجعلت بشرته بلون البن . كان يمضي نهاره منكبا على عمله، يرد تحية المارين به دون أن يرفع ناظريه ليعرف مُحييه. وكنت أنا ايضا أمر به في ذهابي وايابي الى عملي، احييه بلطف ومودة فيجيبني باسما، ثم ينـزل نظارته الى مقدمة أنفه، ويرفع بصره ، نحوي ليكلمني بأقتضاب، ومع الايام ترسخت الألفة بيني وبينه ، فأخذ يحدثني عن بعض همومه، فعرفته عن كثب أنسانا بسيطا طيبا تملأ المحبة قلبه ، وتتقطر نفسه أسى على أحزان الآخرين .. كانت له نظرة الى الحياة تختلف كثيرا عن نظرات العديد من أناس ذلك الزمان، وكان على جانب ليس بالقليل من الثقافة، يتلو عليك بعض الشعر ، ويستشهد في حديثه بالأمثال والحكم، وينتقل بك الى التاريخ فيروي لك شيئا عن واقعة (الطف) ومأساة الحسين فيها . كان مظلوم غريبا عن منطقة السوق، فلم يكن من أبنائها، ولا احد يعرف من اين أتى، وجدوه ذات يوم دخيلا عليهم فقبلوا دخالته ، وهيأوا له مأوى بسيطا قريبا من مركز السوق، لم يسألوه لِمَ جاء ومن أين ؟ وحين عرض عليهم مهنته التي كانوا في حاجة ماسة اليها، سكتوا عنه واحترموا صمته... كان وحيدا لا عائلة له ، يعيش ليومه فقط ، أما غده فيتركه ملكا للأقدار تتحكم فيه ، واذا سأله سائل : من أين جئت يا عم ؟ يجيبه : من أرض الله الواسعة يا بني، أما اذا استفسر عن أهله وعشيرته وبني قومه، رد بلطف : انتم اهلي ... كل الناس الطيبين هم عشيرتي وبني قومي. كان مظلوم محاطا بهالة من الغموض لم يكن أحد قد توصل اليها، ولا كان يرضيه أن يتعرف عليها فرد، فما كان يظهر عليه أنه مطالب بثأر، لانه لم يكن يبدو خائفا او قلقا، ولا متوجسا أمراً، بل كان اقرب الى الرضا والقناعة بحياته. كان يزدري الكثير من المظاهر الكاذبة التي كان يراها لدى بعض المترفين من مالكي الارض والماء، لكنه لم يكن يكشف عن هذا الازدراء الا للقليل ممن يثق بهم ويأمن جانبهم، وكان بسطاء الناس يحبونه ويأنسون اليه، وكثيرا ما زوده تلامذة المدرسة ببعض حاجاته الغذائية من تمر وخبز ولبن (روبة). كان يعمل طيلة النهار، واذا ما آذنت الشمس للمغيب وخلا السوق من رواده، جمع عدته ووضعها في صندوق خشبي صغير حمله الى صريفته. كان يوقد فانوسه النفطي القديم، ويجلس القرفصاء يلوك لقمة مغمسة بالماء واللبن مع قليل من التمر هي كل عشائه، ثم يضطجع على حصيرة بالية متكئا على وسادة من القش ليقرأ في كتاب شئيا مما يشتهي، واذا بدأ النعاس يداعب اجفانه، أو اذا كلّت عيناه عن المطالعة، بادر الى إطفاء فانوسه وغط في نوم عميق. لقد ادهشني يومذاك أن يكون مظلوم هذا الانسان الريفي الذي قد تشمئز منه لاول مرة حين تجده يعمل كالمتسول على حافة الطريق، على دراية بـ (الفية أبن مالك) و(نهج البلاغة) و(معجم البلدان) وحين كنت أسأله متى وأين تعلم القراءة والكتابة في عهد لم تكن المدارس في مطلع ذلك القرن قد وصلت الى ذلك الريف القصي، كان يجيبني أنه تعلمها على أيدي (ملالي) أهله في (كتاتيب) قريته أيام (العصملي) وأن جده لابيه كان محبا للعلم يقتني نوادر الكتب من مكتبات النجف، فشغف هو ايضا بتلك الكتب وبدأ يقرأ شيئا منها كلما توفر له بعض الوقت، وحين كان الفضول يغريني لأعرف المزيد عنه وعن أهله، كان يوقفني بسبابته راجيا ان اكف عن السؤال قائلا: اخي أنا أبن هذه الارض الطيبة التي تنجب كل يوم المئات من أمثالي.. أنا واحد من معذبي هذه الأرض، وما اكثر المعذبين فيها هذه الايام، فدعني أعيش لوحدتي في خلوتي، هكذا كُتب علي، وهذا قدري، ثم يردد هذين البيتين من الشعر:
مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها
ومن كانت منيتـه بأرض فلن يموت في أرض سـواها
كان مظلوم يعيش في ذلك السوق الصغير على ضفاف فرع من فروع نهر الفرات وكان الهور غير بعيد عنه ومساحات من حقول الرز الجيد (العنبر) تمتد أمامه يعمل فيها الفلاحون بجهد ومشقة ، فتراهم يغوصون حفاة عراة في تلك المياه، ينقون الرز من الشوائب والآفات، يحملون مساحيهم على اكتافهم العارية ولا يخرجون الاّ مساء وقد انهكهم التعب وشلهم الاعياء ... كان يتألم لأولئك الفلاحين البؤساء الذين يكدون ويكدحون ولا ينالون غير لقمة العيش، لكنه لم يكن يقوى على البوح بشيء مما يختلج في أعماقه فالاقطاع كان سائدا يومذاك والشيوخ ورؤساء العشائر هم المهيمنون على الأرض والناس، فلم تكن الأرض وحدها ملك يمينهم، بل كان كل من يعيش عليها هو الآخر طوع بنانهم، والويل كل الويل لمن يتذمر او يتأفف، أما الهمسة او النبسة فلن تجر على صاحبها سوى الدمار، لذلك كان السكوت على مضض هو الأسلم، فمظلوم ربما كان في يوم ما واحدا من اولئك الفلاحين الذين يراهم يغوصون في المياه والأوحال... ربما هرب من ظلم لحق به، وما كانت له حيلة على رده.. او ربما هوى أمراة من غير طبقته ، وحين عز عليه البنيان بها هام على وجهه حزينا بائساً حتى استقر به المقام في ذلك السوق القريب من الهور . لقد كان مظلوم يغيب عن السوق أياما كل شهر، ينزل الى المدينة وهي (النجف) طلبا للتسوق والترفة ، يقضي فيها أسبوعا في لهو وانس حتى يأتي على اخر درهم معه، فيعود الى السوق فارغ الكف خالي الوفاض ليعاود من جديد كده اليومي. كان يحدثني عن هذه المدينة بفرح يشابه فرح الأطفال ، فيقول أن المدينة غير الريف، تستطيع فيها أن
تمرح على هواك،لأن الناس هناك من كل الأجناس، ترى الأيراني والأفغاني والباكستاني يحملون من بلادهم بضائعها يعرضونها للبيع في الأسواق، فبأمكانك اذا كنت ملئ الجيوب أن تشتري ما تريد من نفائس التحف... النجف مدينة (الإمام) كبيرة واسعة يؤمها كل يوم الآف الزوار من كل حدب وصوب، فأنت فيها بعيد عن عيون المتطفلين ، تأئه بين التائهين، لا من أحد يعرفك، وقل من تجد بين ذلك الزحام من تعرفه.. . هكذا كان مظلوم حين يعود من النجف فرحا جذلا منتشيا بخمرة نفسية ، متوقد الذهن ، جم النشاط، كثير الحيوية ثم يوما بعد يوم تخبو تلك الجذوة من الحرارة، ويتراجع ذلك الأندفاع، فيعود الى صمته، وينشغل بأثوابه وعباءاته، ينتظر أوبةً أخرى الى المدينة.
كانت تلك الأيام البعيدة مرة وقاسية، وكان ذلك الريف الجميل الموشى بالمياه والبردي والنخيل والخضرة الدائمة على مدار السنة مهملا محروما من أبسط وسائل الراحة. كان البعوض ينهش جسدك صيفا ، والبرغوث يدميك شتاء ، وكانت الملاريا والبلهارزيا تفتكان بالعشرات، فلم يكن في السوق سوى مستوصف صغير يديره مضمد جاهل يعالجك بالكينا والسلفا، ويداوي رمد العينين بقطرات زرقاء أو حمراء تكويك ولا تشفيك. لقد ودعت مظلوم وأنا عائد الى أهلي على أن القاه ثانية، لكنني حين عدت بعد أشهر لم أجده، ولما سألت عنه أهل السوق، أخبروني انه نزل الى المدينة كعادته كلما هل الهلال، لكن غيبته طالت ثم طالت ، وبقيت صريفته تنتظره فما مد اليها أحد يدا، وما عرف فرد ماذا حل بمظلوم، هل وافته المنية وهو في النجف، فحمل مثل مئات الغرباء الذين توافيهم المنية هناك الى تلك الصحراء القاحلة ذات الرمال الحمراء ، ليثوى في واحد من مئات الأجداث الممتدة امتداد البصر؟ ام تاقت نفسه الى أهله وعشيرته فعاد اليهم كما يعود الأبن الضال الى ذويه ناشدا
الدفء والحنان ؟ لقد تعرفت على مظلوم ذات خريف ، وفقدته في خريف آخر, وظلت انظاري تحوم حول مكانه الخالي على حافة الطريق لعله يعود ذات يوم وينتصب كالشبح أمامي ، لكنه لم يعد أبدا، فتألمت لفراقه كأنني فقدت شيئا عزيزا، وتمنيت لو أنني ما عرفته وما وصلت وأياه حبال الود، كان غياب مظلوم على تلك الطريقة سرا على أهل السوق، مثلما كان قدومه أيضا سرا عليهم، وظلوا يتذكرونه بشئ من الحسرة والشوق الى أحاديثه ونكاته، ثم مرت السنون وكرت الاعوام ولم أر السوق منذ أن غادرته، لكن أخباره كانت تصلني وتفرحني ، فقد تأثر بالتحولات الكبرى التي شهدها البلد ، فنما وتوسع، وحلت الدور محل الصرائف، وازاح النور ظلام الليالي ، وتحرر الفلاح من عبوديته، وفي خضم تلك الاحداث نسي الناس مظلوم لأنه أصبح شيئا من الماضي والناس أبناء الحاضر.
لكن صورة مظلوم لم تبارحني، وها أنا أرويها وأنا بعيد عن وطني فالمرء مهما نأى به الزمان، وفرقته عن محبيه الأيام، يبقى حاملا ذكرياته في اعماقه يمضغها في فمه كما يمضغ الجائع طعامه، يتلذذ بحلوها ومرها، لأنها جزء لا يتجزأ من حياته.
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
513 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- سيدني سويني .. مارلين مونرو العصر؟
- تقرير أممي يكشف: خمس محاولات لاغتيال أحمد الشرع ووزيرين خلال عام واحد
- بشرى سارة - الزراعة تُقرر منع استيراد "البصل الأخضر" لوفرة المنتج المحلي!!!
- إيلون ماسك يعلن خطة لبناء "مدينتين" على القمر والمريخ
- نقل نحو ٥٠٠٠ من عناصر داعش السابقين من سوريا إلى سجون العراق
- الموت يغيب دكتورة عراقية في اليابان قبل أسابيع من تخرجها
- أنسنة التكنولوجيا وتوطينها مبادرة أممية للرقمنة الجغرافية بمواجهة الإهانة المكانية (المستوى الدولي والعربي والعراقي)
- قصة (عشق الصبى) - الجزء الاول
تابعونا على الفيس بوك




















































































