كهوف الغربه..!!
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2013 19:12
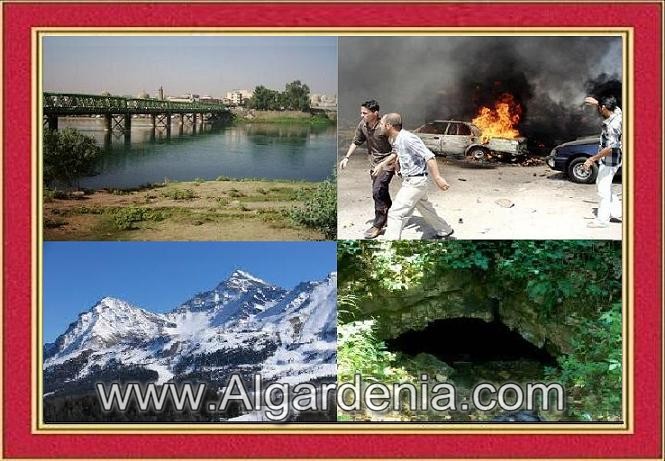
كهوف الغربه

كتبها – فؤاد حسين علي
لو كنت قد استوقفت عراقيا لأسأله قبل ثلاثين عاما عن إمكانية ترك وظيفته وبلده أو محلته، من أجل الهجرة إلى الخارج، لأجاب ببساطة هل أنت مجنون؟

سؤال كنت مشغولا بوقائعه، أستعرضها مع نفسي وأعيد عرضها وأنا أمشي وحيدا في غابة مترامية الأطراف في يوم صيف نهاية تموز عام 2011، الشهر الأجمل في السنة السويدية بالنسبة لنا نحن الشرقيين المقيمين في ربوعها على أقل تقدير، حيث الدرجة المئوية للحرارة في هذه المنطقة القريبة من القطب الشمالي تقارب الخمسة عشر، وخرير المياه المتأتية من ذوبان بقايا الثلوج يسمع من كل الجهات، موسيقى مجسمة وضعت خصيصا لهذا المكان الجميل بهواه العليل.
أسأل نفسي تارة وانا الماشي على غير هدى ماذا عملت بها وبالعمر الذي تجاوز الستين بأربع سنين؟. وأجيب تارة أخرى على مثلها من أسئلة تدور حول نفس الموضوع، أو بالحقيقة أبرر قراري في الهجرة وترك البلاد، وما بها من زوجة وأولاد، وما تبقى من قليل الأصدقاء الذين نجوا من حروب أكلت بعضهم، وأمراض أماتت بعضهم، وهجرة سلبت بعضهم الآخر.
الغابة التي أمشي فيها الآن، ملاصقة للقرية التي عزمت على الاستقرار فيها بعد أن جربت السكن المكتظ في شقة وسط أوربرو، وعجزت عن التأقلم مع متطلباته، الأمر الذي دفع محمد ولدي المقيم قبلي في السويد من أن يشير عليّ في أن أجرب السكن بهذه القرية التي وصفها بالهادئة الجميلة التي يسكنها كبار السن المتقاعدين السويديين الهاربين من ضجيج المدن وزحمة الإنسان، والتي تبعد عن أقرب مركز مدينة بحدود الخمسين كيلومترا، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بالاعتبار إنها تنعزل عن باقي مدن السويد عدة مرات في أيام الشتاء التي يستمر فيها نزول الثلج بشكل متواصل.
لقد قبلت مضطرا هذا التجريب، وحاولت أن أعالج آثار وحدته التي لا نتحملها نحن الذين تعودنا صخب المكان، بالقراءة وبمشاهدة التلفاز أحيانا، وبإجترار الأفكار أي "الدالغات" كما تسمى في بغداد أحيانا أخرى. ومع هذا أصبح العيش في هذه القرية صعبا وإن كانت جغرافيتها قريبة من وصف الجنة أيام الصيف، فأضفت بسببه المشي عامل علاج آخر أستغله للحصول على قدر من التعب الملائم لنوم الليل وكم من أشعة الشمس التي تظهر بين الحين والآخر عسى أن تذكرنا بنهارنا وإن كانت شمسهم هنا لا تشبه شمسنا هناك، وفيه أيضا أستعراض للذكريات التي تنساب عادة في المشي على الطرقات الخالية بتسلسل لا يوجع الذاكرة مثل ذلك الذي يحصل عادة في تخوم الليل.

لقد توغلت بعيدا داخل الغابة في طريق لم أسلكه من قبل، شعرت بالتعب بعد ساعتين من المشي المتواصل، فجلست على جذع شجرة عملاقة، كأن الطبيعة كونت من حافاته مكانا للجلوس أو إن الشجرة الرحوم قد شهدت الكثير من الماشين عبر زمنها الطويل فتعاطفت معهم بتحوير جذورها عونا لهم في مشيهم الطويل. جلست ومع إنشغالي بإحدى الدالغات التي أعادتني إلى أيام الشباب تراءى إلى سمعي صوت أغنية عراقية، لم أفرق في بداية الرؤية بين حقيقة وجودها أغنية عراقية فعلية أو هي خيالات من الدالغة التي كنت مشغول فيها بحب قديم.
لقد أعادتني هذه الواقعة أو بالأحرى أصابتني بصدمة وكأن تيار كهربائي سرى في جسمي المنهك، فأعاد لي نشاطي الحسي كاملا، ليس رغبة مني في التأكد من كون الأغنية حقيقة أملا في الاستمتاع بسماعها، بل وللتخلص من الشك بالوهم في إنها خيال بات يرعبني وأنا وسط الغابة وحيد.
لا، إنها حقيقة، هذه كلماتها واضحة (يا طيور الطايرة مري بهلي يا شمسنا الدايرة ضوي لهلي)، بموسيقاها العراقية الأصيلة وصوت سعدون جابر الشجي، نسيت بسماعها أني في السويد، وتصورت نفسي جالسا في حديقة بيتي عندما كنت معتادا على الجلوس أيام الربيع وسماع بعض الأغاني العراقية عندما كان العراق بلدا يعزه أهله ويتمتعون في العيش بربوعه الغناء.
إلا إن أقتراب الصوت وعلو درجته أعادني ثانية الى السويد إلى الغابة ذاتها، فوقفت منتصبا، مستغربا، متهيبا باتجاه الصوت، وإذا بمصدره شاب يحمل آلة تسجيل نزع من على إذنيه سماعات مربوطة بها ليترك الصوت عاليا في الغابة ، كمن يداري بفعلته هذه وحشة أحس بها وهو في الطريق.
لقد اقترب الشاب، إنه طويل القامة، حنطي البشرة، وبهيئة وهندام يوحي أنه عراقي أو ربما الأغنية التي هيأت لي التصور من أنه عراقي، لكن ملابسه لا تنم عن ذلك، إنها ملابس صيد قديمة، وكلبه الذي يتبعه لا يؤشر عراقيته التي يندر أحد فيها أن يأتلف مع الكلاب التي يعتقدون بنجاستها.
لقد توجست خيفة حتى فكرت في أن أتوارى خلف الشجيرات القريبة وأتجنب ما قد يسفر عنه الاقتراب من هذا الشاب الغريب، الذي لا يمكن الاطمئنان إلى وجوده في موقف أنا وإياه فيه وحيدين، لكن قربه مني ونظرته إليَّ حالت دون قيامي بأي تصرف أو حركة قد تفسر أنها غريبة، فقررت في أجزاء من الثانية أن أبقى واقفا لأتبين ما ستؤول إليه الحال.
لقد وصلني توا، فأغلق الصوت، وأقترب نحوي، وقبل أن يسأل أو يسلم بادرت أنا بالسؤوال: هل أنت عراقي؟
نعم أنا عراقي، السلام عليكم.
وعليكم السلام، يبين أنت عراقي أيضا عمي الحاج.
نعم أنا عراقي أسكن في القرية التي تقع جنوب الغابة مسافة ساعتين مشي من هنا وإسمي فؤاد، أبو أحمد، وأنت أين تسكن؟، أكيد ليس في قريتنا ولا قريبا منها لأني وكما علمت من أهل القرية أن لا أجنبي يسكن في قريتهم، ولا في القرى القريبة منهم، إنهم سويديون أبا عن جد، يعيش غالبيتهم على رواتبهم التقاعدية، وقليلهم يعمل في الغابة ومن أجلها.
أنا رؤوف،لا سكن لي مُؤَشر عند الحكومة السويدية، أو يمكنك القول ليس لي سكن رسمي، لكني، وبعد أن سكت برهة وتلفت يمينا وشمالا، كأنه يفكر في صياغة قول لم يعتده أو يتجنب قول يخجل منه أو يتأكد من أن أحد غيري لم يسمعه ، ألتفت إلي فأكمل قائلا: ألا ترى تلك القمة البعيدة التي يغطيها الثلج من أمامنا، وذاك الحزام الأخضر تحتها مباشرة.
أجبت نعم أراه!
إني أسكن هناك في كوخ أو بالأحرى مغارة يتصل بها كوخ قديم، يبدو إنه لمستكشفين أنشأوه وهم في طريقهم إلى القطب قبل أكثر من قرن من الآن، أو لباحثين جيولوجيين أو منقبين، لا أدري.
وما الذي أسكنك في هذا الكوخ الذي تقول عنه قديم ومهجور.
إنها قصة طويلة، ولا أعتقد أنها تسر سامعيها.
لا يا بني، يمكنك سردها فالوقت في السويد طويل ويمر علينا ببطئ شديد، والغربة التي جمعتنا عراقيين في هذا المكان سمعنا بسببها ما لايسرنا الكثير، وعشنا ما يؤلمنا وهو كذلك كثير.
دعني أجلس لألتقط أنفاسي، سيما وإني بدأت جولتي منذ الساعة الخامسة صباحا، والآن الساعة الثانية ظهرا، فأشعر بالتعب.
قبل أن تبدأ بعرض قصتك وتأسرني في التعاطف معها ومعك دعني أقترح عليك أن تذهب معي إلى القرية، لتبات عندي هذه الليلة وتتمتع ببعض مستلزمات الحضارة التي هجرتها، فأمامنا ساعتين من المشي، خير من تسعة ساعات تحتاجها للعودة الى كوخك الذي يقع خارج الزمن المألوف.
لا ياعمي فؤاد، لا يمكنني التقرب من أي مكان يسكنه السويديون وتشم فيه الشرطة رائحة الغريب، لأني مطلوب ترحيلي من السويد وإعادتي الى العراق، والعودة بالنسبة لي أمر لا يمكن أن أستوعبه، لإني أخاف العيش في العراق بما يفوق خوفي من الوحشة، أو الدببة والضباع التي تملأ وديان الجبل الذي أسكنه. ثم لا يهمك الوقت، فكما تعلم أن الليل هذه الأيام كما هو النهار، مضاء بدرجة تبقينا غير قادرين على التفريق بينهما، فسأعود متى أشاء وبأي وقت أشاء، لافرق لديّ بين الليل والنهار، حتى إني تعودت عدم النوم لعدة أيام متتالية، وبمثلها النوم عدة أيام في الشتاء عندما يحل وقت السبات.
إذن لا مجال للالحاح في هذا الموضوع؟
لا مجال إطلاقا، وسامحني على أية حال، ومع هذا يمكنني المشي وإياك في عودتك قريبا من القرية، فرصة نتكلم فيها، أُسمعكَ فيها قصتي، وتسمعني فيها قصتك، ولو أني أجد في نفسي الرغبة الشديدة لأن أتكلم أكثر من ما أسمع، لأني لم ألتقي أحد ولم أسمع صوتي لأحد منذ ما يقارب الستة شهور، ألتقيت فيها مجموعة شباب أوربيون جاءوا ليخيمون على قمة الجبل الثلجي في عز الشتاء، وعملت دليلا لهم طيلة فترة أسبوعين بقوا في المخيم، كانت بالنسبة لي مناسبة فريدة للتكلم.
لقد توقف قليلا وعاود الالتفات يمينا وشمالا وإلى الخلف هذه المرة ثم أردف قائلا: عمي فؤاد أخشى أن أصدع رأسك بالكلام.
لا، تكلم، فأنا أيضا بحاجة لأن أسمع الكلام وأحس بنبرته العراقية التي أفتقدها في هذه القرية التي يسكنها الأموات.
بعد أن استراح لدقائق معدودات أستجاب لرغبتي في الشروع بالعودة باتجاه القرية خاصة وإني أخشى التأخيروقلق ولدي محمد عليّ في حال حصوله. ومع أول خطوة خطوناها في الطريق بدأ رؤوف يسرد حكايته:
أنا طالب صيدلة في السنة الرابعة بجامعة الموصل، والدي الدكتور عبد الجليل، استاذ الجراحة في كلية الطب بالجامعة ذاتها، ووالدتي أخصائية تخدير، وشقيقتي التي تصغرني بأربع سنين طالبة في السادس الثانوي، نعيش عيشة ميسورة، هادئة، لنا علاقات جيدة مع أقاربنا في الموصل، ومع الجيران، حتى عام 2004 عندما بدأت الموصل تضطرب.
وهنا دار رأسه بإتجاهي سائلا: أنت أكيد تعرف هذا الموضوع؟.
ثم أستمر في الكلام حتى دون أن ينتظر إجابتي عنه، إني أتذكر بالضبط مساء يوم 22 كانون الثاني 2006رد والدي على هاتفه النقال بعصبية غير معهودة قائلا:
أخي أنا طبيب جراح، وعيادتي لهذا الغرض، لا يمكنني الامتناع عن علاج أي إنسان يطلبني، هذا قَسمٌ أقسمته، وهذه أخلاق المهنة، آسف لا أستطيع، إن ما تطلبه غير معقول. سكت والدي قليلا، يبدو أنه يستمع إلى رد من الطرف المقابل، ثم قال: إن الأرواح بأمر الله، وسأقوم به كما هو مطلوب مني كطبيب وكإنسان مسلم، مع السلامة، ثم أقفل الهاتف ورماه بعصبية شديدة على الطاولة القريبة منه، وجلس على أحد الكراسي الملحقة بها بسرعة، وكأنه أصيب بنوبة تشنج أو أنهيار عصبي.
كانت والدتي وأنا وشقيقتي نستمع إلى المكالمة بقلق شديد، فسألته الوالدة على الفور: عبد الجليل ما الأمر؟ ماذا حدث؟ وماذا سيحدث؟ إني أرتجف ألا تراني ؟

إنها كارثة رد الوالد، ثم أستمر بالقول، أتذكرون ذلك التفجير الذي حصل قبل أسبوع في نهاية الشارع القريب من العيادة، وكيف حصد أرواح عشرين شخصا، وجرح أكثر من هذا العدد بينهم عسكريين، جيئ ببعضهم إلى عيادتي التي تحولت إلى مستشفى ميداني حتى ساعة متأخرة من الليل، حيث أجريت أكثر من عشر عمليات جراحية لمصابين إصابات خطيرة، وأكثر من هذا العدد لجرحى بحاجة إلى إجراءت بسيطة لإيقاف النزيف، واليوم كما سمعتهم أتصل أحد لا أعرفه، يدعي أنه من جماعة إسلامية، يحذرني من الاستمرار بمعالجة الكفرة والعملاء حسب قوله، وطبعا يقصد بهم العسكريون.
كيف لي أن أمتنع عن معالجة أي إنسان يقصدني عسكري كان أو مدني، مسيحي أو مسلم؟ إنها خيانة لضميري المهني وتجاوز على قَسم الطب الذي اقسمته يوم تخرجي، وإخلال بمبادئ الاسلام التي يدعونها. والآن يهددونني بالقتل إذا لم أنصاع إلى رغبتهم. وسوف لن أنصاع، وسأفتح العيادة يوم غد وأعالج من يأتي إليّ حتى لو كان متهم بالارهاب!.
هنا تدخلت والدي قائلة: عبد الجليل دعنا نغادر الموصل ونذهب الى سوريا مثلما فعل الدكتور صلاح، وعبد القادر والدكتور أكرم، إنك لست مختلف عنهم ولا أقوى منهم، لقد تركوا البلاد لمجرد تهديدهم من قبل مسلحين مجهولين، وتعرف الموصل الآن لا حاكم لها ينصفنا ولا حكومة تحمينا، أرجوك دعنا نغادر يوم غد دون تأخير..
أما شقيقتي فوقفت باهتة لا تعرف ماذا تقول متبلدة مشاعرها، لا تقوى على النطق، وبدلا منه أستمرت بالبكاء بنحيب يفطر القلوب، الأمر الذي دفع والدي الى إحتضانها وطمأنتها قائلا:
حبيبتي كل شيئ سيكون على ما يرام، وإن هذه التهديدات مجرد تهويش ليس إلا.
أما أنا فموقفي أكثر حيرة، كان موقف صراع بين الخوف من البقاء في الموصل والهروب منها، صراع مؤلم لأن كلا الموقفين مُرْ من وجهة نظري، وبسبب مرارته فضلت البقاء في حالة المشاهد لما يجري مع ميل في داخلي لتأييد الوالد دون التجرؤ على الاعلان عما أشعر به.
كانت ليلة رهيبة، أتذكر تفاصيلها وجميع النقاشات التي أستمرت إلى آذان الفجر من اليوم التالي، عندما حسم الوالد الأمر بقراره في البقاء قائلا بلهجتنا المصلاوية" بقى خلوها على الله).
لقد حُسم الموقف، وتوجهنا جميعا الى النوم مذعورين.
مرت عدة أيام والأمور طبيعية، والوالد يعالج من يأتيه للعيادة دون أن يسأل عن مهنته وأصوله، ويعود الى البيت بحدود الساعة الثامنة مساء، وعندما يصل تبتهج الوالدة وتصيح بأعلى صوتها الحمد لله، حتى جاء اليوم السادس على التهديد وبعد أن أطمأن جميعنا إلى حد بدأنا ننسى الموضوع في خضم التفجيرات والحوادث وأعمال القتل التي تحدث في شوارع الموصل، كان يوم الخميس، وقد عاد الوالد قبل الساعة الثامنة مساء، لأن عموم الأطباء أصبحوا يقفلون عياداتهم قبل هذا الوقت ليعودوا الى بيوتهم قبل حلول الظلام، وأخذ الوالد بعد التهديد يصطحب معه في طريق العودة فراش العيادة ليتفارقا عند البيت، وكان الأمر كذلك في يوم الخميس المشؤوم، الذي وصلا فيه قبل الثامنة بعشرة دقائق كما قال لاحقا، وأنا كنت أذاكر عند صديقي حميد على أساس العودة الى البيت بما لا يزيد عن الثامنة، إلا إن والدته أستوقفتني وألحت عليّ أن أتناول معهم العشاء الذي أتمت إعداده وقت إنتهاء المذاكرة، حتى لم أجد مفرا من الاستسلام لرغبتها مع شعوري بالتوتر لعلمي أن والدتي ستبقى قلقة حتى دخولي البيت، وعليه أتصلت بها على هاتفها النقال بتمام الساعة الثامنة لأطمأن على الوالد وأخبرها أني سأتخر ساعة في بيت حميد نزولا عند رغبة والدته التي نصبت العشاء ووعد والده أن يوصلني بسيارته إلى البيت، فردت علي قائلة: (بس إبني لا تتأخر وتخلي بالنا عندك).
لا يا أمي سأكون عندكم بعد ساعة بالكثير.
وفعلا وصلت البيت بحدود الساعة التاسعة مع أبو حميد الذي تركني في باب البيت عائدا إلى بيته مسرعا تفاديا لأية مجازفة يحتمل حدوثها بنسب عالية.
وجدت الباب الخارجي للبيت مفتوحة، توجست خيفة من الدخول، لكني أندفعت سريعا تحت سلطة القلق، فتحت مصابيح الصالة، وقفت وسطها مذعورا والدي مسجي جثة على السجادة رأسه مفصول عن جسده وكذلك الأطراف، وعيونه مقلوعة من مكانها.
صرخت أمي.....أمي.
ركضت الى الطابق الأعلى حيث غرف النوم، فكانت والدتي كذلك جثة على أرض الغرفة، مقطعة أوصالها، وبجانبها شقيقتي التي قُطع رأسها وشقت بطنها، وكلاهما عاريتين تماما، ودمهما الذي يملأ أرض الغرفة ما زال حارا لم يتخثر بعد.
شعرت إني أختنق، أرغب بالصراخ، صوتي محبوس داخل حنجرتي، أشهق، ألطم رأسي بحافة الباب، يبدو أني قد فقدت الوعي، لأني بعد عدة دقائق، وعندما عاد إليَّ وعيي وأنا مخنوق، كنت مخضبا بالدماء، وكأني جزء من مشهد الذبح، غطيتهم بشرشف، ونزلت راكضا إلى أبي وكأني لم أكن متأكدا من مقتله، هو باق في مكانه بنفس الصورة التي شاهدتها قبل دقائق.
تركت البيت ركضا، أهذي مع نفسي بكلمات لم أفقهها، أخذتني أرجلي الى بيت جيراننا، الطبيب العسكري الذي ترك الخدمة والمهنة وجلس في البيت دون عمل منذ العام 2003. لم أطرق باب الحديقة الخارجي كعادتي من قبل، دفعتها وأنا اركض، حتى وصلت باب الصالة، طرقتها بسرعة وأستعجال وأرتباك واضح، وعندما لم اسمع الرد، ذهبت الى الشباك وكذلك فعلت، ثم عدت الى الباب ثانية، وكأن الفترة بينهما عام بحاله.
ظهر العم أبو محمد بهيئة يستعد فيها لتأنيب من يطرق بابه بهذه الطريقة السمجة، وعندما شاهدني بحالتي المزرية قال: رؤوف أبني أشبيك؟
الحقنا عمي لقد ذبحوا أهلي.
ماذا تقول؟
أهلي كلهم ذبحوا بالبيت.
لا إلاه إلا الله، محمد تعال معنا.
أم محمد أتصلي بكل أقاربنا بالمنطقة وأقارب أبو رؤوف ليحضروا معنا.
دخلت ثانية مع محمد ووالده، وبعد نصف ساعة جاء جدي وعمي وآخرين من الأقارب. موقف غامض، صور مشوشة، فقدان للوعي لمجرد مشاهدة رأس والدي تحت الطاولة، فقت منه في المستشفى بعد يومين وأنا تحت تأثير البثدين. وكان الأهل قد دُفنوا، وأمتنع جدي من إقامة الفاتحة حزنا وأحتجاجا على طريقة الموت، وكذلك فعل أهل والدتي، وسجلت القضية ضد مجهول.
خرجت من المستشفى إلى بيت جدي الذي أخذت أتركه منذ الصباح لأعود عند المساء، أمشي في شوارع الموصل وأزقتها ومحالها، وأتجنب المرور من قرب بيتنا، مشيا على غير هدى وكأني أفتش عن قاتل أهلي، أو عليَّ اسمع من يتكلم عن الموضوع، وهكذا أستمر الحال لما يقارب الأسبوعين، بعدها زاد التجنب في المشي عندي ليشمل حي الأطباء برمته الذي يقع فيه دارنا المنكوب، وبعد شهر من الحادثة وأستمرار المشي وجدت نفسي قابعا في بيت جدي لا أقوى عن الخروج، ولا رغبة لدي في مواجهة أحد حتى أعز الأصدقاء، وكأني أخاف الناس جميعا، لا أطمئن لأحد منهم.
حار بي الجد المسكين، وحار معه أصدقاء أبي من الأطباء. فأضحيت أقضي كل اليوم ليله مع نهاره في البيت ثم الغرفة، تركت الكلية، وكأني غادرت الحياة.
في الأسبوع الأول من الشهر الثاني، أصطحبني جدي مرغما إلى كاتب العدل لأوقع على معاملة القسام الشرعي، وعند التوقيع عليها كأن الوعي قد عاد إلي فجأة، فقررت أن أبيع البيت الذي ورثته من أبي وأترك العراق، أتصلت دون علم جدي باحد الدلالين في الحي فقلت له:
عمي أبو سمير لديَّ النية أن أبيع بيتنا الذي تعرفه في بداية الشارع، قال لي نعم لكنك تعرف بيعه ليس بالأمر الهين في هذه الأيام خاصة.... ثم سكت، فأكملت أنا (خاصة وقد ذبحت فيه العائلة). فاجاب إنه أمر الله، وإنه قضاء وقدر الله يصبرك، لكن الناس يتشائمون من البيوت التي تذبح بها عوائل بأكملها.
إسمعني جيدا، أنا أريد أن أبيع وبأسرع ما يمكن، ولدي الاستعداد أن ابيع بأي ثمن، وأزيدك علما إنني سأغادر بعد التوقيع على البيع مباشرة، فأعتقد هذا يكفي أن تجد الشخص المناسب لإتمام هذه الصفقة التي ستكسب منها الكثير.
إن شاء الله رد الدلال أبو سمير، سوف أبذل قصارى جهدي، أمهلني يومين على بعضها، لأتحرك على الأشخاص الراغبين.
يومين فقط ومن بعدها سأحاول عرضه بطريقة أخرى أو عند دلالين آخرين.
أتصل بيّ على نفس الرقم بعد يومين، البقاء في حياتك أبني رؤوف.
حياتك الباقية، مع السلامة.
قبل أن تنتهي اليومين أتصل بي قائلا: السلام عليكم أبني رؤوف.
وعليكم السلام عمي أبو سمير.
تدري الظروف الأمنية غير مستقرة في الموصل، وعملية البيع والشراء شبه متوقفة، لكني إكراما للمرحوم الوالد، وتقديرا لظروفك وحاجتك سوف اشتري منك البيت، على أن أبقيه إلى أن تتحسن الظروف لأبيعه على راحتي، فإذا وافقت، تعال إلى المكتب الآن لنتفق على السعر، وكافة الاجراءات.
نعم سأوافيك بعد ربع ساعة من الآن.
وصلت بالوقت المحدد، وبعد أن سلمت عليه، وهو الجالس وحيدا في المكتب، ومن هيئته يتبين وكأنه صياد ينصب فخا، ومع علمي بهذا الوضع، قبلتُ أن أكون الطريدة التي يبغي صيدها، لأن لا أحد يعلم مقدار الألم والخوف في داخلي، وكم الرغبة لدي في أن أترك العراق.
إني اسمع عرضك عمي أبو سمير.
والله وأنت لم تجبرني على القسم بالله الواحد الأحد، إني أريد مصلحتك، والشروة هذه فيها مجازفة كبيرة، من يدري يجوز يرجعون الارهابيين بعد فترة ويفجرون البيت، لو يعتدون على الساكنين، عليه سأشتريه وابقيه فارغ.
عمي، الله يخليك، لماذا تفتح الجرح الذي لم يلتئم بعد، ممكن تأتي من الآخر، وبدون هذه المقدمات؟
ماشي آني أدفع بالبيت ثلاثمائة مليون دينار، صحيح هو يسوة أكثر، بس تدري هذا المبلغ مو قليل، وإحضارة نقدا هم موسهل.
آني موافق، متى نوقع العقد؟؟؟.
الآن إذا تحب، والمبلغ تطلبة بالدينار العراقي أم بالدولار؟.
لا بالدولار، أوقع الآن وأستلم، وتوصلني أنت مع الفلوس بسيارتك إلى بيت جدي.
حاضر، لكن يبقى مبلغ خمسين ألف دولار، سوف تستلمه عندما تعمل لي توكيل عند كاتب العدل.
أنا مستعد أن نذهب الى كاتب العدل الآن، وأوراق البيت والقسام الشرعي جميعها جاهزة، أريد أن أحسم الموضوع ولم ابقي شيئا يتعلق به.
على بركة الله.
وقعت على مجموعة أوراق، واستلمت مبلغا كان قد وضعه في شنطة صغيرة، دون أن أعده، بسبب ضيق الوقت أو نتيجة الاعياء النفسي الذي أعانيه.
توجهنا الى كاتب العدل، عملت وكالة، وأستلمت ما تبقى أي الخمسين ألف دولار، وبعد وصولي إلى بيت جدي، أخذت حقيبة ملابسي، وتوجهت إلى موقف السيارات المتجهة الى سوريا دون أن أخبر أحد عن وجهتي، طلبت سيارة تنقلني وحدي إلى دمشق، وسرعان ما أتفقت مع أحدهم، فوجدت نفسي في بداية الليل قد دخلت الحدود السورية، وقريبا من نهايته وصلت دمشق التي أريد.
في دمشق بدات مشوار جديد، أتنقل بين العراقيين في السيدة زينب وفي الصناعة واماكن أخرى، اسأل عن مختصين بالتهريب إلى أوربا، حضيت بأحدهم بعد ستة شهور، كان عراقي نصب عليّ بعشرة آلاف دولار، وتركني لا أعرف المكان الذي يتواجد فيه.
وهكذا أستمر الحال ستة اشهر أخرى، أتنقل من شخص إلى آخر، ومن وسيط إلى آخر، حضيت أخيرا وبعد ما يقارب السنة بشخص سوري يعمل في مكتب سياحي قريب من ساحة المهاجرين، طلب عشرون ألف دولار، منها خمسة آلاف مقدمة، والباقي عند أستلام التأشيرة إلى روسيا، التي منها أنتقل إلى النمسا "ترانزيت" في طريق عودة مرسوم نهايته المفترضة دمشق، على أن يرافقني في السفرة شخص، يتركني عند مطار فينا بعد أن يأخذ جوازي العراقي.
وافقت كعادتي وبنفس السرعة التي بعت فيها البيت، دون أن أدخل بالتفاصيل التي باتت تزعجني، حتى إني مستعد أن أخسر هذه الخمسة ومثلها أخرى وأخرى حتى أحضى بمن يخرجني الى أوربا أملا في نسيان المأساة التي لا يمكن أن تنسى.
بعد أسبوعين، صدق الرجل، سلمته المبلغ وأستلمت جوازي، مع التأشيرة وتفصيل بالأماكن والعناوين التي ألتقي فيها بشخص داخل موسكو، يكمل معي الخطة إلى فينا، وزودني بشكله وإسمه ورقم هاتفه، وكلمة السر، وقال لي: لا تعطيه شيئا من المال، سوى سعر تذكرة العودة من موسكو - فينا - ثم دمشق، مؤكدا أن فينا هي المحطة التي ستنزل بها، وعليك أن تكون حذر، وشاطر، وتتحاشى أي خطأ.
نعم، ومتى الطيران؟؟؟.
رحلة دمشق - موسكو، ستكون يوم الأربعاء، واليوم الأثنين، عليك أن تستعد، هذا الجواز، وتذكرة السفر والعناوين، والله معاك.
فتحت محفظتي وسلمته ما تبقى من المبلغ المتفق عليه، خمسة عشر ألف دولار، مودعا إياه، مع السلامة.
كل شيئ جرى بسرعة، وجاء يوم الأربعاء، وتوجهت الى المطار، بعد أن أودعت ما تبقى من مبلغ البيت عند خالي المقيم مؤقتا في دمشق، طالبا منه تحويله إلي في المكان الذي سأستقر عنده، وبالاعتماد على إتصال تلفون مني لاحقا، واخذت الطيارة الى موسكو، والتقيت الشخص المطلوب في فندق كان هو قد حجز لي فيه، وأخذ جوازي حسب الخطة المتفق عليها، قائلا:
سنلتقي هنا بالفندق بعد غد لنتكلم عن التفاصيل، تمتع بموسكو، لأنها تستحق أن تشاهد في مثل هذه الأيام من السنة.
نعم، سأخرج، وسأتجول، وسأشاهد الناس، لأتأكد هل هم يشبهون أناسا لدينا يذبحون بالسيف والسكين.
وقبل أن يتركني الشاب الذي عرف عن نفسه، بالمهندس سامي، قال: أنصحك ان لا تحمل معك مبالغ كبيرة من المال لان العصابات هنا كثيرة وشرسة.
هل يذبحون بالسيف هنا أيضا؟؟؟.
لا، هنا المسألة مختلفة، لدينا التهديد بالمسدس والسكين، والاختطاف.
المهم أن لا يكون بينها ذبح بالسيف.
إطمئن، فإن الاسلاميين لم يصلوا إلى موسكو، ولم تصل سيوفهم، وسوف لن تصل، إنها صُنعت فقط لمنطقتكم العربية، الاسلامية التي تعيش الردة الى سابق العهد، إلى ما قبل التاريخ.
مع السلامة، أنتظرني بمثل هذا الوقت بعد غد، وإن شاء الله سوف تسير الأمور، كما تود، لأنك شاب طيب.
إن شاء الله، سأنتظر.
جاء الوقت المحدد، وتم الطيران باليوم الثاني، مع شاب آخر رافقني في الرحلة، وتفارقنا في مطار فينا بعد أن أخذ مني جوازي العراقي، وبدأت رحلة جديدة مع الهجرة النمساوية، ومهربين آخرين، أخذوا مني عشرة آلاف دولار لإيصالي بسيارة إلى السويد، بعد أن أشاروا عليّ أنها تعطي موافقات لجوء، فوصلتها بالضبط منتصف شهر آب 2008. وتلك قصة أخرى، من قصصي التي سوف لن تنتهي، أعتقد أنك تعبت من كثر الاستماع إلي. وقد تكون لديك قصة تريد أن تسمعني إياها، أو إنك محتاج أن تتكلم مثلما أنا محتاج.
لا يابني، تكلم أنت، لم أعد قادرا على الكلام، أو لم يعد الكلام قادرا على الخروج من فمي الذي أشعر أنه فيه يتعثر، بعد سماعي قصتك. الله يرحم الذين غادروا هذه الدنيا، والله ينتقم من كل الذين تسببوا فيما وصلنا إليه بهذه الغربة.
عموما وباختصار شديد، قدمت على اللجوء في السويد وسكنت في المخيم قريبا من مدينة نورث شوبنك، ودخلت المدرسة فتعلمت اللغة السويدية بستة أشهر، وفكرت جديا أن أعيد نشاطي الدراسي وأكمل الصيدلة، لكني تفاجئت من رفض طلبي للجوء، إذ إن المحقق لم يقتنع بقصتي، وطلب صورا لتعزيز سردي للقصة، فأجبته في حينه، كيف لي أن أحمل دم أبي وجسد شقيقتي العاري، وسيقان والدتي المقطوعة معي إينما أذهب، إني هربت لأتخلص من منظرهما المعتم، وذكراهم المؤلمة، فرد علي في حينه، إن قصصكم أنتم العراقيين غريبة حتى تصل أحيانا إلى أغرب من الخيال.
لكنها الحقيقة.
أثبتها لي، وسأتفق معك.
كيف لي أن اثبتها، وأنا الهارب من وقعها.
وأنتهت السنة، وحلت السنة اللاحقة، وأنا اتابع التمييز، ولم افلح، فجاءت الفاجعة في تبليغي أن ملفي سيحول إلى الشرطة، إذا لم البي الدعوة إلى العودة أختياريا.
كفرت بحظي العاثر، وبتاريخي وأصلي، وقررت أن استمر، حتى لو أحالوني الى المشنقة، وليس الى الشرطة، إني أفضل الموت هنا على أن أعيش هناك وسط خيالات تفزعني، وخوف يطوقني طوال الليل والنهار.
كان آخر تبليغ بتحويل ملفي إلى الشرطة نهاية عام 2009، وبالتحديد في 30/12، وبينما كان الناس هنا يستعدون لاحتفالات عيد الميلاد، أشتريت حقيبة ظهر، وضعت فيها بعض حاجياتي وملابسي البسيطة، وأتصلت بخالي ليحول لي مبلغا من المال، ومن بعد أستلامه في اليوم الثاني همت على وجهي كما كنت أهيم في الموصل قبل عدة سنوات، لا علم لي بالمكان، ولا علاقة لي بالزمان، الأمر الذي يهمني هو أن أمشي، وأترك للقدر جوانب التحكم بمصيري، كما تحكم بمصير عائلتي، وتركني وحيدا، دون أن يأخذني معهم لأستريح.
تنقلت في الليل والنهار، وفي موسم لم تتوقف فيه الثلوج عن النزول، أسلك طريق، وأترك آخر، حتى وصلت بعد أسبوع من الترحال إلى كوخ قديم على سفح ذلك الجبل الذي أشرت لك عليه قبل ساعة ونصف، وضعت فيه حاجياتي، وأعدت ترتيبه، شعرت أني بعيد عن الشرطة وأحتمالات الترحيل، وهكذا بقيت من ذلك التاريخ حتى يومي هذا، أسبت فيه وبالمغارة الملاصقة له في الشتاء، بإستثناء بعض الأوقات التي أخرج فيها لصيد الأرانب البرية بعد أن تعلمت فنون صيدها من الطبيعة، وأخرج في الصيف للمشي في غابته والغابات القريبة منه، وصيد الأسماك التي أجففها لموسم الشتاء، وأعرف محلا أو سوبر ماركت بسيط على بعد ثلاث ساعات مشي من كوخي، أقصده في أوقات أتأكد أن لا شرطة تمر قربه، اشتري منه ما أحتاج من معلبات ومواد، وأعود إلى المغارة ثانية، إنها وطني الجديد.
وإلى متى ستبقى فيه وبهذه الحياة الصعبة؟
عمي أبو أحمد، بربك تعيش وحدك مع الطبيعة أحسن، لو ترجع بمواجهة حاملي السيوف، فاقدي الضمير أحسن.
لا أستطيع أن أرى مكان فيه ناس، ومنه أسمع أخبار العراق، وأقول لك بصراحة تأتيني حالة أتخيل فيها أن الماشين في الشارع العام، يحملون سيوف ليقتلوا من يصادفهم في الطريق.
إني سابقى هكذا، وسأقاوم، وسأقبل الموت بهدوء في وطني الجديد، كما إني لا أخاف الموت، بل أرحب به أحيانا ليخلصني من آلامي وليجمعني بأهلي الذين رحلوا عني في رمشة عين.
عمي أبو أحمد، إن القرية التي تسكنها لا تبعد عن المكان الذي نحن فيه سوى عشرة دقائق، بدأت أقلق مع كل خطوة أتقدمها في إتجاه السير الذي قد أقابل فيه الناس، هذا هو الحد الذي يفصلني عن الحضارة والناس، آسف لم يبق لي وقت أن اسمع قصتك، كان أملي أن أسمعها، لكن حاجتي للكلام ولأن أُسْمعُ غيري كان أقوى من أن أسمعَ منك.
شكرا على إستماعك لي.
لا تأبه ياولدي، كلانا متشابهان، في هذه الغربة، من خسر أهله فهو غريب منكوب، ومن خسر وطنه فهو غريب مطلوب، وكلانا سيموت بعيدا عن الأهل، وربما سندفن بلا أكفان أو قد لا نجد قبور، ومن يعلم قد ننتحر بنفس اليوم لأني لا أخفيك سرا أفكر بين الحين والآخر بالانتحار.
أملي أن أراك ثانية لأسمع منك، وربما لأسمعك قصتي أنا أيضا.
عمي أبو أحمد لا يمكن أن أعطي وعدا، لأني لم أستطع أن أفي بوعد من هذا النوع، وفي حالتي هذه، لكني أتمنى أن نلتقي ثانية بالصدفة لأسمع منك.
والآن مع السلامة.
مسكته من كلتا يديه بقوة، وجلبته إلى صدري، قبلته بطريقة الأب الحاني على إبنه العليل، ووقفت في مكاني أرقب عودته، لم أتمكن من الحراك حتى توارى بين الأشجار.
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
834 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- طرائف رمضانية من التراث العربي
- قصة (عشق الصبى) - الجزء الثاني
- نحو صيامٍ بيئي لإنقاذ الرافدين
- دراسة جديدة تفك لغز "العمر البيولوجي"
- قصتها بدأت منذ قرون طويلة .. "السنبوسك" أشهر فطيرة في رمضان
- كلمات على ضفاف الحدث العراق والارقام يكحل العين ...!!
- لماذا ستصعّد إيران الضربات العسكرية الأميركية وخطر الغرق في مستنقع نِيت سوانسون / اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خماس
- عودُ الثقاب في إقليمٍ مكدّس بالوقود هل نحن أمام حربٍ
تابعونا على الفيس بوك


























































































